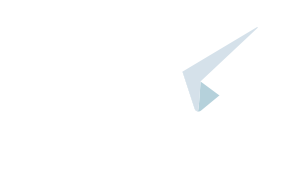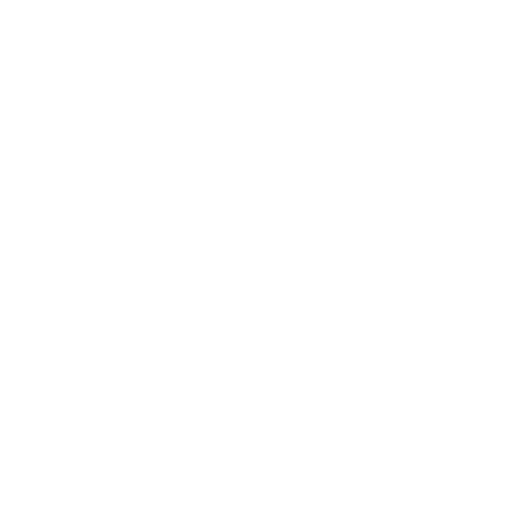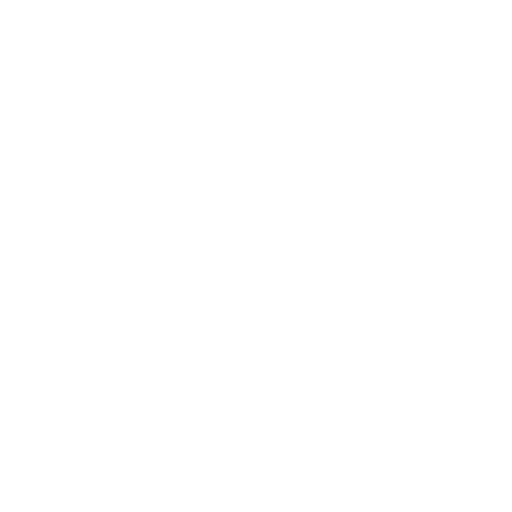تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم


علوم القرآن

أسباب النزول


التفسير والمفسرون


التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل


مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج


التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين


القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة


تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن


الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة


قصص قرآنية


قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله


سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة


حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية


العقائد في القرآن


أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية


التفسير الجامع


حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص


حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة


حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر


حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن


حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات


حرف الدال

سورة الدخان


حرف الذال

سورة الذاريات


حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن


حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة


حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ


حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح


حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف


حرف الضاد

سورة الضحى


حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق


حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر


حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية


حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق


حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش


حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون


حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل


حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد


حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس


حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة


حرف الواو

سورة الواقعة


حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس


آيات الأحكام

العبادات

المعاملات
«بايزيد» و«شقيق» و«معروف» كانوا تلامذة لثلاثة أئمّة
المؤلف:
السيّد محمّد الحسين الحسينيّ الطهرانيّ
المصدر:
معرفة الله
الجزء والصفحة:
ج3/ ص296-304
2025-09-23
428
لم يبخل الأئمّة أو يقصّروا في إغنائهم وإفاضتهم من تلك العلوم، حتى حاز ثلاثة منهم على صُحبة ثلاثة من الأئمّة صحبة معنويّة وصوريّة شديدة القُرب، أحدهم بايَزيد البَسطاميّ الذي مارس التقيّة خوفاً من بطش البطّاشين وانتحل شخصيّة السقّاء وتمكّن بذلك من مصاحبة الإمام جعفر الصادق عليه السلام سنوات طوالًا فتشرّب من حقائق ذلك الإمام وارتوى من معارف فيضه الشيء الكثير[1].
والثاني، شَقِيق البَلخيّ الذي تاب من ذنوبه على يد الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام ولازمه.
والثالث: معروف الكَرخيّ والذي تنكّر بهيئة بوّاب لدار الإمام الرضا عدّة سنوات تقيّةً وخوفاً من المناوئين[2].
وبسبب اكتساب هؤلاء الثلاثة معارفهم وحقائقهم من الأئمّة الثلاثة وتدريسهم ذلك لباقي الزهّاد والعبّاد، فقد اصطبغوا بصبغة الزهد والعبادة والمعارف الخاصّة والتي لم تكن موجودة في عصر بني اميّة.
وواضح بشكل لا يقبل الشكّ أن المعارف والحقائق التي كان الأئمّة حائزين عليها هي نفسها التي قام الرسول بتعليمها إلى علي بن أبي طالب عليه السلام ومنه إلى أولاده ومن أولاده إلى مَن وجدوا فيه الاستعداد والقابليّة لنيلها. ولمّا لم يكن للأئمّة المذكورين مُعلّماً غير آبائهم، فقد كان منهلم الوحيد والأصليّ هو الرسول وعلى عليهما صلوات الله.
وأهمّ دليل لدينا يُثبت أن الأئمّة الثلاثة لم يتوانوا في إغداق أعلى مراتب المعارف الدينيّة على الأشخاص الثلاثة المذكورين، ويُشير إلى نوع تلك المعارف ومنبعها، هو كتاب «مصباح الشريعة» الذي يحوي أحاديثاً في الحقائق والمعارف قالها الإمام جعفر الصادق، ولمّا كان شَقيق البَلخيّ مُلازماً للإمام موسى بن جعفر عليهما السلام فقد أمر الإمام أحد أقربائه الذي كان من خواصّ أهل العِلم والذي كان قد دوّن تلك الأحاديث في الحقائق والمعارف (للإمام جعفر الصادق عليه السلام) في كتاب مستقلّ بتسليم ذلك الكتاب إلى شَقيق البَلخيّ ليُبيّنه البلخيّ بدوره إلى الخواصّ من أهل المعرفة والتصوّف.
وقد نال الكتاب المذكور الذي احتوى على أسرار التصوّف وحقائقه ثقة كبار علماء الشيعة؛ واستند المرحوم الحاجّ ميرزا حسين النوريّ- وهو خاتم مُحدّثي الشيعة- كذلك على أحاديث الكتاب المذكور واعتبره واحداً من المصادر التي اعتمدها كتاب «مستدرك الوسائل».
وذكر النجاشيّ في رجاله ما قوله أن الفُضَيل بن عياض هو أحد مشاهير المتصوّفة في القرن الثاني للهجرة والذي قال عنه النجاشيّ إنّه ثقة، ووصفه الشيخ الطوسيّ في «الفهرست» بالزهد وكان قد ألّف كتاباً روى فيه عن الإمام الصادق[3].
لكنّي أعتقد أن هذا الكتاب لم يعد موجوداً في الوقت الحاضر؛ إلّا أنّ كتاب «مصباح الشريعة» الذي يشمل مائة باب في الحقائق موجود في أيدينا اليوم ومطبوع كذلك. وللميرزا حسين النوريّ كلام في «خاتمة المستدرك» حول هذا الكتاب له علاقة بما نتحدّث عنه نرى من المناسب نقله هنا: كتب المرحوم الحاجّ النوريّ يقول: «للصوفيّة مقصدان يُعتَبر أحدهما مقدّمة للآخر.
المقصد الأوّل هو تهذيب النفس وتنقيتها من الشوائب والظلمات وتطهيرها من الرذائل والصفات السيّئة، وصبغها بالأوصاف الجميلة والكمالات المعنويّة. ويحتاج هذا الأمر إلى معرفة النفس والقلب وتحديد الصفات الجيّدة والخصال الحميدة والذميمة حتى يتمكّن (المرء) من البدء بتطهير النفس والقلب وتزكيتهما وتنويرهما وتحليتهما. وهذا مقصد جَدّ عظيم يشترك فيه أهل الشرع وكافّة العلماء. وكيف لا يكونون شركاء في ذلك وقد وُضِعَت العبادات والشعائر الدينيّة لهذا الغرض، وما كان إرسال الرسل أو إنزال الكتب إلّا لأجل ذلك، وقد حثّ القرآن الكريم في كثير من الآيات على الاهتمام بأمر القلب وتهذيبه.
وللصوفيّة مؤلّفات نفيسة كثيرة في هذا المقصد ومفيدة جدّاً، إلّا أنّنا نجد فيها كذلك كلاماً عن الرياضات المحرّمة والبِدَع والكذب.
وأمّا المقصد الثاني، فهو عبارة عن ادّعاءات يستنبطونها كنتيجة لتهذيب النفس والرياضات؛ ويتحدّثون فيها عن «الوصول» و«الاتّحاد» و«الفَناء» وامور أخرى كثيرة. ولا يشترك معهم في هذا أهل الشرع والدين.
ولأنّ كبار العلماء يشاركونهم الرأي في المقصد الأوّل فقد صار اولئك الذين بالغوا في السير وراء ذلك المقصد موضع انتقاد المتّسمين بقلّة التبصُّر والتمييز؛ ولهذا نسبوا كثيراً من العلماء الأجلّاء من أمثال أبي الفتوح الرازيّ، وعلي بن طاووس، والشهيد الثاني وغيرهم إلى التصوّف، في حين لا توجد أيّة صلة بين المقصدين المذكورين، إذ لا يستلزم تهذيب النفس وجوب الاعتقاد والإيمان بالوصول والاتّحاد والرياضات المحرّمة. (راجع كتاب «خاتمة مستدرك الوسائل» ج 3، ص 330).
مع ملاحظة كلام الحاجّ ميرزا حسين ودقّته، لكنّ ما يلفت نظرنا هو أن المرحوم لم يكن لديه اطّلاع كافٍ على عقائد الصوفيّة وذلك من خلال مطالعة ما ذكره بهذا الخصوص في المقصد الثاني أعلاه؛ لأنّنا نعلم أن هذه الطائفة لا تؤمن بالاتّحاد والحلول، وإذا كان هناك ذِكر أو إشارة إلى الاتّحاد في كتبهم فذلك معناه ما ذكره الخواجة الطوسيّ في «أوصاف الأشراف».
«وليس الاتّحاد ما يتوهّمه بعض قصّار النظر من أن المراد به هو اتّحاد الله تعالى مع العبد: تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا[4] بل معناه أن يرى الجميع دون تكلّف».
وأمّا ما يخصّ الوصول، فإنّ ما ذكره الخواجة بعد العبارات أعلاه يدلّ بوضوح على عدم اكتمال المحدّث وتمامه، لأنّه قال: «وتكون مصداقاً لدعاء المنصور الحلّاج الذي أنشد قائلًا:
بَيْنِي وبَيْنَكَ إنِّيِّيٌ يُنَازِعُنِي *** فَارْفَعْ بِفَضْلِكَ إنِّيِّي مِنَ البَيْنِ[5]
فتزول إنّيّته ويُردِّد العبارة التالية ما استطاع: «أنَا مَنْ أهْوَى ومَنْ أهْوَى أنَا».
ونعلم أن مَن قال: أنَا الحَقُّ وسُبْحَانِي مَا أعْظَمَ شَأنِي، لم يكن في مقام الادّعاء بالالوهيّة، بل هو بذلك قد نفى إنّيّته وأثبتَ إنّيّة الغير وهو المطلوب».
وأمّا التريّض الذي تمارسه الصوفيّة الحقّة لتزكية النفس، فإنّ المرحوم نفسه قد ذكر أن أهل الشرع وكافّة العلماء يفعلون ذلك أيضاً. ومَن يطالع كتب التراجم التي تصوّر حالات العلماء الزاهدين الورعين، يلاحظ أن التريّض الذي كانوا يمارسونه هو من نفس نوع التريّض الذي كانت تؤدّيه جماعة الصوفيّة الحقّة.
والخلاصة، فإنّ المتصوّفة لا تختلف من حيث ممارساتها الدينيّة وطقوسها العقائديّة مع بقيّة المتشرّعين سوى أنّهم كانوا يمارسون الفرائض بشكل أفضل ويؤدّون المندوبات بكثافة، ويمكن القول: أن عصارة المعارف الدينيّة وخلاصة الحقائق الإسلاميّة لهذه الجماعة كذلك هي نفس الأشياء التي تمّ بيانها باختصار واشير إليها في كتاب «مصباح الشريعة».
إلّا أن الجانب العلميّ لُاولئك كان له شكل مختلف، حيث استقى كبار المتصوّفة بعض علومهم من مصادر أخرى إلى جانب الدين الإسلاميّ الحنيف، والذي يعتبره المحقّقون مصدراً لا يمكن إنكاره أو التغاضي عنه بأيّ شكل من الأشكال[6].
يبدو لنا أن ما ذكره المحدّث النوريّ رحمه الله عن عدم وجود ترابط بين مقصدي الصوفيّة هو غير صحيح، لأنّ الملازمة والترابط الكامل بين ذلكما المرامين ليس فقط من ضروريّات مسلك الصوفيّة وحسب، بل وكذلك من ضروريّات أهل الشرع وأتباع السنّة النبويّة والعَلَويّة، وهي كذلك تشكّل بداهة مفاد الآيات القرآنيّة والكتب السماويّة الأخرى.
إن للعبادة وتزكية النفس والتخلّق بالأخلاق الحميدة وتجنّب الصفات الرذيلة أثر فعّال في عُرف وعقيدة المتشرّعين الكبار. والتي يُراد بها التقرّب إلى الحقّ تعالى والتزلّف إليه. فأيّ نوع من أنواع العبادة والعمل سيكون باطلًا وفاسداً ما لم تكن الغاية من ذلك التقرّب.
وليس المقصود بالتقرّب إلى الحقّ تعالى التقرّب الزمانيّ أو المكانيّ أو الكيفيّ أو الكمّيّ وغير ذلك. بل المقصود به رفع الحُجُب النفسانيّة حيث يُرفع بكلّ عمل حجاب، حتى تزول جميع الحُجُب في النهاية ولا يبقى بين العبد والحقّ أيّ حجاب. اي أنّه لا يصل إلى مرحلة «لقاء الحقّ» وحسب، بل سيفوز ب«الاتّحاد» و«الوحدة» و«الوصول» ومقام «الفناء في الله» ومن ثمّ مقام «البقاء بالله».
أليست الآيات القرآنيّة: فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً ولا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً،[7] تدلّ صراحة على أن العمل الصالح يوصل الإنسان إلى لقاء ربّه إذا اقترن بنيّة الإخلاص؟! أليست الآية مَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ[8] تدلّ دلالة واضحة على إمكانيّة التشرّف باللقاء الإلهيّ بمجرّد العزم في النيّة والعمل والقول.
فما فائدة ونتيجة تزكية النفس والتخلّي والتجلّي والتحلّي بجميع المتاعب والمصاعب المتوقّعة في هذا المقام إذا لم تكن بقصد التقرّب إلى الحقّ تعالى، اي بنيّة رفع الحجاب والتقرّب إليه بدرجات متفاوتة ومراتب متباينة من «الوصول والاتّحاد والوحدة والفناء والبقاء» سوى كونها مصداقاً لعمل حمار الطاحونة الذي يدور حول نفسه باستمرار؟! فهل كان الله بحاجة إلى أعمال العباد حتى يكلّفهم بتكاليف مجرّدة غير ذات معنى، ثمّ يُرسلهم إلى مجرّد نار أو مجرّد جنّة؟! إن هذا العمل شديد الشبه بعمل إله وهميّ محتاج حاقد ضاغن جشع حسود بخيل؛ إنّه ليس عمل الإله الحقيقيّ الواقعيّ، الغنيّ على الإطلاق، الكريم الرحمن الرحيم.
إن كلّ ما فرضه الأنبياء من واجبات وأعمال على اممهم كان بهدف رفع حُجُبهم النفسانيّة، فإذا رُفِع الحجاب كانت الجنّة، وكان الحقّ، وكان اللقاء والوصول والفَناء.
وإذا بقي الحجاب، فهي الجحيم والشيطان والخسران والحرمان والطرد والزمهرير ولظى نزّاعة للشوى والحسرة والندم. ألم نطالع قصّة الأعمال الشاقّة والعبادات الكثيرة لـ «بَلْعَم بن باعوراء» في القرآن الكريم التي أبقته في آخر المطاف فقيراً؟! ولهذا نرى أن الفصل الذي أوجدوه بين هذين المقصدين غير صحيح وليس في محلّه. فالذين عملوا بالمقصد الأوّل وساروا على نهجه ثمّ وصلوا إلى المقصد الثاني كانوا هم الفائزون والمفلحون.
وأمّا الذين عملوا بالمقصد الثاني دون أخذ علّته الغائيّة بنظر الاعتبار ودون أيّما أمل في لقاء الحقّ أو رجاء في ذلك، وكذلك دون رفع الحُجُب الظلمانيّة والنورانيّة، فقد ظلّوا في أماكنهم يراوحون لم يخطوا خطوة واحدة إلى الأمام، فمثلهم كالحمار في الوحل الذي يتّجه يمنة ويسرة بغير هدى، فكان نصيبهم الحرمان إلى الأبد.
[1] - كتب العالم الجامع للكمالات الشيخ بهاء الدين العامليّ المعروف ب«الشيخ البهائيّ» في كتابه «الكشكول» طبعة مصر الدرج الأوّل، ص 86، موضوعاً حول بايَزيد البَسطاميّ قال فيه: «كان سقّاءً للإمام جعفر الصادق عليه السلام دون شكّ أو ريب. ذكر هذه القضيّة جماعة من المؤرّخين، وأورد ذلك أيضاً الإمام فخر الدين الرازيّ في كثير من كتبه الكلاميّة، وذكره كذلك السيّد الجليل رضيّ الدين علي بن طاووس في كتاب «الطرائف»، وذكره أيضاً العلّامة الحلّيّ في شرحه على «تجريد الاعتقاد» للخواجة الطوسيّ» إلى آخر كلامه في هذه المسألة.
أقول: نُقل في كتاب «الطبقات» للشعرانيّ، ج 1، ص5 عن بايزيد البسطاميّ قوله إنّه كان يقول لعلماء عصره: أخذْتم عِلمَكم من علماءِ الرُّسوم ميِّتاً عن ميِّتٍ؛ وأخذْنا عِلمَنا من الحيّ الذي لا يموت!
[2] - كتب العالم الجامع للكمالات الشيخ بهاء الدين العامليّ المعروف ب«الشيخ البهائيّ» في كتابه «الكشكول» طبعة مصر الدرج الأوّل، ص86، موضوعاً حول بايَزيد البَسطاميّ قال فيه: «كان سقّاءً للإمام جعفر الصادق عليه السلام دون شكّ أو ريب. ذكر هذه القضيّة جماعة من المؤرّخين، وأورد ذلك أيضاً الإمام فخر الدين الرازيّ في كثير من كتبه الكلاميّة، وذكره كذلك السيّد الجليل رضيّ الدين علي بن طاووس في كتاب «الطرائف»، وذكره أيضاً العلّامة الحلّيّ في شرحه على «تجريد الاعتقاد» للخواجة الطوسيّ» إلى آخر كلامه في هذه المسألة.
أقول: نُقل في كتاب «الطبقات» للشعرانيّ، ج 1، ص 5 عن بايزيد البسطاميّ قوله إنّه كان يقول لعلماء عصره: أخذْتم عِلمَكم من علماءِ الرُّسوم ميِّتاً عن ميِّتٍ؛ وأخذْنا عِلمَنا من الحيّ الذي لا يموت!
[3] - راجع «خاتمة المستدرك» ج 3، ص 333.
[4] - كما قلنا فإنّ هذه العبارة مقتبسة من الآية 43، من السورة 17: الإسراء.
[5] - ورد في التعليقة: «هذا البيت هو أحد الأبيات الشعريّة الصوفيّة التي نظمها الحلّاج، وباقي الأبيات هي:
أنا أنا أنتَ أم هذا إلَهينِ *** حاشايَ حاشايَ مِن إثباتِ اثنَينِ
هُويَّتي لك في لائيّتي أبداً *** كُلٌّ على الكلِّ تلبيسٌ بوَجهَينِ
فأين ذاتُك عنّي حيث كنتُ أرَى *** فَقد تبيَّن ذاتي حيثُ لا أيني
ونورُ وجهِك معقودٌ بناصيَتي *** في ناظِر القلب أو في ناظِر العَينِ
بيني وبينَك إنّيّي يُنازعني *** فارفع بلطفك إنّيّي مِنَ البَيْنِ
وأنا أقول متمثّلًا:
گرفتم آنكه نگيرى مرا به هيچ گناهى *** همين گناه بس كه با وجود تو هستم
يقول:« لقد أدركتُ أنّك لا تؤاخذني بأيّة جريرة، إلّا بجريرة أنّي موجود بوجودك».
[6] «شرح گلشن راز» للشيخ محمّد اللاهيجيّ، مع مقدّمة لكيوان السميعيّ، ص62 إلى 66.
[7] - ذيل الآية الأخيرة من السورة 18: الكهف.
[8] - صدر الآية 5، من السورة 29: العنكبوت.
 الاكثر قراءة في فرق واديان ومذاهب
الاكثر قراءة في فرق واديان ومذاهب
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية












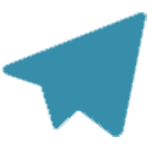
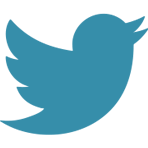

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)