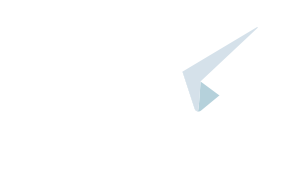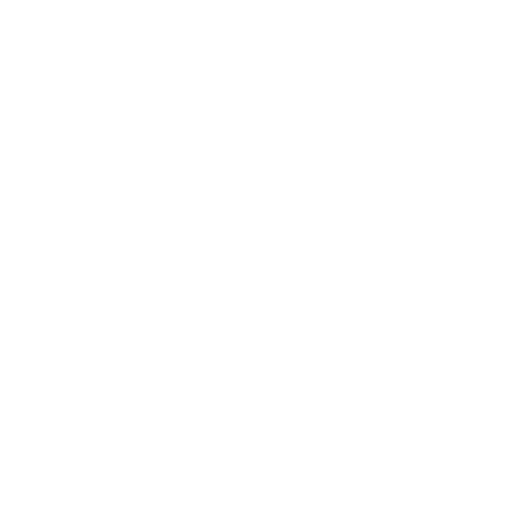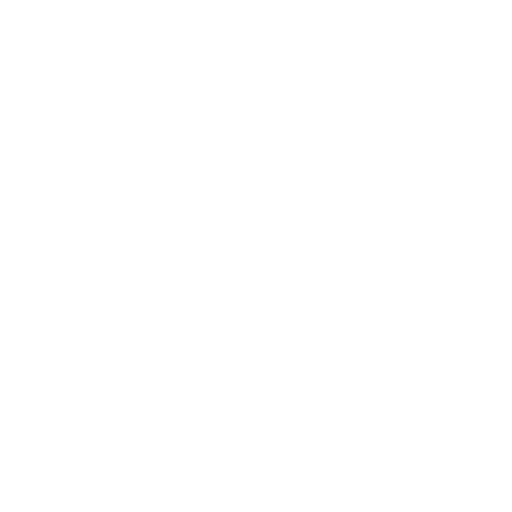علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

أحاديث وروايات مختارة

الأحاديث القدسيّة

علوم الحديث عند أهل السنّة والجماعة


علم الرجال

تعريف علم الرجال

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله)

أصحاب الائمة (عليهم السلام)

العلماء من القرن الرابع إلى القرن الخامس عشر الهجري
مَن نُسب إلى غير آبائهم أو نسب إلى شخص في الظَّاهر وفي الحقيقة خلاف ذلك
المؤلف:
أبو الحسن علي بن عبد الله الأردبيلي التبريزي
المصدر:
الكافي في علوم الحديث
الجزء والصفحة:
ص 799 ــ 815
2025-08-27
559
الفصل السابع: فيمن نسب إلى غير آبائهم، أو نسب إلى شخص في الظَّاهر، وفي الحقيقة خلاف ذلك.
وهو على قسمين:
القسم الأوّل:
الأول: مَنْ نُسِبَ إلى أمِّهِ (1):
بنو عَفْرَاء: مُعَاذ، وعَوْذ، ومُعَوِّذ، وقيل (2): إنّ الأكثر في عَوْذ: عوف.
ومنهم بلال ابن حَمَامَة المؤذِّن، حمامةُ أمُّهُ، وأبوه رَبَاح.
ومنهم بنو بَيْضَاء (3)، اسمها دَعْد.
شُرَحبيل ابن حَسَنَة، هي أمّه، وأبوه [عبد الله بن المُطَاع الكِنْدِي.
عبدُ الله ابن بُحَيْنَة، هي أمُّهُ (4)، وأبوه: مالك بن القِشْب الأَزْدِي الأَسَدِي.
وسَعْد ابن حَبْتَةَ الأنْصَارِي، هي أمّه، وأبوه] (5): بَحيرُ بن مُعَاوية جَدّ أبي يوسف القاضيّ. هؤلاء من الصَّحَابة، ومن غيرهم:
محمد: ابن الحنفيّة، هي أمُّهُ (6)، واسمُها: خَوْلَة، وأبوه: علي بن أبي طالب - عليه السّلام - (7).
إسماعيل ابن عُليّة، هي: أُمُّهُ (8)، وأبوه: إبراهيم أبو إسحاق.
إبراهيم ابن هراسة، هي أمُّهُ، وأبوه: سَلَمة.
الثاني: من نسب إلى جدّته:
مثل: يعلى ابن مُنْية، صحابي، وهي أمُّ أبيهِ (9)، وأبوهُ أميَّةُ.
بشير ابن الخَصَاصِيَةِ (10)، هو بَشير بن مَعْبَد، والخَصَاصيَةُ أمُّ الثالث من أجدَاده، هما من الصَّحَابة.
ومن غيرهم: ابن سُكَيْنَة، وهو عَبدُ الوهَّاب بن عَلي البغدادي (11)، وسُكَيْنَةُ أمُّ أبيه، وهو شَيخُ الشيخ تقي الدين.
الثالث: مَن نُسِبَ إلى جَدِّه.
منهم: أبو عبيدة بن الجرّاح، وهو عَامِرُ بن عبدِ الله بن الجَرَّاح.
وَحَمَلُ ابن النَّابِغَةِ الهُذَليُّ الصَّحابيُّ، وهو حَمَلُ بن مَالِكٍ بن النَّابغة.
مُجَمَّع ابن جَارِيَةَ، وهو مُجَمَّعُ بن يَزِيدَ بن جَارِيَةَ.
ابنُ جُرَيْجٍ، وهو عبدُ الملكِ بن عَبدِ العَزِيزِ بن جُرَيْجٍ.
بَنَو الماجِشون، منهم: يوسف بن يَعقوبَ بن أبي سِلْمَةَ الماجِشُون.
قال الغسّاني (12): "هو لَقَبُ يعقوبَ بن [أبي] سِلْمةَ جَرَى على بَنيهِ، وبني أخيه عبد الله بن [أبي] سِلْمة".
قال الشيخ تقي الدين: "معناه الأبيض الأحمر" (13).
قلت: إنّه لفظ مُعَرَّب، وأصلُه بالفارسيِّ: [ماهَكَون] (14) أي: لون أحمر، فسمِّي به لحُمرة وَجْنَتيه، ثم عرِّب (15)، والله أعلم.
ابنُ أبي ذِئُب، هو مُحَمَد بنُ عبدِ الرحمن (16) ابن أبي ذئب.
ابن أبي لَيْلَى الفَقِية، هو مُحَمَّدُ بن عبدِ الرحمن بن أبي ليلى.
قلت: وابن البَيْلَماني، هو محمد بن عبد الرحمن بن البَيْلَماني، وكلاهما ضَعيفان (17)، والله أعلم.
وابنُ أبي مُلَيكَةَ، هو عبدُ الله بن عُبيدِ الله بن أبي مُلَيكَةَ.
أحمد بن حنبل، هو أحمدُ بن مُحَمَّد بن حَنْبَل.
بنو أبي شيبة، هم: أبو بكر، وعُثمان، والقاسم بنو مُحَمَّد بن أبي شيبة (18).
الرابع: من نسب إلى غير أبيه (19).
مثل: المقداد ابن الأسود، وهو ابن عَمرو الكِنْدِي، ويُقال له: ابنُ الأسودِ؛ لأنَّه كان في حِجْرِ الأسودِ بن عَبدِ يَغُوث، وَتَبنَّاه (20).
وحَسَنُ بن دِيْنَار، وهو ابن واصل، ودِيْنَارُ زَوْجُ أُمِّهِ (21).
قلت: وفي غيرِ الرُّواة، مثل: عبد المطَّلِب، فإنّه تربَّى في حِجْر المطَّلِب، فَنُسِبَ إليه، والله أعلم.
القسم الثاني:
مثل: أبي مسْعُود البدريّ، لم يشهد بدرًا عند الأكثر (22)، ونُسِبَ إليها؛ لنُزولهِ فيها.
سُلَيمانُ بن طَرْخَان التَّيْمِّيُّ، نَزَلَ في تَيْمٍ، وليس منهم (23).
أبو خَالدٍ الدَّالانيُّ، هو أسَدِيُّ (24)، اسمه: يزيد بن عبد الرحمن، نزل في بني دَالانَ، بَطْنٌ من هَمْدَان.
إبراهيم الخُوزِيُّ (25) - بالخاء المعجمة، وبالزاء، ليس مِنَ الخُوزِ، فنسب إليهم؛ لأنه نَزل شِعْبَ الخوزِ بمكَّة.
عَبْدُ الملِكِ العَرْزَميُّ - بفتح العين المهملة وإسكان الراء المهملة، بعدها زاي مفتوحة - نزل جَبَّانَةَ عَرْزَم بالكوفة، وهي قَبيلة في (26) فزارة.
مُحَمَّدُ بن سِنَان العَوَقيُّ - بفتح العين والواو - باهليٌّ، نزل في العَوَقَة، وهم بطنٌ من عبدِ القَيْس (27)، فنُسِبَ إليهم.
أحمدُ بن يُوسُف السُّلَميُّ، روى عنه مُسلم، وهو أزْدِيٌّ، كانتْ أُمُّه سُلَمِيَّة (28).
وأبو عَمْرُو بن نُجَيْد، كذلك فإنَّه حَافدُهُ (29).
وأبو عَبدِ الرَّحمن السُّلَمِيُّ مُصنِّفُ كُتبِ الصُّوفيَّة (30)، كانتْ أمُّه امرأة (31) أبي عَمرو المذكور، فنُسِبَ سُلَميًّا، وهو أزْدِيٌّ.
ويَقْرُبُ منه: مِقْسَمُ (32) مَولَى ابن عباسٍ، للزومه إيّاه.
وَيزيدُ الفَقِير، وُصِفَ بذلك؛ لأنَّه أصيب في فَقَارِ ظَهْرِه (33).
خَالد الحذَّاء، لم يكن حَذّاءً، لكن يجلسُ في الحذَّائِينَ (34).
في المبهمات، وهي أنواع:
الأول: ما أبهم برجل وامرأة، مثل: حديث ابن عباس - رضي الله عنه - أنّ رجلًا قال: يا رسول الله: الحجُّ كلّ عام؟ (35).
وهذا الرجل أقرع بن حابس، بيَّنه ابن عبّاس في رواية أخرى (36).
وحديثُ عائشةَ: سمع رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم - رجلًا يقرأ في المسجد فقال...(37).
الرجل هو عبد الله بن يزيد (38).
وحديث أبي سعيدٍ الخُدْريِّ في أنَاسٍ من أصحابِ رسولِ الله - صلى الله عليه [وآله] وسلّم - مرُّوا بحيٍّ فلم يضيِّفوهم، فلُدِغَ سيِّدُهُم، فَرَقَاهُ رجُلٌ منهم بفاتحة الكتابِ على ثلاثينَ شاةً (39).
الرَّاقي هو الرَّاوي: أبو سَعيد الخُدريّ (40).
حديث عائشةَ في مُجادلة المرأةِ خولةَ بنتِ ثَعْلَبة، وزوجها أوسُ بن الصَّامت أخُو عُبَادة (41).
الثاني: ما أبهم بابن فلان أو ابن فلانة:
حديث أُمِّ عطيَّة: ماتت إحدى بنات رسول الله -صلى الله عليه [وآله] وسلم-، فقال: "اغْسِلنَها بماءٍ وسِدْرٍ" (42) ... الحديث.
هي زينبُ زوجةُ أبي العاص بن الرَّبيع (43).
في كتاب الجهاد: قال رسول الله - صلى الله عليه [وآله] وسلم -: "ابنُ أُختِ القَومِ منهم" (44).
هو النُّعمان بن مُقَرِّن (45).
ابن اللُّتْبِيَّة، اسمه: عبد الله (46)، منسوب إلى اللُّتْبِ، بَطْنٌ من الأسْدِ بإسكان السِّين.
ابنُ أمُّ مَكْتُوم الأعمى، اسمُه: عبدُ الله بن زائِدَة (47)، وقيل: عَمرو، وقيل غير ذلك(48)، وأمُّ مكتوم: عاتكة.
الثالث: بالعَمِّ والعَمَّةِ: حديثُ رِافِعِ بن خَدِيج، عن عمِّه في حديث المخابرة (49).
عمُّه هو: ظُهَيْرُ بن رَافع الأنْصَارِيُّ (50).
زِيادُ بن عِلَاقَة، عن عمِّه. هو: قُطْبةُ بن مَالِك الثَّعْلَبِيُّ بالمثلثة (51).
عَمَّةُ جابر بن عبد الله التي بكتْ أباه يوم أحد (52)، اسمُها فاطمةُ بنتُ عَمْرو بن حَرَام(53)، وسمَّاها الواقدي (54): هندًا.
الرابع: الزوجُ والزوجة: حديثُ سُبَيعَةَ الأَسْلَمِيَّة، أنَّها ولدت بعد وفاة زوجها بليالٍ(55).
زوجُها هو: سَعْدُ ابن خَوْلَة، بَدْرِيٌّ (56).
بَرْوَعُ بنتُ واشق - بفتح الباءِ عند المحدَّثين (57) -، زوجُها: هِلالُ بن مُرَّة الأشْجَعِيُّ(58).
زوجةُ عبدِ الرَّحمن بن الزَّبير - بفتح الزاي - التي كانت تحت رِفَاعَة بن سَمَوأَل القُرَظِيُّ فطلَّقها (59)، اسمُها: تَمِيمَةُ بنتُ وَهْب (60)، وقيل غير ذلك (61).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أفرده بالتصنيف جمع، منهم: أبو الحسن المدائني (ت 215 هـ) له: "من نسب إلى أمّه" و"من نسب إلى أمّه من الشعراء" ذكرهما في "الفهرست" (ص 166) وابن الأعرابي (ت 231 هـ)، له "من نسب إلى أمّه"، ذكره ابن حجر في "الفتح" (7/ 303) ولمحمد بن حبيب البغدادي (ت 245 هـ) "ألقاب الشعراء ومن يعرف منهم بأمّه" و"من نسب إلى أمّه من الشعراء"، وهما مطبوعان ضمن "نوادر المخطوطات" لعبد السلام هارون الأول: فيه (2/ 297 - 328)، والثاني: فيه (1/ 81 - 96)، ولأبي سعيد بن الحسن بن الحسين العَتَكي السكري (ت 275 هـ): "الشعراء المعروفون بأمّهاتهم"، ذكره ابن ماكولا في "الإكمال" (1/ 278) وللنووي (ت 676 هـ) جزء "مَنْ نُسِبَ لأمّه"، ذكره لنفسه في كتابه "تهذيب الأسماء واللغات" (1/ 89)، ولمُغْلطاي في هذا الباب "تصنيف حسن في ثلاث وستين ورقة" كذا في "التدريب" (2/ 337)، وهو مذكور أيضًا في "التبصرة والتذكرة" (3/ 225)، قال العراقي: "هو عندي بخطّه"، وذكره المناوي في "الجواهر والدرر" (2/ 648)، وللمزي (ت 742 هـ) كتاب مفرد فيمن نسب إلى غير أبيه، أفاده التِّرْمسي في "نهج ذوي النظر" (ص 283) وفي آخر "تهذيب الكمال" (34 - 422 - 487) "فصل فيمن اشتهر بالنسبة إلى أبيه أو جدّه أو أمّه أو عمّه أو نحو ذلك"، ولابن خطيب داريا (ت 811 هـ): "جزء فيمن نسب إلى أمّه"، واعتمد ابن اللُّبودي (ت 896 هـ) عليه كثيرًا في جزئه "تذكرة الطالب النبيه بمن نسب إلى أمّه دون أبيه" وهو من مخطوطات الخزانة التيموريّة في القاهرة، برقم (147) ويقع في (89) صفحة، وللفيروزآبادي (ت 817 هـ). "تحفة الأبيه فيمن نسب إلى غير أبيه" وهو مطبوع ضمن "نوادر المخطوطات" (1/ 97 - 110) ولفؤاد السيّد "معجم الذين نسبوا إلى أمهاتهم" وهو مطبوع في (364) صفحة، في بيروت، سنة 1996 م، عن الشركة العالمية للكتاب، وفيه (538) ترجمة، وهو أوسع كتاب في بابه.
(2) القائل: ابن عبد البر في "الاستيعاب" (3/ 131)، ونصَّ عليه ابنُ الصلاح.
(3) هم: سَهْل وسُهَيل، وصَفْوان، أبوهم وَهب، و(بيضاء) لقب أمّه واسمها دَعْد، أفاده ابن حجر في "تعجيل المنفعة" (1/ 625). انظر: "تحفة الأبيه" (1/ 106)، "مقدّمة ابن الصلاح" (370).
(4) اسمها عبدة بنت الحارث، كذا في "الثقات" (3/ 216) و"الإصابة" (8/ 46 - ط البجاوي) و(بُحينة) لقب أمّه.
(5) سقط من الأصل، ودونه خطأ، والمثبت من "مقدمة ابن الصلاح" (ص 370).
(6) أي: لَقَبُها.
(7) كذا في الأصل.
(8) وقيل: أم أمّه، زعمه علي بن حُجْر، انظر: "الإكمال" (1/ 375)، "تحفة الأبيه" (1/ 102)، "طبقات ابن سعد" (7/ 325).
(9) هذا في قول الزُّبير بن بكار، ووافقه عليه جماعة. وقال ابن عبد البر في "الاستيعاب" (3/ 661): "والذي عليه الجمهور أنّها أمُّهُ" وهو قول ابن المديني والقعنبي ويعقوب بن شيبة، وبه جزم البخاريّ في "التاريخ الكبير" (8/ 414) وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (9/ 301)، وابن جرير وابن قانع في "معجم الصحابة" (15/ 79، 53) والطبراني في "المعجم الكبير" (22/ 651) وابن حبان في "الثقات" (3/ 441) وابن منده وآخرون، وحكاه الدارقطني في "المؤتلف" (4/ 2119) عن أصحاب الحديث، ورجّحه المزّيّ في "تهذيب الكمال" (32/ 378) و"تحفة الأشراف" (10/ 28)، أفاده العراقي في "التقييد والإيضاح" (424) وعليه اقتصر المصنّف فيما مضى في فقرة رقم (185) وينظر "الإكمال" (7/ 296) لابن ماكولا.
(10) بتخفيف الياء، وانظر "تحفة الأبيه" (1/ 102).
(11) ترجمته في "السير" (21/ 502)، "التكملة لوفيات النَقَلة" (2/ 201)، "طبقات الشافعية" (5/ 136).
(12) في "تقييد المهمل" (3/ 1138) وما بين المعقوفتين منه، وسقط من الأصل، وهو مثبت عند ابن الصلاح ومختصري كتابه.
(13) علوم الحديث (372)، وقال القاضي عياض في "المشارق" (1/ 397): "ومعناه: المَوَرَّدُ: لحُمْرَةِ وَجْههِ".
(14) بياض في الأصل، واستدركته من "تقييد المهمل" (3/ 1138)، و (ماه) هو القمر، و (كَون) أي: مثل. فهي بمعنى: مثل القمر. انظر "سمط اللآلئ" (2/ 644)، فرهنك: عربي - فارسي" (648، 685 - 686) لرضا مهيار.
(15) وقيل: إنّ أصلهم من أصبهان، فكان إذا سَلَّم بعضهم على بعض قال: شوني شوني! فسمّي: الماجِشون، قاله ابن خلِّكان في "وفيات الأعيان" (1/ 287). وينظر: "معجم مُقَيَّدات ابن خلِّكان" (288).
(16) ابن المغيرة، كذا في "مقدمة ابن الصلاح" (372) ومختصراتها.
(17) انظر لهما - على التوالي - "الميزان" (3/ 613، 617).
(18) أبو شيبة هو جدُّهم، واسمه: إبراهيم بن عثمان، واسطيُّ، وأبوهم: محمد بن أبو شيبة. ومن المتأخرين: أبو سعيد بن يونس، صاحب "تاريخ مصر"، هو: عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصَّدَفي، قاله ابن الصلاح.
(19) زاد ابن الصلاح: "هو منه بسبَبٍ".
(20) كان ذلك في الجاهليّة، ترجمته في "الإصابة" (3/ 454)، "التجريد" (2/ 92).
(21) ومنه تعلم ما في "الجرح والتعديل" (3/ 11): "الحسن بن دينار بن واصل "! فجعل (واصلًا) جدَّهُ!!، وانظر "فتح المغيث" (3/ 269).
(22) قال البُلقيني في "محاسن الاصطلاح" (634): "المحمّدون: ابن إسحاق، وابن شهاب، وابن خزيمة، والبخاريّ، عدُّوه ممَّن شهد بَدرًا".
قلت: نصّ ابن إسحاق - كما في "سيرة ابن هشام" (2/ 102) - أنّه لم يشهد بدرًا، وقال ابن سعد في "طبقاته" (6/ 16) عن الواقديّ: "ليس بين أصحابنا اختلاف في أنّه لم يشهدها". وفي "الاستيعاب" (4/ 173): "لم يشهد بدرًا عند جمهور أهل العلم بالسير"، وذكر الخلاف فيه. ونقل ابن حجر في "الإصابة" (2/ 490) عن البرقي قوله: "لم يذكره ابن إسحاق فيهم" وعن الطبرانيّ قوله: "أهل الكوفة يقولون: شهدها، ولم يذكره أهل المدينة فيهم" ورجّح عدم ذكره فيهم: ابن معين في "تاريخه" (2/ 410) والسمعانيّ في "الأنساب" (2/ 111)، والزهري -خلافًا لما تقدم عن البُلقيني- والحربيّ. ورجَّح البخاري في "صحيحه" (4007) ومسلم في "الكنى" (2/ 778) واختاره أبو عُبيد، وجزم به الكلبي وابن البرقي أنه بدريُّ، والدليل عليه، كما بيَّنتُه في كتابي "بهجة المنتفع" (ص 316). وينظر: "التاريخ الكبير" (6/ 429)، "عيون الأثر" (1/ 280)، "فتح المغيث" (3/ 271).
(23) هو مولى بني مرّة، انظر" تهذيب الكمال" (12/ 5) والتعليق عليه.
(24) مولاهم، ترجمته في "المجروحين" (3/ 105)، "الإكمال" (3/ 306)، "الأنساب" (5/ 298).
(25) هو مولى أبي أمية، ترجمته في "الإكمال" (3/ 17)، "الأنساب" (5/ 229)، "اللباب" (1/ 470) وينظر لـ (الخوز): " معجم البلدان" (2/ 404).
(26) كذا في الأصل! وصوابها "من"، كما عند ابن الصلاح، ومن اختصر = "مقدمته"، وانظر لـ (فَزَارَة): "جمهرة أنساب العرب" (255) ولـ (عَزْرَم): "اللباب" (2/ 334). وزاد ابن الملقن في "المقنع" (2/ 631) قوله: "قلتُ: وقيل: إن الجبَّانة كانت لرجلِ أسود، اسمُه (تَحرْزَم) ".
(27) نقله أبو علي الجياني في "تقييد المهمل" (2/ 389)، وزاد بعد قوله: "من عبد القيس": "أبو نضرة المنذر بن مالك، صاحب أبي سعيد، روى له مسلم، ومحمد بن سِنَان العَوَقي، أبو بكر الباهلي البصري، هو بَاهلي، فنسب إليهم، وهو من شيوخ البخاري" وزاد ابن الملقن في (المقنع) (2/ 631) هنا قوله: (قلت: وقيل (العَوَقَة) محقة بالبصرة، لقَبيلة من العرب، وهو حيٌّ من عبد القيس" ووجدت هذه الزيادة عند ابن السمعاني في "الأنساب" (9/ 407) ومختصره "الباب" (2/ 364). وانظر: "الإكمال" (6/ 315)، "مشتبه النسبة" (ص 47).
(28) كان أحمد بن يوسف يقول: "أنا أزْديُّ، وأمِّي سُلَميَّةٌ". (92/ 1). انظر: "الأنساب" (7/ 182)، "مشتبه النسبة" (35)، "تهذيب التهذيب"
(29) انظر: "الأنساب" (7/ 182)، "الإكمال" (1/ 188)، وما سيأتي قريبًا.
(30) طبع له "طبقات الصوفيّة" في مجلَّدة، بتحقيق نور الدين شريبة، و"تسعة كتب في أصول التصوف والزهد"، وهي: "مناهج العارفين"، "درجات المعاملات"، "جوامع آداب الصونية"، "المقدمة في التصوف"، "بيان أحوال الصوفية"، "مسألة درجات الصادقين"، "سلوك العارفين"، " نسيم الأرواح"، "بيان زلل الفقراء"، وهي مطبوعة بتركيا بتحقيق سليمان بن إبراهيم آتش، وله من المطبوع "عيوب النفس".
(31) كذا في الأصل! وهو خطأ، صوابه "ابنت" كما عند ابن الصلاح في "المقدمة" (426 - مع "التقييد")، و"المقنع" (2/ 631)، و"الإرشاد" (2/ 760)، و"رسوم التحديث". ثم رأيت في "طبقات الصوفية" (454) لأبي عبد الرحمن هذا ترجمة لـ"أبي عمرو بن نُجيد، وهو إسماعيل بن نُجيد بن أحمد بن يوسف بن سالم بن خالد السُّلَمّي" قال: "جَدِّي لأُمّي رحمه الله".
(32) هو مولى عبد اللَّه بن الحارث بن نوفل، لزم ابنَ عباس، فقيل له: مولى ابن عباس. ترجمته في "التاريخ الكبير" (8/ 33)، "الجرح والتعديل" (8/ 414)، وهو من رجال "الكمال" (2/ 273 - "التقريب").
(33) فكان يأُلم منه حتّى ينحني له، ترجمته في "التهذيب" (11/ 338).
(34) قاله البخاري في "التاريخ الكبير" (3/ 173) وابن حبان في "الثقات" (6/ 253). وقال ابن سعد في "طبقاته" (7/ 259): الم يكن بحذاء، ولكن كان يجلس إليهم" قال: "وقال فهد بن حيَّان القيسي: لم يحْذُ خالدٌ قط، وإنما كان يقول: احذوا على هذا النحو، ولقّب الحذاء".
ومثله ما في "التاريخ الكبير" (1/ 69): "محمد بن حُميد أبو سفيان المَعْمري" قال البخاري: "قيل: مَعْمَريّ، لأنه رحل إلى مَعْمَر".
ومثله: "عليّ بن سهل بن المغيرة العَفَّاني" روى عن عفّان بن مسلم، وأكثر عنه حتى نُسِب إليه، كذا في "تهذيب الكمال" (20/ 456).
ومثله أيضًا: "محمد بن النُّوشَجان أبو جعفر السُّوَيديّ". قال البخاري في "التاريخ الكبير" (1/ 253): "وإنّما قيل: السُّويدي، لأنه رحل إلى سُويد بن عبد العزيز"، ومثله كثير.
(35) أخرجه أحمد (1/ 292/ 301، 323) والطيالسي (2669) - ومن طريقه الخطيب في "الأسماء المبهمة" (ص 13) - والدارمي (796) وابن الجارود في "المنتقى" (410) - ومن طريقه ابن بَشكوال في "الغوامض" (2/ 527) - وابن نصر في "السنة" (ص 35) والدارقطني (2/ 281) من طرق عن سِمَاك عن عكرمة عن ابن عباس، بإبهام الرجل. وسِمَاك في روايته عن عكرمة اضطراب.
والحديث صحيح، أخرجه البخاري (1785) ومسلم (1216) من حديث جابر بن عبد الله.
(36) أخرجها أحمد (1/ 255، 271، 272، 290، 291، 352، 370 - 371) وابن أبي شيبة (4/ 85) والدارمي (1788) وأبو داود (1721) والنسائي (5/ 111) وابن ماجه (2886) والدارقطني (2/ 278، 279، 280) والحاكم (1/ 441، 470) والبيهقي (4/ 326) والخطيب في "الأسماء المبهمة" (ص 13) وابن بشكوال في "الغوامض" (2/ 527 - 528)، وفيه بعد الحديث: "فقام الأقْرَعُ بن حابس، فقال: أفي كل عامٍ يا رسول اللَّه؟ قال: لو قُلْتُها؛ لوجبت" وإسناده صحيح.
وعيّنه بـ(الأقرع) جمع، منهم: النووي في "مبهماته" (رقم 144) وعنه سبط ابن العجمي في" تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم" (ص 228/ رقم 512).
وقيل: سُراقة بن مالك، وقيل: عُكَّاشة، فيما ذكره ابن السَّكن.
انظر: "الغوامض" (رقم 176)، "المستفاد" (40) لأبي زُرعة ابن العراقي.
(37) أخرجه البخاري (2655) ومسلم (788) من حديث عائشة.
(38) الخطمي، فيما أسنده الخطيب في "الأسماء المبهمة" (رقم 178)، وتبعه النووي في "الإشارات" (564)، وبه قال محمد بن طاهر في (إيضاح الإشكال" (رقم 137) ووقع التصريح به عند ابن منده في "معرفة الصحابة" -وهو ساقط من مطبوعه- كما في "أسد الغابة" (3/ 417) و"الإصابة" (4/ 368).
وفي رواية البخاري في "صحيحه" (2655) أنه عَبَّاد ولم ينسبه ووقع في بعض نسخ "صحيح البخاري" عن الفَرَبْرِي أنه عبَّاد بن تَميم، وقد أفاد ابن الملقَّن عن ابن التِّين أنه (عَبَّاد بن بشر)، قاله سبط ابن العجمي في "تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم" (رقم 322). قلت: وتسميته بـ (ابن بشر) عند أبي يعلى، ونقل ابن حجر في "الفتح" (5/ 365) أن عبد الغني بن سعيد جزم في "مبهماته" بأنه عبد اللَّه بن يزيد الأنصاري، وهكذا صنع ابن الجوزي في "التلقيح" (653) واحتمل ابن حجر تعدد القصة من جهتين، فانظر كلامه. وهذا المثال من زيادات المصنّف التي انفرد بها عن ابن الصلاح، وهي غير مسبوقة بـ(قلت)، فتنبّه لذاك، تولّى اللَّه هداك.
(39) أخرجه البخاري (2276، 5007، 5736، 5749) ومسلم (2201).
(40) وقع مصرَّحًا به في "مسند أحمد" (3/ 10) و"جامع الترمذي" (2053) و"سنن ابن ماجه" (2156)، وهو الذي اعتمده الخطيب في "الأسماء المبهمة" (رقم 58) والنووي في "الإشارات" (ص 12) و"شرحه على صحيح مسلم" (14/ 187) وابن الجوزي في "التلقيح" (ص 644) وابن حجر في "الفتح" (4/ 456) والسخاوي في "فتح المغيث" (3/ 277) وأبو زرعة العراقي في "المستفاد" (ص 55) وسبط ابن العجمي في "تنبيه المعلم" (رقم 917)، وينظر – للاستزادة - "التقييد والإيضاح" (427).
(41) أخرجه أبو داود (2214 و2215) وأحمد في "مسنده" (6/ 410 - 411)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3257، 3258)، وابن الجارود (746)، والطبراني في "الكبير" (24/ 633)، وابن حبّان (4279)، والبيهقي في "سننه" (7/ 389، 391) من طرق عن محمّد بن إسحاق: حدثني معمر بن عبد اللَّه بن حنظلة عن يوسف بن عبد اللَّه بن سلام عن خولة بنت مالك (وعند بعضهم خويلة بنت ثعلبة وهي نفسها) به. قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (9/ 433): إسناده حسن. أقول: لكن فيه معمر بن عبد اللَّه هذا قال فيه الحافظ نفسه في "التقريب": مقبول، أي: عند المتابعة، وإلّا فلين الحديث، وقال الذهبي: كان في زمن التابعين لا يعرف، وذكره ابن حبّان في "ثقاته"، ما حدّث عنه سوى ابن إسحاق بخبر مظاهرة أوس بن الصامت.
وله شاهدان مرسلان. الأول: رواه البيهقي (7/ 389 - 390) من طريق محمد بن أبي حرملة، عن عطاء بن يسار أن خويلة بنت ثعلبة، فذكره، وقال البيهقي: هذا مرسل وهو شاهد للموصول قبله. الثاني: رواه ابن سعد في "الطبقات" (8/ 378 - 379) من طريق إبراهيم بن سعد الزهري، عن صالح بن كيسان، وإسناده صحيح، وله شاهد موصول من حديث ابن عباس، رواه البيهقي (7/ 392) من طريق أبي حمزة الثمالي عن عكرمة عنه. وقال: كذا رواه أبو حمزة الثمالي، وهو ضعيف، ورواه الحاكم بن أبان عن عكرمة دون ذكر ابن عباس فيه.
والحديث عند البخاري معلّقاَ قبل حديث (7386) ووصله- معينًا المبهم (الرجل والمرأة) -: أحمد (6/ 46) وعبد بن حميد (1514) والنسائي (6/ 168) وفي "التفسير" (رقم 590) وابن ماجه (188، 2063) وأبو يعلى (4780) وابن جرير في "التفسير" (28/ 5، 6) والبيهقي (7/ 382) والخطيب في "الأسماء المبهمة" (رقم 4) وابن بشكوال في "الغوامض" (1/ 260).
وانظر – للاستزادة -: "الإصابة" (8/ 42 - ط البجاوي)، "المستفاد" (رقم 399 - ط دار الوفاء)، "التلقيح" (631).
(42) أخرجه البخاري (1253، 1254، 1257، 1259، 1261، 1263) ومسلم (939).
(43) بيَّن ابن حجر في "الفتح": (3/ 128) رقم (1253) هذا المبهم، فقال: "لم تقع في شيء من روايات البخاري مسمّاة، والمشهور أَنَّها زينب زوج أبي العاصي بن الربيع والدة أُمامة التي تقدّم ذكرها في الصَّلاة، وهي أَكبر بنات النَّبي - صلى الله عليه [وآله] وسلم -، وكانت وفاتها - فيما حكاه الطبري في "الذيل"- في أوّل سنة ثمان، وقد وردت مسمّاة في هذا عند مسلم من طريق عاصم الأَحول عن حفصة عن أُم عطيَّة قالت: "لمّا ماتت زينب بنت رسول اللَّه - صلى الله عليه [وآله] وسلم - قال رسول اللَّه - صلى الله عليه [وآله] وسلم -: "اغسلنها" فذكر الحديث، ولم أرها في شيء من الطرق عن حفصة ولا عن محمد مسمّاة إِلَّا في رواية عاصم هذه، وقد خولف في ذلك، فحكى ابن التين عن الداودي الشارح أَنَّه جزم بأنَّ البنت المذكورة أُم كلثوم زوج عثمان ولم يذكر مستنده، وتعقّبه المنذري بأنَّ أُم كلثوم توفّيت والنَّبي - صلى الله عليه [وآله] وسلم - ببدر فلم يشهدها، وهو غلط منه، فإنَّ التي توفّيت حينَئذٍ رقيّة، وعزاه النووي تبعًا لعياض لبعض أهل السير، وهو قصور شديد، فقد أَخرجه ابن ماجه [1458]، عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الوهَّاب الثقفي عن أَيوب، ولفظه: "دخل علينا ونحن نغسّل ابنته أُم كلثوم" وهذا الإِسناد على شرط الشيخين، وفيه نظر، قال في "باب كيف الإِشعار"- وكذا وقع في "المبهمات" لابن بشكوال- من طريق الأوزاعي عن محمد بن سيرين عن أُم عطيَّة قالت: "كنت فيمن غسل أُم كلثوم" الحديث، وقرأت بخط مُغُلْطاي: "زعم الترمذي أنَّها أُم كلثوم وفيه نظر". كذا قال، ولم أَرَ في الترمذي شيئًا من ذلك. وقد روى الدولابي في "الذريّة الطاهرة" [رقم (84)] من طريق أبي الرّجال عن عمرة أن أمّ عطيَّة كانت ممّن غسل أُم كلثوم ابنة النَّبيّ -صلى الله عليه [وآله] وسلم- الحديث، فيمكن دعوى ترجيح ذلك لمجيئه من طرق متعدّدة، ويمكن الجمع بأن تكون حضرتهما جميعًا، فقد جزم ابن عبد البر رحمه الله في ترجمتها بأنَّها كانت غاسلة الميّتات، ووقع لي من تسمية النّسوة اللاتي حضرن معها ثلاث غيرها، ففي "الذريَّة الطاهرة" [رقم (83)] أيضًا من طريق أسماء بنت عميس أنَّها كانت ممّن غسّلها قالت: "ومعنا صفيَّة بنت عبد المطلب"، ولأبي داود [3157]، من حديث ليلى بنت قانف - بقاف ونون وفاء - الثقفيَّة قالت: "كنتُ فيمن غسلها"، وروى الطَّبراني من حديث أُم سليم شيئًا يومئ إلى أنَّها حضرت ذلك أيضًا". انظر: "طبقات ابن سعد" (8/ 455)، "شرح النووي على صحيح مسلم" (7/ 4)، "إكمال المعلم" (3/ 77)، "المستفاد" (29)، "الأسماء" (91) رقم (50)، و"الغوامض" رقم (6)، "الإشارات" (ص 12)، "التلقيح" (ص 644)، "تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم" (ص 176 - 177/ رقم 370 - بتحقيقي)، "المقنع" (2/ 638 - 639)، "تنوير الحوالك" (1/ 172)، "فتح الملهم" (2/ 484).
(44) أخرجه البخاري (3528، 6762) ومسلم (1059). وفي الأصل: "سيدهم" بدل "منهم "!
(45) المبهم في هذا الحديث هو النعمان بن مُقَرِّن، وقع التصريح به عند الدارمي (2/ 243) والطبراني في "المعجم الصغير" (1/ 80) وابن منيع في "مسنده" بسندٍ صحيح، مما في "هدي الساري" (298). وينظر له: "الأسماء" للخطيب (رقم 151)، "الغوامض" (309)، "الإشارات" (304)، "شرح ثلاثيات المسند" (1/ 671)، "الدراية" (2/ 193)، "فتح الباري" (6/ 552) رقم (3528)، "تنبيه المعلم" (رقم 420). وفي الأصل: "نعمن بن ..." وهذه الترجمة من زيادات المصنّف.
(46) انظر: "مشارق الأنوار" (1/ 70، 370)، "الأسماء المبهمة" (رقم 95)، "فتح الباري" (13/ 165)، "الإصابة" (2/ 363)، "تهذيب الأسماء واللغات" (1/ 2).
(47) نسبة لجدّه، وهو ابن قيس بن زائدة، أفاده ابن حبان في "الثقات" (3/ 214).
(48) مثل: عبد اللَّه، والأكثر والأشهر أنّه عمرو، انظر: "إيضاح الإشكال" (ص 34)، "التقييد والإيضاح" (430)، "الاستيعاب" (2/ 370)، "تهذيب الكمال" (22/ 26).
(49) أخرجه البخاري (2339) ومسلم (1548).
(50) سُمِّي في رواية لمسلم (1548) بعد (114)، وانظر "المستفاد" (54)، "تنبيه المعلم" (260/ رقم 600 - بتحقيقي)، "الأسماء المبهمة" (400)، "الإشارات" (11)، "التلقيح" (651)، "إيضاح الإشكال" (25).
(51) انظر: "صحيح مسلم" (166، 167)، "الأسماء المبهمة" (رقم 141)، "إيضاح الاشكال" (ص 28).
(52) كما في "صحيح البخاري" (1293) و"صحيح مسلم" (2471) مبهمة.
(53) فسّرها البخاري في "صحيحه" (1244) ومسلم (2471) بعد (130) وأحمد في "المسند" (3/ 298)، وانظر: "تنبيه المعلم" (415 - بتحقيقي)، "إيضاح الإشكال" (ص 29).
(54) في "مغازيه" (1/ 266)، ووقع في "الإكليل" للحاكم تسميتها (هند بنت عمرو) أيضًا، فلعلّ لها اسمين، أو أحدهما اسمها، والآخر لقبها، أو كانتا جميعًا حاضرتين، قاله ابن حجر في "الفتح" (3/ 163) رقم (1293) وفي الأصل: "الواحدي" بدل "الواقدي" وهو خطأ ندَّ به قلم الناسخ.
(55) أخرجه البخاري (5320) ومسلم (1485) مبهمًا.
(56) سمّي عند مسلم (1484) بعد (56). ومدّة (الليالي): أربعون عند البخاري (4909)، وقيل غير ذلك، انظر "تنبيه المعلم" (252/ رقم 581) وتعليقي عليه.
(57) كذا في الأصل! ولعلَّ سقطًا فيه، وعند ابن الصلاح ومن اختصر كتابه: "بفتح الباء عند أهل اللغة، وشاع في ألسنةِ أهل الحديثِ كسرُها". وهذا هو الصواب؛ لأنّ الجوهري قال في "الصحاح" (3/ 1184): "الصواب الفتح؛ لأنّه ليس من كلام العرب (فِعْوَل) إلّا خِروع وعَيود: اسم وادٍ " وبنحوه في "المحكم" (2/ 104).
(58) أخرج أبو داود (2114) والترمذي (1145) والنسائي (3354) وابن ماجه (1891) وأحمد (1/ 447) وغيرهم عن ابن مسعود أن زوجها مات عنها، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها الصّداق، فأفتاها النبي - صلى الله عليه [وآله] وسلم- بَأنَّ لها الصداق كاملًا، وعليها العدّة، ولها الميراث.
وسُمِّي زوجها في رواية أبي داود (2116) والخطيب في "الأسماء المبهمة، (233) وقيل في اسم زوجها: ابن مروان، وقيل: اسمه الجراح، وينظر: "إيضاح الإشكال" (ص 54)، "الإصابة" (3/ 607).
(59) أخرجه البخاري (2639، 5260، 5265، 5317، 5792، 6084) ومسلم (1433) ولم يسمِّياها. وقال ابن الملقن في "المقنع" (2/ 643): "والزبير هذا قتله الزبير بن العَوَّام - بضم الزاي -، فاستَفِدْهُ".
(60) جاءت تسميتها عند مالك في "الموطأ" (2/ 531) ومن طريقه: الشافعي في "المسند" (ص 293) وابن الجارود في "المنتقى" (ص 171) والبيهقي في "الكبرى" (7/ 375) وابن حبان (9/ 430) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (4/ 255).
وينظر: "الأسماء المبهمة" (244)، "التجريد" (2/ 253)، "الاستيعاب" (4/ 255)، "الإصابة" (4/ 256)، "تنبيه المعلم" (240/ 550).
(61) قيل: اسمها (سهيمة)، أخرجه أبو نعيم [في "المعرفة" (43)]، وكأنّه تصحيف، وعند ابن منده: (أُميمة) وسُمِّي أباها (الحارث)، وهي واحدة، اختُلِفَ في التلفّظ باسمها والراجح الأوّل، قاله ابن حجر في "الفتح" (9/ 464) رقم (5317).
 الاكثر قراءة في علوم الحديث عند أهل السنّة والجماعة
الاكثر قراءة في علوم الحديث عند أهل السنّة والجماعة
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية












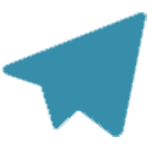
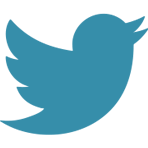

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)