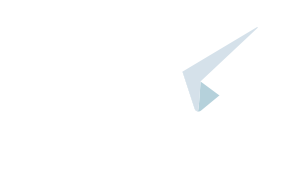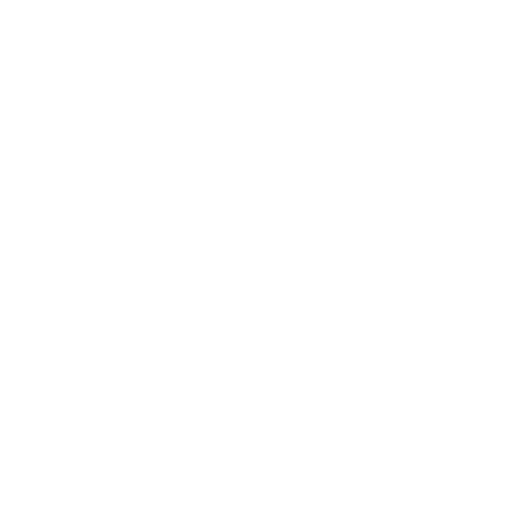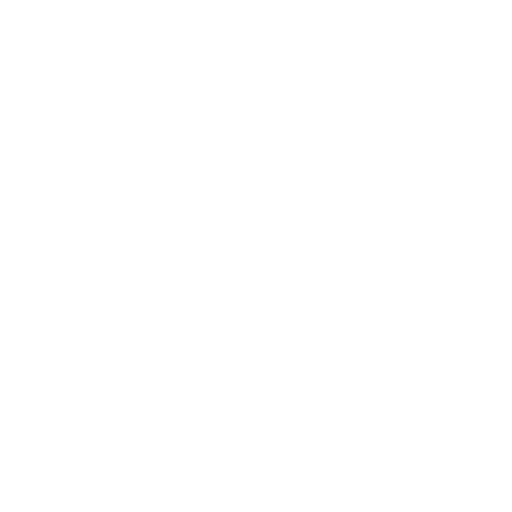تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم


علوم القرآن

أسباب النزول


التفسير والمفسرون


التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل


مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج


التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين


القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة


تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن


الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة


قصص قرآنية


قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله


سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة


حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية


العقائد في القرآن


أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية


التفسير الجامع


حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص


حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة


حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر


حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن


حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات


حرف الدال

سورة الدخان


حرف الذال

سورة الذاريات


حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن


حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة


حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ


حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح


حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف


حرف الضاد

سورة الضحى


حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق


حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر


حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية


حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق


حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش


حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون


حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل


حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد


حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس


حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة


حرف الواو

سورة الواقعة


حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس


آيات الأحكام

العبادات

المعاملات
اللهُ في كُلِّ مَكَانٍ
المؤلف:
السيّد محمّد الحسين الحسينيّ الطهرانيّ
المصدر:
معرفة الله
الجزء والصفحة:
ج1/ ص260-298
2025-07-13
21
قَالَ اللهُ الحَكِيمُ في كِتَابِهِ الكَرِيمِ: {مَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}.[1]
والآيات السابقة لها هي: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ {الم، أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وهُمْ لا يُفْتَنُونَ ، ولَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ ، أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ أَنْ يَسْبِقُونا ساءَ ما يَحْكُمُونَ}.
أمّا الآيات اللاحقة لها فهي: {وَمَنْ جاهَدَ فَإِنَّما يُجاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ، والَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ ولَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ}.
في الآية، موضوع البحث، يعد الله سبحانه وتعالى، المشتاقين إلى رؤيته صراحةً بلقائه وزيارته، وينبّه إلى أن الأمر لا ينتهي بمجرّد قول الشهادتين والإيمان باللسان، بل أن المؤمنين أمامهم امتحانات عديدة عليهم اجتيازها، وبدون الاختبار، ووضع المتفوّهين بالشهادتين والإيمان باللسان على محكّ التجربة، يستحيل على أحد الصعود إلى درجات النعيم والفوز بالجنان ولقاء جمال الواهب المنّان، وهي سنّة سنيّة، ودأب قديم للّه في إخضاع كلّ الامم والأقوام للامتحان، حتى يتبيّن المؤمن الصادق من المدّعي الكاذب.
ولقد ساء ما يعتقد به البعض وضلّ ضلالًا كبيراً، أنّه بارتكاب القبائح والمعاصي يسبقون إرادة الله واختياره وقدره وقضاءه، بل سيندحرون، وسيتبيّن لهم أنّهم توهّموا كونهم أحراراً غير مقيّدين في ارتكابهم تلك الأعمال في عالم الكون والأمر والخلق والإيجاد، ساء ما يعتقدون به ويظنّون، حيث لم يعقلوا أن استباقهم لأمر الله وتأخّرهم عنه، هو أمر إلهيّ محيط بهم، وأنّهم بطريقة تفكيرهم هذه إنّما يضعون أنفسهم في قبضة إرادة الله القاهرة ومشيئته الغالبة.
وأمّا الذين يتُوقون إلى رؤية الله ولقائه، فستتحقّق لهم امنيتهم تلك، ولن يخيب أملهم أو تحبط مساعيهم؛ وسيحين موعد اللقاء، وتطوي صفحة البُعد والهجران، فالله الواحد العالم بالخلق والسميع بهم؛ على علمٍ تامّ بتلك الامنية، وسيكشف النقاب عن وجهه المشرق، وسيُلقّى السالك جائزته لقاء سعيه واجتهاده الحثيث في سبيل لقاء الله ورؤيته.
إن اجتهاد الناس ورغبتهم في لقاء الله، لا ينفع الله في شيء، لأنّه غنيّ عن العالمينَ، وأن مردود وثواب اجتهاد وسعي الإنسان المجاهد والساعي والسالك، إنّما هو عائد له.
إن الذين آمنوا بالله لا بلسانهم بل بأعماق قلوبهم، وأعقبوا ذلك أعمالًا صالحة تُرضِي الله المحبوب الأزليّ، الذين تجيش في نفوسهم فكرة لقاء الله، فلا جرم أن الله سبحانه سيغفر ما تقدّم من ذنوب هؤلاء المحبّين الصادقين ويثيبهم على صالح أعمالهم.
تفسير «الميزان» لآية: مَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ الله فَإِنَّ أجَلَ الله لآتٍ
تفسير آيات أوائل سورة العنكبوت في امتحان المؤمنين ورجاء لقاء الله
قال جناب العلّامة الطباطبائيّ قدّس الله تربته في تفسير هذه الآيات: «يلوح من سياق آيات السورة وخاصّة ما في صدرها من الآيات أن بعضاً ممّن آمن بالنبيّ صلى الله عليه وآله بمكّة قبل الهجرة رجع عنه خوفاً من فتنة كانت تهدّده من قِبَل المشركين، فإنّ المشركين كانوا يدعونهم إلى العود إلى ملّتهم ويضمنون لهم أن يحملوا خطاياهم إن اتّبعوا سبيلهم فإن أبوا فتنوهم وعذّبوهم ليعيدوهم إلى ملّتهم.
يشير إلى ذلك قوله تعالى: {وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنا ولْنَحْمِلْ خَطاياكُمْ}-(الآية).[2]
وقوله: {وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذابِ اللَّهِ}- (الآية).[3]
و كأنّ في هؤلاء الراجعين عن إيمانهم من كان رجوعه بمجاهدة من والديه على أن يرجع وإلحاح منهما عليه في الارتداد كبعض أبناء المشركين على ما يستشمّ من قوله تعالى: {وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً وإِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما}- (الآية)[4]، وقد نزلت السورة في شأن هؤلاء.
فغرض السورة على ما يستفاد من بدئها وختامها والسياق الجاري فيها أن الذي يريده الله سبحانه من الإيمان ليس هو مجرّد قولهم: {آمَنَّا بِاللَّهِ}، بل هو حقيقة الإيمان التي لا تحرّكها عواصف الفتن ولا تغيّرها غِير الزمن، وهي إنما تتثبّت وتستقرّ بتوارد الفتن وتراكم المحن.
فالناس غير متروكين بمجرّد أن يقولوا: ءَامَنَّا بِاللهِ دون أن يُفتنوا ويُمتحنوا فيظهر ما في نفوسهم من حقيقة الإيمان أو وصمة الكفر فليعلمنّ الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين.
فالفتنة والمحنة سُنّة إلهيّة لا معدّل عنها تجري في الناس الحاضرين كما جرت في الامم الماضين كقوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم ولوط وشعيب وموسى فاستقام منهم من استقام وهلك من هلك. {وَ ما ظَلَمَهُمُ اللَّهُ ولكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ}.[5]
فعلى من يقول: ءَامَنْتُ بِاللهِ أن يصبر على ايمانه ويعبد الله وحده فإن تعذّر عليه القيام بوظائف الدين فليهاجر إلى أرض يستطيع فيها ذلك فأرض الله واسعة ولا يَخَفْ عسر المعاش فإنّ الرزق على الله.
{وَ كَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُها وإِيَّاكُمْ}.[6]
وأمّا المشركون الذين يفتنون المؤمنين من غير جرم أجرموه إلّا أن يقولوا: رَبُّنَا اللهُ فلا يحسبوا أنّهم يُعجزون الله ويسبقونه، فأمّا فتنتهم للمؤمنين وإيذاؤهم وتعذيبهم فإنّما هي فتنة لهم وللمؤمنين غير خارجة عن علم الله وتقديره، فهي فتنة وهي محفوظة عليهم إن شاء أخذهم بوبالها في الدنيا وإن شاء أخّرهم إلى يوم يُرجعون فيه إليه، وما لهم من محيص.
وأمّا ما لفّقوه من الحجّة وركنوا إليه من باطل القول فهو داحض مردود إليهم والحجّة قائمة تامّة عليهم.
ثمّ يصل سماحة الاستاذ إلى تفسير الآية الثانية فيقول: قوله تعالى: {وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا ولَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ}.
اللامان للقسم، وقوله: {وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} حال من الناس في قوله: أ حَسِبَ النَّاسُ، أو من ضمير الجمع في قوله: لَا يُفْتَنُونُ. وعلى الأوّل فالإنكار والتوبيخ متوجّه إلى ظنّهم أنّهم لا يُفتنون مع جريان السنّة الإلهيّة على الفتنة والامتحان، وعلى الثاني إلى ظنّهم الاختلاف في فعله تعالى حيث يفتن قوماً ولا يفتن آخرين، ولعلّ الوجه الأوّل أوفق للسياق.
فالظاهر أن المراد بقوله: {وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} أن الفتنة والامتحان سنّة جارية لنا وقد جرت في الذين من قبلهم وهي جارية {وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا}.[7]
وقوله: {فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا} إلى آخر الآية، تعليل لما قبله، والمراد بعلمه تعالى بالذين صدقوا [و] بالكاذبين ظهور آثار صدقهم وكذبهم في مقام العمل بسبب الفتنة والامتحان الملازم لثبوت الإيمان في قلوبهم حقيقة وعدم ثبوته فيها حقيقة فإنّ السعادة التي تترتّب الإيمان المدعو إليه وكذا الثواب إنما تترتّب على حقيقة الإيمان الذي له آثار ظاهرة من الصبر عند المكاره والصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله لا على دعوى الإيمان المجرّدة.
ويمكن أن يكون المراد بالعلم علمه تعالى الفعليّ الذي هو نفس الأمر الخارجيّ، فإنّ الامور الخارجيّة بنفسها من مراتب علمه تعالى، وأمّا علمه تعالى الذاتيّ فلا يتوقّف على الامتحان البتّة.
والمعنى: أ حَسِبُوا أن يتركوا ولا يُفتنوا بمجرّد دعوى الإيمان وإظهاره، والحال أن الفتنة سنّتنا وقد جرت في الذين من قبلهم، فمن الواجب أن يتميّز الصادقون من الكاذبين بظهور آثار صدق هؤلاء وآثار كذب اولئك، الملازم لاستقرار الإيمان في قلوب هؤلاء وزوال صورته الكاذبة عن قلوب اولئك.
والالتفات في قوله {فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ} إلى اسم الجلالة قيل: للتهويل وتربية المهابة، والظاهر أنّه في أمثال المقام لإفادة نوعٍ من التعليل.
وذلك أن الدعوة إلى الإيمان والهداية إليه والثواب عليه لمّا كانت راجعة إلى المسمّى بالله الذي (مِنْهُ يَبْدَا كُلُّ شَيءٍ، وبِهِ يَقومُ كُلُّ شَيءٍ، وإليه يَنْتَهي كُلُّ شَيءٍ بِحَقيقَتِهِ) فمن الواجب أن يتميّز عنده حقيقة الإيمان من دعواه الخالية، ويخرج عن حال الإبهام إلى حال الصراحة، ولذلك عدل عن مثل قولنا: فَلَنَعْلَمَنَّ، إلى قوله: {فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ}.
المراد بـ «الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ» هم المشركون الذين...
قوله تعالى: {أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ أَنْ يَسْبِقُونا ساءَ ما يَحْكُمُونَ}.
«أمْ» منقطعة، والمراد بقوله: {الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ} المشركون الذين كانوا يفتنون المؤمنين ويصدّونهم عن سبيل الله، كما أن المراد بالناس في قوله: أ حَسِبَ النَّاسُ هم الذين قالوا: ءَامَنَّا، وهم في معرض الرجوع عن الإيمان خوفاً من الفتنة والتعذيب.
والمراد بقوله: {أَنْ يَسْبِقُونا}، الغلبة والتعجيز بسبب فتنة المؤمنين وصدّهم عن سبيل الله، على ما يعطيه السياق.
وقوله: {ساءَ ما يَحْكُمُونَ}، تخطئة لظنّهم أنّهم يسبقون الله بما يمكرون من فتنة وصدّ، فإنّ ذلك بعينه فتنة من الله لهم أنفسهم وصدّ لهم عن سبيل السعادة؛ {وَ لا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ}.[8]
ثمّ يصل العلّامة بعد بيان موجز إلى هذه الآية، فيقول في تفسيرها وتفسير الآيتينِ اللتين تعقبانها: «قوله تعالى: {مَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}. إلى تمام ثلاث آيات. لما وبّخ سبحانه الناس على استهانتهم بأمر الإيمان ورجوعهم عنه بأيّ فتنة وإيذاء من المشركين، ووبّخ المشركين على فتنتهم وإيذائهم المؤمنين وصدّهم عن سبيل الله إرادة لإطفاء نور الله وتعجيزاً له فيما شاء وخطأ الفريقين فيما ظنّوا. رجع إلى بيان الحقّ الذي لا معدّل عنه والواجب الذي لا مخلص منه، فبيّن في هذه الآيات الثلاث أن من يؤمن بالله لتوقّع الرجوع إليه ولقائه، فليعلم أنّه آتٍ لا محالة وأن الله سميع لأقواله عليم بأحواله وأعماله، فليأخذ حذره وليؤمن حقّ الإيمان الذي لا يصرفه عنه فتنة ولا إيذاء وليجاهد في الله حقّ جهاده، وليعلم أن الذي ينتفع بجهاده هو نفسه ولا حاجة للّه سبحانه إلى إيمانه ولا إلى غيره من العالمينَ، وليعلم أنّه إن آمن وعمل صالحاً فإنّ الله سيُكفّر عنه سيئاته ويجزيه بأحسن أعماله.
والعلمان الأخيران يؤكّدان العلم الأوّل ويستوجبان لزومه الإيمان وصبره على الفتن والمحن في جنب الله.
فقوله: {مَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللَّهِ}، رجوع إلى بيان حال مَن يقول: آمنت فإنّه إنّما يؤمن لو صدق بعض الصدق لتوقّعه الرجوع إلى الله سبحانه يوم القيامة، إذ لو لا المعاد لَلُغِي الدين من أصله، فالمراد بقوله: {مَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللَّهِ: مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ}؛ أو من كان يقول: آمنت بالله. فالجملة من قبيل وضع السبب موضع المسبّب.
بيان العلّامة: لقاء الله لا ينحصر في القيامة
والمراد بـ لِقَاءَ اللهِ وقوف العبد موقفاً لا حجاب بينه وبين ربّه، كما هو الشأن يوم القيامة الذي هو ظرف ظهور الحقائق، قال تعالى: {وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ}.[9]
وقيل: المراد بلقاء الله هو البعث. وقيل: الوصول إلى العاقبة من لقاء مَلَك الموت والحساب والجزاء. وقيل: المراد ملاقاة جزاء الله من ثواب أو عقاب. وقيل: ملاقاة حكمة يوم القيامة، والرجاء على بعض هذه الوجوه بمعنى الخوف.
وهذه وجوه مجازيّة بعيدة لا موجب لها إلّا أن يكون من التفسير بلازم المعنى.
وقوله: {فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ}، الأجل هو الغاية التي ينتهي إليها زمان الدين ونحوه، وقد يطلق على مجموع ذلك الزمان والغالب في استعماله هو المعنى الأوّل.
و{أجَلَ اللهِ}: هو الغاية التي عيّنها الله تعالى للقائه، وهو آت لا ريب فيه وقد أكّد القول تأكيداً بالغاً، ولازم تحتّم إتيان هذا الأجل وهو يوم القيامة أن لا يسامح في أمره ولا يستهان بأمر الإيمان بالله حقّ الإيمان والصبر عليه عند الفتن والمحن من غير رجوع وارتداد، وقد زاد في تأكيد القول بتذييله بقوله: {وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}، إذ هو تعالى لمّا كان سميعاً لأقوالهم عليماً بأحوالهم فلا ينبغي أن يقول القائل: آمنت بالله إلّا عن ظهر القلب ومع الصبر على كلّ فتنة ومحنة.
ومن هنا يظهر أن ذيل الآية: {فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ} من قبيل وضع السبب موضع المسبّب كما كان صدرها: {مَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللَّهِ} أيضاً، والأصل من قال: آمَنْتُ بِاللهِ. فليقله مستقيماً صابراً عليه مجاهداً في ربّه.
وقوله: {وَ مَنْ جاهَدَ فَإِنَّما يُجاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ}، المجاهدة والجهاد مبالغة من الجهد بمعنى بذل الطاقة، وفيه تنبيه لهم أن مجاهدتهم في الله بلزوم الإيمان والصبر على المكاره دونه ليست ممّا يعود نفعه إلى الله سبحانه حتى لا يهمّهم ويُلغوه لغِناهم عنه، بل إنّما يعود نَفعُهُ إليهم أنفسهم، لغناهُ تعالى عن العالمين، فعليهم أن يلزموا الإيمان ويصبروا على المكاره دونه.
فقوله: {وَمَنْ جاهَدَ فَإِنَّما يُجاهِدُ لِنَفْسِهِ} تأكيد لحجّة الآية السابقة. وقوله: {أن اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ} تعليل لما قبله.
والالتفات من سياق التكلّم بالغير إلى اسم الجلالة في الآيتين نظير ما مرّ من الالتفات في قوله: {فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا}.
وقوله: {وَ الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ ولَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ}. بيان لعاقبة إيمانهم حقّ الإيمان المقارن للجهاد ويتبيّن به أن نفع إيمانهم يعود إليهم لا إلى الله سبحانه وأنّه عطيّة من الله وفضل.
وعلى هذا فالآية لا تخلو من دلالة ما على أن الجهاد في الله هو الإيمان والعمل الصالح، فإنّها في معنى تبديل قوله في الآية السابقة: {وَمَنَ جاهَدَ} من قوله في هذه الآية: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحاتِ}.
وتكفير السيّئات هو العفو عنها، والأصل في معنى الكفر هو الستر، وقيل: تكفير السيّئات هو تبديل كفرهم السابق إيماناً ومعاصيهم السابقة طاعات، وليس بذاك.
وجزاؤهم بـ {أَحْسَنَ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ} هو رفع درجتهم إلى ما يناسب أحسن أعمالهم أو عدم المناقشة في أعمالهم عند الحساب إذا كانت فيها جهات رداءة وخسّة فيعاملون في كلّ واحد من أعمالهم معاملة من أتى بأحسن عمل من نوعه فتحتسب صلاتهم أحسن الصلاة وإن اشتملت على بعض جهات الرداءة وهكذا».[10]
وعموماً، فإنّ هذه الآية الشريفة التي نحن بصددها، وبالنظر إلى ما أوردناه من تفسير العلّامة قدّس الله سرّه تبيّن بوضوح أن لقاء الله هو أمر حتميّ، وللوصول إلى ذلك، لزم أن يعمل الراغبون للقائه على حزم أمرهم وأن يتهيّأوا لذلك ويخطوا بخطوات ثابتة وبعزم راسخ للمضيّ في هذا الطريق، وألّا يخشوا أيّة آفة أو عاهة في هذا السبيل، وألّا يردعهم رادع أو مانع يصادفهم، وعليهم إزالة كلّ تلك الموانع بالاستعانة بالله، ولا يستوحشوا ممّا يلاقيهم من محن واختبارات مفروضة في هذا الطريق، حتى ينعموا بوصاله سبحانه وبمدد منه. أن هذا ليس حِكراً على امّة خاتم الأنبياء، فهذه السنّة مع جميع الامم السالفة، وكلّ الأقوام المؤمنة بأنبيائها.
إن الأعذار لن تجدي نفعاً، وتأجيل العمل إلى الغد، لن يُثمر، وإسدال ستار الجهل والحُمق على البصيرة يحول دون ورود النور إلى القلوب.
فكيف للّه أن يُفهم عباده، وبأيّة وسيلة أو طريقة، فيعقل السفهاء، ويفيق النائمون، وينتبه الغافلون؟ فوالله وتالله وبالله، لو لم تكن في القرآن كلّه إلّا هذه الآيات الأخيرة المذكورة في أوّل سورة العنكبوت، والتي تمّ تفسيرها إجمالًا من قِبَل الاستاذ العلّامة فقيد الفقه والعلم والعرفان والبصيرة والشهود، فنقرأها ونفهمها، لكفى بها من عِبرة، فما بالك مع باقي الآيات في القرآن التي تبحث جلّها وحدة الحقّ، ووجود واجب الوجود، والتي تبيّن لنا بوضوح وصريح البيان لقاءه سبحانه.
أبيات من لاميّة ابن الفارض في ضرورة المجاهدة للقاء الله تعالى
هُوَ الحُبُّ فَاسْلَمْ بِالحَشَا مَا الهوى سَهْلُ *** فَمَا اخْتارَهُ مُضْنيً بِهِ، ولَهُ عَقْلُ
وَ عِشْ خالِياً، فَالحُبُّ راحَتُهُ عَنَا *** وأوَّلُهُ سُقْمٌ، وآخِرُهُ قَتْلُ
وَ لَكِنْ لدى المَوْتُ فِيهِ صَبَابَةً *** حَيَاةٌ لِمَنْ أهْوَى، على بِهَا الفَضْلُ
نَصَحْتُكَ عِلْماً بِالهَوَى والذي أرَى *** مُخَالَفَتِي، فَاخْتَرْ لِنَفْسِكَ مَا يَحْلُو
فَإنْ شِئْتَ أن تَحْيَى سَعِيداً، فَمُتْ بِهِ *** شَهِيداً وإلَّا فَالغَرَامُ لَهُ أهْلُ
فَمَنْ لَمْ يَمُتْ في حُبِّهِ لَمْ يَعِشْ بِهِ *** ودُونَ اجْتِنَاءِ النَّحْلِ مَا جَنَتِ النَّحْلُ
تَمَسَّكْ بأذْيَالِ الهوى، واخْلَعِ الحَيَا *** وخَلِّ سَبِيلَ النَّاسِكِينَ، وأن جَلُّوا
وَ قُلْ لِقَتِيلِ الحُبِّ: وَفَّيْتَ حَقَّهُ *** ولِلْمُدَّعِي: هَيْهَاتَ مَا الكَحِلُ الكَحَلُ[11]
تَعَرَّضَ قَوْمٌ لِلْغَرَامِ وأعْرَضُوا *** بِجانِبِهِمْ عَنْ صِحَّتِي فِيهِ واعْتَلُّوا
رَضُوا بِالأمَانِي، وابْتُلُوا بِحُظُوظِهِمْ *** وخَاضُوا بِحَارَ الحَبِّ دَعْوى فَمَا ابْتَلُّوا
فَهُمْ في السُّرَى لَمْ يَبْرَحُوا مِنْ مَكَانِهِمْ *** ومَا ظَعَنُوا في السَّيْرِ، عَنْهُ وقَدْ كَلُّوا
وَعَنْ مَذْهَبي، لَمَّا اسْتَحَبُّوا العَمَى عَلَى ال- *** هُدَى حَسَداً مِنْ عِنْدِ أنْفُسِهِمْ ضَلُّوا
أحِبَّةَ قَلْبِي، والمَحَبَّةُ شَافِعِي *** لَدَيْكُمْ، إذَا شِئْتُمْ بِهَا اتَّصَلَ الحَبْلُ
عَسَى عَطْفَةٌ مِنْكُمْ على بِنَظْرَةٍ *** فَقَدْ تَعِبَتْ بَيْنِي وبَيْنَكُمُ الرُّسلُ
أحِبَّايَ أنْتُمْ، أحْسَنَ الدَّهْرُ أمْ أسَا *** فَكُونُوا كَمَا شِئْتُمْ، أنَا ذَلِكَ الخِلُ
إذَا كَانَ حَظِّي الهَجْرُ مِنْكُمْ ولَمْ يَكُنْ *** بِعَادٌ فَذَاكَ الهَجْرُ عِنْدِي هُوَ الوَصْلُ
وَمَا الصَّدُّ إلَّا الوُدُّ مَا لَمْ يَكُنْ قِلى *** وأصْعَبُ شَيءٍ غَيْرَ إعْرَاضِكُمْ سَهْلُ
وَتَعْذيبُكُمْ عَذْبٌ لدى وجَوْرُكُمْ *** عَلَيّ بِمَا يَقْضِي الهوى لَكُمُ عَدْلُ
وَصَبْرِيَ صَبْرٌ عَنْكُمُ، وعَلَيْكُمُ *** أرَى أبَداً عِنْدِي مَرَارَتُهُ تَحْلُو
أخَذْتُمْ فُؤَادِي وهوَ بَعْضِي فَمَا الَّذي *** يَضُرُّكُمُ لَوْ كانَ عِنْدَكُمُ الكُلُ
نَأيْتُمْ فَغَيْرَ الدَّمْعِ لَمْ أرَ وَافِياً *** سِوَى زَفْرَةٍ مِنْ حَرِّ نَارِ الجَوَى تَغْلُو
فَسُهْدِيَ حَيّ في جُفُونِي مُخَلَّدٌ *** ونَوْمِي بِهَا مَيْتٌ ودَمْعِي لَهُ غُسْلُ
هَوى طَلَّ مَا بَيْنَ الطُّلُولِ دَمِي فَمِنْ *** جُفُونِي جَرَى بِالسَّفْحِ مِنْ سَفْحِهِ وَبْلُ
تَبَالَهَ قَوْمِي، إذْ رَأوْنِي مُتَيَّماً *** وقَالُوا: بِمَنْ هَذَا الفَتَى مَسَّهُ الخَبْلُ؟
وَ مَا ذَا عسى عَنِّي يُقَالُ سوى: غَدَا *** بِنُعْمٍ لَهُ شُغْلٌ، نَعَمْ لي بِهَا شُغْلُ
وَ قَالَ نِسَاءُ الحَيّ: عَنَّا بِذِكْرِ مَنْ *** جَفَانَا، وبَعْدَ العِزِّ لَذَّ لَهُ الذُّلُ
إ ذَا أنْعَمَتْ نُعْمٌ على بِنَظْرَةٍ *** فَلَا أسْعَدَتْ سُعْدَى ولَا أجْمَلَتْ جُمْلُ
وَ قَدْ صُدِئَتْ عَيْنِي بِرُؤْيَةِ غَيْرِهَا *** ولَثْمُ جُفُونِي تُرْبَهَا لِلصَّدَا يَجْلُو
وَ قَدْ عَلِمُوا أنِّي قَتِيلُ لِحَاظِهَا *** فَإنَّ لَهَا في كُلِّ جارِحَةٍ نَصْلُ
حَدِيثِي قَدِيمٌ في هَوَاهَا ومَا لَهُ *** كَمَا عَلِمَتْ بَعْدٌ، ولَيْسَ لَهُ قَبْلُ
وَ مَا لي مِثْلٌ في غَرَامِي بِهَا، كَمَا *** غَدَتْ فِتْنَةً في حُسْنِهَا مَا لَهَا مِثْلُ
حَرَامٌ شِفَا سُقْمِي لَدَيْهَا رَضِيتُ مَا *** بِهِ قَسَمَتْ لي في الهوى ودَمِي حِلُ
فَحَالِي وأن سَاءَتْ فَقَدْ حَسُنَتْ بِهَا *** ومَا حَطَّ قَدْرِي في هَوَاهَا بِهِ أعْلُو
وَ عِنْوَانُ مَا فِيهَا لَقِيتُ ومَا بِهِ *** شَقِيتُ وفي قَوْلِي اخْتَصَرْتُ ولَمْ أغْلُ
خَفِيتُ ضَنى حتى لَقَدْ ضَلَّ عَائِدِي *** وكَيْفَ تَرَي العُوَّادُ مَنْ لَا لَهُ ظِلُ
وَ مَا عَثَرَتْ عَيْنٌ عَلَى أثَرِي ولَمْ *** تَدَعْ لي رَسْماً في الهوى الأعْيُنُ النُّجْلُ
وَ لِي هِمَّةٌ تَعْلُو إذَا مَا ذَكَرْتُهَا *** ورُوحٌ بِذِكْرَاهَا إذَا رَخُصَتْ تَغْلُو
جَرَى حُبُّهَا مَجْرَى دَمِي في مَفَاصِلِي *** فَأصْبَحَ لي عَنْ كُلِّ شُغْلٍ بِهَا شُغْلُ
فَنَافِسْ بِبَذْلِ النَّفْسِ فِيهَا أخَا الهَوَي *** فَإنْ قَبِلَتْهَا مِنْكَ يَا حَبَّذَا البَذْلُ
فَمَنْ لَمْ يَجُدْ في حُبِّ نُعْمٍ بِنَفْسِهِ *** ولَوْ جَادَ بِالدُّنْيَا إليه انْتَهَى البُخْلُ
وَ لَوْ لَا مُرَاعَاةُ الصِّيَانَةِ غَيْرَةً *** ولَوْ كَثُرُوا أهْلُ الصَّبَابَةِ أوْ قَلُّوا
لَقُلْتُ لِعُشَّاقِ المَلَاحَةِ أقْبِلُوا *** إلَيْهَا عَلَى رَأيِي وعَنْ غَيْرِهَا وَلُّوا
وَ أن ذُكِرَتْ يَوْماً فَخِرُّوا لِذِكْرِهَا *** سُجُوداً وأن لَاحَتْ، إلى وَجْهِهَا صَلُّوا
وَ في حُبِّهَا بِعْتُ السَّعَادَةَ بِالشَّقَا *** ضَلَالًا وعَقْلِي عَنْ هُدَايَ بِهِ عَقْلُ
وَ قُلْتُ لِرُشْدِي والتَّنَسُّكِ والتُّقَى *** تَخَلُّوا، ومَا بَيْنِي وبَيْنَ الهوى خَلُّوا
وَ فَرَّغْتُ قَلْبِي عَنْ وُجُودِيَ مُخْلِصاً *** لَعَلِّيَ في شُغْلِي بِهَا مَعَهَا أخْلُو
وَ مِنْ أجْلِهَا أسْعَى لِمَنْ بَيْنَنا سَعَي *** وأعْدُو، ولَا أغْدُو لِمَنْ دَأبُهُ العَذْلُ
فارْتَاحُ لِلْوَاشِينَ بَيْنِي وبَيْنَهَا *** لِتَعْلَمَ مَا ألْقَى ومَا عِنْدَهَا جَهْلُ
وَ أصْبُو إلى العُذَّالِ حُبَّاً لِذِكْرِهَا *** كَأنَّهُمُ مَا بَيْنَنَا في الهوى رُسْلُ
فَإنْ حَدَّثُوا عَنْهَا فَكُلِّي مَسَامِعٌ *** وكُلِّيَ أن حَدَّثْتُهُمْ، ألْسُنٌ تَتْلُو
تَخَالَفَتِ الأقْوَالُ فِينَا تَبَايُناً *** بِرَجْمِ ظُنُونٍ بَيْنَنَا مَا لَهَا أصْلُ
فَشَنَّعَ قَوْمٌ بِالوِصَالِ ولَمْ تَصِلْ *** وأرْجَفَ بِالسّلْوَانِ قَوْمٌ ولَمْ أسْلُ
فَمَا صَدَقَ التَّشْنِيعُ عَنْهَا لِشِقْوَتِي *** وقَدْ كَذَبَتْ عَنِّي الأرَاجِيفُ والنَّقْلُ
وَ كَيْفَ ارَجِّي وَصْلَ مَنْ لَوْ تَصَوَّرَتْ *** حِمَاهَا المُنَى وَهْماً، لَضاقَتْ بِهِ السُّبْلُ
وَ أن وَعَدَتْ لَمْ يَلْحَقِ الفِعْلُ قَوْلَهَا *** وأن أوْعَدَتْ فَالقَوْلُ يَسْبِقُهُ الفِعْلُ
عِدِينِي بِوَصْلٍ وامْطُلِي بِنَجَازِهِ *** فَعِنْدِي إذَا صَحَّ الهوى حَسُنَ المَطْلُ
وَ حُرْمَةِ عَهْدٍ بَيْنَنَا عَنْهُ لَمْ أحُلْ *** وعَقْدٍ بِأيْدٍ بَيْنَنَا مَا لَهُ حَلُ
لأنْتِ عَلَى غَيْظِ النَّوَى ورِضَى الهَوَى *** لَدَيّ وقَلْبِي سَاعَةً مِنْكِ مَا يَخْلُو
تُرَى مُقْلَتِي يَوْماً تَرَى مَنْ احِبُّهُمْ *** ويُعْتِبُنِي دَهْرِي ويَجْتَمِعُ الشَّمْلُ
وَ مَا بَرِحُوا معنى أرَاهُمْ مَعِي فَإنْ *** نَأوْا صُورَةً في الذِّهْنِ قَامَ لَهُمْ شَكْلُ
فَهُمْ نُصْبُ عَيْنِي ظَاهِراً حَيْثُمَا سَرَوْا *** وهُمْ في فُؤَادِي بَاطِناً أيْنَمَا حَلُّوا
لَهُمْ أبَداً مِنِّي حُنُوٌّ وأن جَفَوْا *** ولِي أبَداً مَيْلٌ إلَيْهِمْ وأن مَلُّوا[12]
عشّاق لقاء الله تعالى لا يخافون ممّا يصيبهم
وهنا يحكم العقل السليم بأن يكون القلب كلّه ملكاً للّه، بغضّ النظر عن الطقوس والعادات والتقاليد التي تشغل الإنسان عن ربّه بغيره؛ وأن يواصل الإنسان السير منفرداً في طريق الصدق، ولقاء ربّه الودود ومرضاته، منفرداً، ولو وقف بوجهه جميع العالمين، وأن ينهجَ منهج الرسول الكريم: {لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللَّهَ والْيَوْمَ الْآخِرَ وذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً}.[13] وينصت لنداء الحقّ القائل: {قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ}.[14]
ولا يكتفي بقدميه، بل زحفاً على صدره، وصولًا إلى بارئه، وأن ينطق بكلّ جوارحه ملبّياً ذلك النداء. وأن يخرج من زمرة المرتدّين، وينضوي تحت لواء {يُحِبُّهُمْ ويُحِبُّونَهُ ، ولا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ}: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ ويُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ولا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ واللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ}.[15]
خبر يونس بن ظبيان في صفات اولي الألباب
نقل السيّد هاشم البحرانيّ رواية لطيفة وظريفة عن يونس بن ظَبيان، عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليهما السلام حول منهج وسلوك اولي الألباب، وكيفيّة محبّتهم للّه، والأعمال التي يتقرّبون بها إلى الله فتوصلهم إلى لقائه ومعرفته، حتى يصل في نهاية الأمر إلى أن على كلّ من يروم الوصول إلى مقام الكمال، أن يسير على نهج الأئمّة عليهم السلام حتى يتسنّى له اجتياز كلّ العقبات والطرق الصعبة والتخلّص من حبائل الشيطان والنفس الأمّارة بالسوء، وبذلك يتمّ له الوصول إلى علم اليقين وعين اليقين وحقّ اليقين. وقد ذكر روايات عدّة في تفسير الآية الكريمة: {يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ}.[16]
منها هذه الرواية: عن ابن بابويه، عن علي بن الحسين، عن أبي محمّد هارون بن موسى، عن محمّد بن همام، عن عبد الله بن جعفر الحميريّ، عن عمر بن على العبديّ، عن داود بن كُثَير الرقّيّ، عن يونس بن ظبيان أنّه قال: دخلتُ على الصادق عليه السلام، فقلتُ: يا بن رسول الله! إنّي دخلتُ على مالك وأصحابه فسمعتُ بعضهم يقول أن الله له وجه كالوجوه، وبعضهم يقول: له يدان، واحتجّوا لذلك قول الله تعالى: {بِيَدَيّ أسْتَكْبَرْتَ}. وبعضهم يقول: هو كالشابّ من أبناء الثلاثين! فما عندك في هذا يا بن رسول الله؟ قال يونس: وكان متّكِئاً فاستوى جالساً وقال: اللهمَّ عَفْوَكَ! عَفْوَكَ! ثمّ قال: يَا يُونُسُ! مَنْ زَعَمَ أن لِلَّهِ وَجْهاً كَالوُجُوهِ فَقَدْ أشْرَكَ. ومَنْ زَعَمَ أن لِلَّهِ جَوَارِحَ كَجَوَارِحِ المَخْلُوقِينَ فَهُوَ كَافِرٌ بِاللهِ، فَلَا تَقْبَلُوا شَهَادَتَهُ! ولَا تَأكُلُوا ذَبِيحَتَهُ! تعالى اللهُ عَمَّا يَصِفُهُ المُشَبِّهُونَ بِصِفَةِ المَخْلُوقِينَ. فَوَجْهُ اللهِ أنْبِيَاؤُهُ وأوْلِيَاؤُهُ.
وَ قَوْلُهُ: {خَلَقْتُ بِيَدَيّ أسْتَكْبَرْتَ}، فَالْيَدُ: القُدْرَةُ [كَقَوْلِهِ:] {وَ أيَّدَكُم بِنَصْرِهِ} (لأنّ «أيَّدَ» من مادّة «يد». اي أن الله تعالى قوّاكم بنصره). فَمَنْ زَعَمَ أن اللهَ في شَيءٍ، أوْ عَلَى شَيءٍ ، أوْ تَحَوَّلَ مِنْ شَيءٍ إلَى شَيءٍ، أوْ يَخْلُو مِنْهُ شَيءٌ، ولَا يَخْتَلِي[17] مِنْهُ مَكَانٌ، أوْ يَشْغَلُ بِهِ شَيءٌ؛ فَقَدْ وَصَفَهُ بِصِفَةِ المَخْلُوقِينَ.
وَاللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيءٍ. لَا يُقَاسُ بِالمِقْيَاسِ، ولَا يُشْبِهُ بِالنَّاسِ. ولَا يَخْلُو مِنْهُ مَكَانٌ، ولَا يَشْتَغِلُ بِهِ مَكَانٌ. قَرِيبٌ في بُعْدِهِ، بَعِيدٌ في قُرْبِهِ. ذَلِكَ اللهُ رَبُّنَا لَا إلَهَ غَيْرُهُ.
فَمَنْ أرَادَ اللهَ وأحَبَّهُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَهُوَ مِنَ المُوَحِّدِينَ. ومَنْ أحَبَّهُ بِغَيْرِ هَذِهِ الصِّفَةِ فَاللهُ مِنْهُ بَرِيءٌ ونحن مِنْهُ بُرَاءُ.
ثمّ قال عليه السلام: أن اولِى الألْبَابِ الَّذِينَ عَمِلُوا بِالفِكْرَةِ حتى وَرِثُوا مِنْهُ حُبَّ اللهِ. فَإنَّ حُبَّ اللهِ إذَا وَرِثَتْهُ القُلُوبُ اسْتَضَاءَ بِهِ وأسْرَعَ إليه اللُطْفُ،[18] فَإذَا نَزَلَ مَنْزِلَةَ اللُّطْفِ (و نزل عليه الاسم الإلهيّ اللطيف) صَارَ مِنْ أهْلِ الفَوَائِدِ.
فَإذَا صَارَ مِنْ أهْلِ الفَوَائِدِ تَكَلَّمَ بِالحِكْمَةِ. وإذَا تَكَلَّمَ بِالحِكْمَةِ صَارَ صَاحِبَ فِطْنَةٍ.[19] فَإذَا نَزَلَ مَنْزِلَةَ الفِطْنَةِ عَمِلَ بِهَا في القُدْرَةِ، فَإذَا عَمِلَ بِهَا في القُدْرَةِ عَمِلَ في الأطْبَاقِ السَّبْعَةِ.
فَإذَا بَلَغَ هَذِهِ المَنْزِلَةَ صَارَ يَتَقَلَّبُ في لُطْفٍ وحِكْمَةٍ وبَيَانٍ.
فَإذَا بَلَغَ هَذِهِ المَنْزِلَةَ جَعَلَ شَهْوَتَهُ ومَحَبَّتَهُ في خَالِقِهِ.
فَإذَا فَعَلَ ذَلِكَ نَزَلَ المَنْزِلَةَ الكُبْرَى؛ فَعَايَنَ رَبَّهُ في قَلْبِهِ، ووَرِثَ الحِكْمَةَ بِغَيْرِ مَا وَرِثَتْهُ الحُكَمَاءُ، ووَرِثَ العِلْمَ بِغَيْرِ مَا وَرِثَتْهُ العُلَمَاءُ، ووَرِثَ الصِّدْقَ بِغَيْرِ مَا وَرِثَهُ الصِّدِّيقُونَ.
إن الحُكَمَاءَ وَرِثُوا الحِكْمَةَ بِالصَّمْتِ. وأن العُلَمَاءَ وَرِثُوا العِلْمَ بِالطَّلَبِ. وأن الصِّدِّيقِينَ وَرِثُوا الصِّدْقَ بِالخُشُوعِ وطُولِ العِبَادَةِ.
فَمَنْ أخَذَهُ بِهَذِهِ السِّيرَةِ إمَّا أن يَسْفَلَ وإمَّا أن يُرْفَعَ. وأكْثَرُهُمُ الذي يَسْفُلُ ولَا يَرْفُعُ إذَا لَمْ يَرْعَ حَقَّ اللهِ ولَمْ يَعْمَلْ بِمَا أمَرَهُ بِهِ.
فَهَذِهِ صِفَةُ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ اللهَ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ، ولَمْ يُحِبُّهُ حَقَّ مَحَبَّتِهِ.
(يا يونس!) فَلَا يَغُرَّنَّكَ صَلَاتُهُمْ وصِيَامُهُمْ ورِوَايَاتُهُمْ وعُلُومُهُمْ؛ فَإنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ.[20]
الحجج الإلهيّة منحصرة في الأئمّة الاثني عشر
ثمّ قال الإمام: يَا يُونُسُ! إذَا أرَدْتَ العِلْمَ الصَّحِيحَ فَعِنْدَنَا أهْلَ البَيْتِ! فَإنَّا وَرِثْنَاهُ، واوتِينَا شَرْحَ الحِكْمَةِ وفَصْلَ الخِطَابِ.
يقول يونس: قلتُ: يَا بْنَ رَسُولِ اللهِ!
وَكُلُّ مَنْ كَانَ مِنْ أهْلِ البَيْتِ وَرِثَ كَمَا وَرِثْتُمْ مِنْ على وفَاطِمَةَ؟!
قال عليه السلام: مَا وَرِثَهُ إلَّا الأئِمَّةُ الاثْنَا عَشَرَ!
يقول يونس: قلت يا بن رسول الله سمّهم لي!
قال عليه السلام: أوَّلُهُمْ علي بن أبِي طَالِبٍ، وبَعْدَهُ الحَسَنُ والحُسَيْنُ، وبَعْدَهُ علي بن الحُسَيْنِ، وبَعْدَهُ مُحَمَّدُ بْنُ على، وبَعْدَهُ أنَا، وبَعْدِي موسى وَلَدِي، وبَعْدَ موسى على ابْنُهُ، وبَعْدَ على مُحَمَّدٌ، وبَعْدَ مُحَمَّدٍ على، وبَعْدَ على الحَسَنُ، وبَعْدَ الحَسَنِ الحُجَّةُ؛ اصْطَفَانَا اللهُ وطَهَّرَنَا، وآتَانَا مَا لَمْ يُؤْتِ أحَداً مِنَ العَالَمِينَ.
قال يونس ثمّ قلتُ له: يا بن رسول الله! دخل عليك ابن عبد الله بن مسعود وسألك ما سألت فأجبته بغير ما أجبتني به.
قال: يَا يُونُسُ! كُلُّ امْرِئٍ مَا يَحْتَمِلُهُ! ولِكُلِّ وَقْتٍ حَدِيثُهُ! وإنَّكَ لأهْلٌ لِمَا سَألْتَهُ! فَاكْتُمْهُ إلَّا عَنْ أهْلِهِ![21]
رواية «مصباح الشريعة»: وأن الموقِنِينَ لَعَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ
يروي العلّامة المجلسيّ رحمه الله في «بحار الأنوار» عن «مصباح الشريعة»: قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام: الإخْلَاصُ يَجْمَعُ حَوَاصِلَ[22] الأعْمَالِ.
وَهُوَ معنى مِفْتَاحُهُ القَبُولُ، وتَوْقِيعُهَا الرِّضَا.
فَمَنْ تَقَبَّلَ اللهُ مِنْهُ ورَضِيَ عَنْهُ فَهُوَ المُخْلِصُ وأن قَلَّ عَمَلُهُ. ومَنْ لَا يَتَقَبَّلِ اللهُ مِنْهُ فَلَيْسَ بِمُخْلِصٍ وأن كَثُرَ عَمَلُهُ؛ اعْتِبَاراً بِآدَمَ عليه السلام وإبْلِيسَ. (إذ تُقبّل عمل آدم مع قلّته، ولم يُتقبّل عمل إبليس مع كثرته).
وَعَلَامَةُ القَبُولِ وُجُودُ الاسْتِقَامَةِ بِبَذْلِ كُلِّ المُحَابِّ، مَعَ إصَابَةِ عِلْمِ[23] كُلِّ حَرَكَةٍ وسُكُونٍ.
فَالمُخْلِصُ ذَائِبٌ رُوحُهُ، بَاذِلٌ مُهْجَتَهُ في تَقْوِيمِ مَا بِهِ العِلْمُ والأعْمَالُ والعَامِلُ والمَعْمُولُ بِالعَمَلِ. لأنَّهُ إذَا أدْرَكَ ذَلِكَ فَقَدْ أدْرَكَ الْكُلَّ. وإذَا فَاتَهُ ذَلِكَ فَاتَهُ الكُلُّ. وهُوَ تَصْفِيَةُ مَعَانِي التَّنْزِيهِ في التَّوْحِيدِ[24].
كَمَا قَالَ الأوَّلُ: هَلَكَ العَامِلُونَ إلَّا العَابِدُونَ؛ وهَلَكَ العَابِدُونَ إلَّا العَالِمُونَ؛ وهَلَكَ العَالِمُونَ إلَّا الصَّادِقُونَ؛ وهَلَكَ الصَّادِقُونَ إلَّا المُخْلِصُونَ؛ وهَلَكَ المُخْلِصُونَ إلَّا المُتَّقُونَ؛ وهَلَكَ المُتَّقُونَ إلَّا المُوقِنُونَ؛ وأن المُوقِنِينَ لَعَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ.
قَالَ اللهُ تعالى لِنَبِيِّهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ: «وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حتى يَأتِيَكَ الْيَقِينُ».
وَأدْنَى حَدِّ الإخْلَاصِ بَذْلُ العَبْدِ طَاقَتَهُ، ثُمَّ لَا يَجْعَلَ لِعَمَلِهِ عِنْدَ اللهِ قَدْراً فَيُوجِبَ بِهِ عَلَى رَبِّهِ مُكَافَاةً بِعَمَلِهِ. لِعِلْمِهِ أنَّهُ لَوْ طَالَبَهُ بِوَفَاءِ حَقِّ العُبُودِيَّةِ لَعَجَزَ.
وَأدْنَى مَقَامِ المُخْلِصِ في الدُّنْيَا السَّلامَةُ مِنْ جَمِيعِ الآثَامِ، وفي الآخِرَةِ النَّجَاةُ مِنَ النَّارِ والفَوْزُ بِالجَنَّةِ[25].
نعم رأينا في رواية اولي الألباب أن الإمام عليه السلام صرّح بمعاينة الله ومشاهدته في القلب (فَعَايَنَ رَبَّهُ في قَلْبِهِ)، وهذه إنّما تكون بجهاد النفس والروح التي شرحها الإمام قبل هذا وأكّد أن نتيجة ذلك وثمرته هو الورود في المنزلة الكبرى ولقاء ربّ العزّة.
وقد لاحظنا في هذه الرواية الأخيرة عن «مصباح الشريعة» أن النجاة إنّما تكون بالإخلاص في العمل، مؤكّدة أن البذل في سبيل المحبوب بشكل صحيح وأصيل مع العلم بصواب كلّ حركة وسكنة تؤدّي، وصهر الروح وبذل المهجة والنفس في سبيل الله، واعتبار ذلك ميزاناً ومعياراً لقبول الأعمال والأفعال.
قوّة العشق الحقيقيّ هي وحدها التي تفتح سبيل الوصول إلى الله
إن الطريق الأقوم والسبيل الأرشد، هما ما سار فيه الأنبياء والنخبة من الأولياء. وهو جدّ خطير ودقيق، إنّه عشق للّه، الحيّ ذي الجلال والواحد القهّار. وما أخطره وما أعظمه، وما أكثر ما يحمل من معاني الشوق والحبّ، حتى غدا خلاصة أعمال الكائنات ورجح على عبادة الثقلينِ.
إنّها قوّة الحبّ التي تزيل الموانع وتدكّ الحصون وتعين على اجتياز العقبات والسير في غمرة الظُّلمة، وتعبر بالمرء بحار الحسرة وصحاري الحيرة، وعوالم التيه والضلال، ولو لا ذلك ما استطاعت جميع قوى الدنيا أن تخطو بالإنسان شبراً إلى الأمام بدون إرادة الله. أن الحبّ حلّال المشاكل ومفتاح سرّ النجاح.
عشق قدوة العاشقين سيّد الشهداء عليه السلام
روي العلّامة المجلسيّ رحمه الله عن كتاب «الخرائج والجرائح» للقطب الراونديّ رحمه الله عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام عن أبيه عليه السلام أنّه قال:
مَرَّ عليّ عليه السلام بِكَرْبَلَاءَ فَقَالَ: لَمَّا مَرَّ بِهِ أصْحَابُهُ وقَدِ اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ يَبْكِي ويَقُولُ: هَذَا مُنَاخُ رِكَابِهِمْ، وهَذَا مُلْقَى رِحَالِهِمْ، هَا هُنَا مُرَاقُ دِمَائِهِمْ؛ طُوبَى لَكِ مِنْ تُرْبَةٍ عَلَيْهَا تُرَاقُ دِمَاءُ الأحِبَّةِ!
وَقَالَ البَاقِرُ عليه السلام: خَرَجَ على يَسِيرُ بِالنَّاسِ، حتى إذَا كَانَ بِكَرْبَلَاءَ عَلَى مِيلَيْنِ أوْ مِيلٍ، تَقَدَّمَ بَيْنَ أيْدِيهِمْ حتى طَافَ بِمَكَانٍ يُقَالُ لَهُ: المِقْدَفَانِ. فَقَالَ: قُتِلَ فِيهَا مِائَتَا نَبِيّ ومِائَتَا سِبْطٍ كُلُّهُمْ شُهَدَاءُ.
وَمَنَاخُ رِكَابٍ ومَصَارِعُ عُشَّاقٍ شُهَدَاءَ. لَا يَسْبِقُهُمْ مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ؛ ولَا يَلْحَقُهُمْ مَنْ بَعْدَهُمْ.[26]
رواية ابن عبّاس في كربلاء عند الحركة باتّجاه صفّين
روى العالم الكبير والمحقّق العظيم المرحوم الحاجّ الشيخ جعفر الشوشتريّ عن مجاهد، عن ابن عبّاس أنّه قال: كنت مع أمير المؤمنين عليه السلام عند ما خرج إلى صفّين، فلمّا وصل إلى نينوى على شطّ الفرات، ناداني بأعلى صوته وقال: يَا بْنَ عَبَّاسٍ! أ تَعْرِفُ هَذَا المَوْضِعَ؟!
أجبته: كلا يا أمير المؤمنين، لا أعرفه.
قال عليه السلام: لَوْ عَرَفْتَهُ كَمَعْرِفَتِي، لَمْ تَكُنْ تَجُوزُهُ حتى تَبْكِيَ كَبُكَائِي!
يقول ابن عبّاس: فبكى عليه السلام حتى اخضلَّتْ لحيته الشريفة وجرت دموعه على صدره. وبكينا نحن أيضاً معه، وكان يقول: أوَّهْ! أوَّهْ! مَا لي ولآلِ أبِي سُفْيَانَ؟! مَا لي ولآلِ حَرْبٍ حِزْبِ الشَّيْطَانِ وأوْلِيَاءِ الكُفْرِ؟! يَا أبَا عبد الله! فَقَدْ لَقِيَ أبُوكَ مِثْلَ الذي تَلْقَى مِنْهُمْ!
ثمّ طلب ماءً ليتوضّأ، وصلى قدراً، ولمّا فرغ من صلاته، أخذته غفوة لساعة فلمّا أفاق نادى: يا بن عبّاس! فأجبته: لبيك.
قال عليه السلام: ألَا احَدِّثُكَ بِمَا رَأيْتُ في مَنَامِي آنِفاً عِنْدَ رَقْدَتِي؟! فقلت: قد رقدت عيناك، أبشر يا أمير المؤمنين، إنّها رؤيا خير!
فقال عليه السلام: كَأنِّي بِرِجَالٍ قَدْ نَزَلُوا مِنَ السَّمَاءِ؛ ومَعَهُمْ أعْلَامٌ بِيضٌ، وقَدْ تَقَلَّدُوا سُيُوفَهُمْ وهي بِيضٌ تَلْمَعُ، وقَدْ خَطُّوا حَوْلَ هَذِهِ الأرْضِ خَطَّةً.
ثُمَّ رَأيْتُ كَأنَّ هَذَا النَّخِيلَ قَدْ ضَرَبَتْ بِأغْصَانِهَا الأرْضَ، تَضْطَرِبُ بِدَمٍ عَبِيطٍ. وكَأنِّي بِالحُسَيْنِ سَخْلَتِي وفَرْخِي ومُضْغَتِي ومُخِّي، قَدْ غَرَقَ فِيهِ يَسْتَغِيثُ فِيهِ فَلَا يُغَاثُ.
وَكَأنَّ الرِّجَالَ البِيضَ قَدْ نَزَلُوا مِنَ السَّمَاءِ يُنَادُونَهُ ويَقُولُونَ: صَبْراً آلَ الرَّسُولِ! فَإنَّكُمْ تُقْتَلُونَ على أيْدِي شِرَارِ النَّاسِ وهَذِهِ الجَنَّةُ يَا أبَا عبد الله إليه مُشْتَاقَةٌ. ثُمَّ يَعُزُّونَنِي ويَقُولُونَ: يَا أبَا الحَسَنِ! أبْشِرْ فَقَدْ أقَرَّ اللهُ بِهِ عَيْنَكَ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العَالَمِينَ!
ثُمَّ انْتَبَهْتُ هَكَذَا! والذي نَفْسُ على بِيَدِهِ، لَقَدْ حَدَّثَنِي الصَّادِقُ المُصَدَّقُ: أبُو القَاسِمِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ في خُرُوجِي إلَى أهْلِ البَغْيِ عَلَيْنَا!
وَهَذِهِ أرْضُ كَرْبٍ وبَلَا، يُدْفَنُ فِيهَا الحُسَيْنُ عليه السلام وسَبْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ وُلْدِي ووُلْدِ فَاطِمَةَ. وإنَّهَا لَفِي السَّمَاوَاتِ مَعْرُوفَةٌ تُذْكَرُ أرْضُ كَرْبٍ وبَلَا كَمَا تُذْكَرُ بُقْعَةُ الحَرَمَيْنِ وبُقْعَةُ بَيْتِ المَقْدِسِ- إلى آخره.[27]
وأيضاً يروي آية الله الشوشتريّ أعلى الله مقامه: أنّه لمّا سار الحسين عليه السلام نحو المدينة حضر جماعة من الجنّ عنده، وكان عليه السلام ينوح ويقرأ المراثي في حين كانوا يستمعون له. وتفصيل الرواية أنّه لمّا حضرت مواكب الجنّ المسلمين عند الإمام عليه السلام قالوا: يَا سَيِّدَنَا! نَحْنُ شِيعَتُكَ وأنْصَارُكَ، فَمُرْنَا بِأمْرِكَ ومَا تَشَاءُ! ولَوْ أمَرْتَنَا بِقَتْلِ كُلِّ عَدُوٍّ لَكَ وأنْتَ بِمَكَانِكَ، لَكَفَيْنَاكَ ذَلِكَ!
فَجَزَاهُمُ الحُسَيْنُ عليه السلام خَيْراً وقَالَ لَهُمْ: أ ومَا قَرَأتُمْ كِتَابَ اللهِ المُنْزَلَ عَلَى جَدِّي رَسُولِ اللهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ: {أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ ولَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ}؟[28]
ويقول الله سبحانه: {لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلى مَضاجِعِهِمْ}.[29]
وَإذَا أقَمْتُ بِمَكَانِي فَبِمَاذَا يُبْتَلَى هَذَا الخَلْقُ المَتْعُوسُ[30] وبِمَا ذَا يُخْتَبَرُونَ؟! ومَنْ ذَا يَكُونُ سَاكِنَ حُفْرَتِي بِكَرْبَلَاء؟ وقَدِ اخْتَارَهَا اللهُ يَوْمَ دَحَى الأرْضَ وجَعَلَهُ مَعْقِلًا لِشِيعَتِنَا، ويَكُونُ لَهُمْ أمَاناً في الدُّنْيَا والآخِرَةِ! وَلَكِنْ تَحْضُرُونَ يَوْمَ السَّبْتِ وهُوَ يَوْمُ عَاشُورَا الذي في آخِرِهِ اقْتَلُ، ولَا يَبْقَى بَعْدِي مَطْلُوبٌ مِنْ أهْلِي! وتُسْبَى أخَوَاتِي وأهْلُ بَيْتِي، ويُسَارُ بِرَأسِي إلَى يَزِيدَ لَعَنَهُ اللهُ!
فقالت جماعة الجنّ: يا حبيب الله وابن حبيب الله، لو لم تكن طاعتك مفروضة ولم تجز مخالفتك، لجعلنا أعداءك هباءً منثوراً قبل أن
تصل أيديهم إليك.
فقال الإمام الحسين صلوات الله عليه لهم: نحن واللهِ أقْدَرُ عليهم مِنْكُمْ، ولَكِنْ {لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ ويَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ}.[31]
لقاء عبد الله بن عبّاس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير مع الحسين
وذكر أيضاً آية الله الشوشتريّ كلاماً حول مراثي سيّد الشهداء عليه السلام، واستماع عبد الله بن عمر أحياناً، وعبد الله بن الزبير أحياناً أخرى لها خارج مكّة، وهذا الكلام هو: إنَّهُ لَمَّا خَرَجَ الحُسَيْنُ عليه السلام مِنْ مَكَّةَ، جَاءَ عبد الله بْنُ العَبَّاسِ وعبد الله بْنُ الزُّبَيْرِ، فَأشَارَا عَلَيْهِ بِالإمْسَاكِ.
فَقَالَ لَهُمَا: أن رَسُولَ اللهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ قَدْ أمَرَنِي بِأمْرٍ وأنَا مَاضٍ فِيهِ.
قَالَ: فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ وهُوَ يَقُولُ: وَا حُسَيْنَاهْ!
عبد الله بن عمر ينصح الإمام الحسين عليه السلام بالصلح!
ثُمَّ جَاءَ عبد الله بْنُ عُمَرَ وأشَارَ إليه بِصُلْحِ أهْلِ الضَّلَالِ، وحَذَّرَهُ مِنَ القَتْلِ والقِتَالِ.
فَقَالَ: يَا أبَا عَبْد الرَّحْمَنِ! أمَا عَلِمْتَ أن مِنْ هَوَانِ الدُّنْيَا على اللهِ تعالى أن رَأسَ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا اهْدِى إلَى بَغِيّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إسْرَائِيلَ؟! أمَا تَعْلَمُ أن بَنِي إسْرَائِيلَ كَانُوا يَقْتُلُونَ بَيْنَ طُلُوعِ الفَجْرِ إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ سَبْعِينَ نَبِيَّاً ثُمَّ يَجْلِسُونَ في أسْوَاقِهِمْ يَبِيعُونَ ويَشْتَرُونَ كَأنْ لَمْ يَصْنَعُوا شَيْئاً! فَلَمْ يُعَجِّلِ اللهُ عليهم بَلْ أخَذَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ أخْذَ عَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ؟! يَا أبَا عَبْد الرَّحْمَنِ! ولَا تَدَعْ نُصْرَتِي!
إلَّا أن سَيِّدَ الشُّهَدَاءِ عَلَيهِ سَلَامُ الأوَّلِينَ والآخِرِينَ، والإمام إلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ، رُوحِي وأرْوَاحُ العَالَمِينَ لَهُ الفِدَاء، لم ينثنِ عن رأيه وتصميمه، وسار قُدُماً بأمر الله الجليل وسنّة رسوله الكريم، وطبقاً لنظريّته وإرادته في تحقيق هذا الأمر بالتمام والكمال، بل إنّه كان مسروراً ومغتبطاً في قيامه وثورته ضدّ ظلم بني اميّة ويزيد، وأمسي مثلًا يُقتدى به إلى أبد الآبدين، ملخّصاً حقّه وحقّ أخيه وامّه وجدّه في ارجوزته المدوّية يوم عاشوراء:
كَفَرَ الْقَوْمُ وقِدْماً رَغِبُوا *** عَنْ ثَوَابِ اللهِ رَبِّ الثَّقَلَيْنْ
وأثبت أن الوصاية تختصّ بأمير المؤمنين عليه السلام وأن إمامته هي الإمامة الحقّة، وأن حكومة يزيد المبنيّة على أساس حكومة معاوية، وعلى أساس حكومة عثمان وعلى أساس حكومة عمر، وعلى أساس حكومة أبي بكر، إنّما هي باطلة وجوفاء.
واعلموا يا خلق الله! واسمعوا أيّها الناس! أن أبي وصيّ المصطفى، وهو المرتضى خليفة الحقّ. وأنا الإمام الناطق بالحقّ، ومَن له حقّ مسك زمام الامور الظاهريّة والباطنيّة والمادّيّة والمعنويّة وسوق البشر نحو الهداية وسُبل السلام. وقيادة الناس إلى شاطئ الأمن والأمان، ويخلفني ابني على من بعدي وهكذا حتى آخر الأئمّة المعصومين عليهم السلام، الطاهر الطهر المتمسّك بحبل الله، المعرض عن هوي النفس الأمّارة بالسوء، وحبّ الجاه، والمستند إلى عزّة صاحب العزّة، الإمام المهديّ محمّد بن الحسن العسكريّ عجّل الله تعالى فرجه الشريف.
افٍّ، افٍّ لهذه الدنيا وحكومتها! افٍّ افٍّ لعالم الشهوات والتوابع!
أرمي الوصول إلى مأمنه، أن ربّي ومحبوبي الأزليّ، الذي بذلت له مهجتي مذ كنت في حجر النبيّ قال لي: يا حسين! عليك بهذا الأمر هذا طريقك وهذا مسلكك.
فالنفس عزيزة على الذليل الذي يقبل بظلم دول الطغيان سابقاً وحاضراً.
لكنّي أنا الحسين، ونفسي عزيزة إذا بذلتها لتحرير بني البشر من براثن هؤلاء الوحوش، عندئذٍ، سأستطعم لذّة الفداء حينما أرى نفسي وأهل بيتي على هذا الطريق. هذا هو منهجي فمن أراد أن يكون حسيناً فليسلك هذا المنهج.
لقاء الفرزدق مع سيّد الشهداء عليه السلام في طريق الكوفة
وذكر آية الله الشيخ الشوشتريّ قدّس الله تربته أن السيّد رحمه الله قال: وصل خبر استشهاد مسلم بن عقيل إلى الإمام في منزل «زُبالة» إلّا أن الإمام واصل سيره حتى التقي بالفرزدق فسلّم عليه وقال: يَا بْنَ رَسُولِ اللهِ! كَيْفَ تَرْكَنُ إلى أهْلِ الكُوفَةِ وهُمُ الَّذِينَ قَتَلُوا ابْنَ عَمِّكَ مُسْلِمَ بْنَ عَقِيلٍ وشِيعَتَهُ؟!
يقول الراوي: فَاسْتَعْبَرَ الحُسَيْنُ عليه السلام بَاكِياً. ثُمَّ قَالَ: رَحِمَ اللهُ مُسْلِماً! فَلَقَدْ صَارَ إلَى رَوْحِ اللهِ ورَيْحَانِهِ وتَحِيَّتِهِ ورِضْوَانِهِ! أمَا إنَّهُ قَدْ قَضى مَا عَلَيْهِ، وبَقِيَ مَا عَلَيْنَا. ثُمَّ أنْشَأ يَقُولُ:
فَإنْ تَكُنِ الدُّنْيَا تُعَدُّ نَفِيسَةً *** فَدَارُ ثَوَابِ اللهِ أعلى وأنْبَلُ
وَأن تَكُنِ الأبْدَانُ لِلْمَوْتِ انْشِئَتْ *** فَقَتْلُ امْرِئٍ بِالسَّيْفِ في اللهِ أفْضَلُ
وَأن تَكُنِ الأرْزَاقُ قِسْماً مُقَدَّراً *** فَقِلَّةُ حِرْصِ المَرْءِ للِرِّزْقِ أجْمَلُ
وَأن تَكُنِ الأمْوَالُ لِلتَّرْكِ جَمْعُهَا *** فَمَا بَالُ مَتْرُوكٍ بِهِ الحُرُّ يَبْخَلُ[32]
[1] الآية 5، من السورة 29: العنكبوت.
[2] الآية 12، من السورة 29: العنكبوت.
[3] الآية 10، من السورة 29: العنكبوت.
[4] الآية 8، من السورة 29: العنكبوت.
[5] ذيل الآية 33، من السورة 16: النحل.
[6] صدر الآية 60، من السورة 29: العنكبوت.
[7] ذيل الآية 23، من السورة 48: الفتح.
[8] الآيتان 42 و43، من السورة 35: فاطر: {وَ أقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أهْدَى مِنْ إحدى الامَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ ما زَادَهُمْ إلَّا نُفُوراً ، اسْتِكْبَاراً في الأرْضِ ومَكْرَ السَّيِّئِ ولَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إلَّا بِأهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إلَّا سُنَّتَ الأوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبْدِيلًا ولَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَحْوِيلًا}.
[9] ذيل الآية 25، من السورة 24: النور.
[10] «الميزان في تفسير القرآن» ج 16، ص 101 إلى 107، طبعة الآخونديّ.
[11] الكَحِل: عينٌ مكحولةٌ؛ الكَحَل: سوادُ العين خِلقة.
[12] «ديوان ابن الفارض المصري» ص 38 إلى 42، اللاميّة، الطبعة الاولى، 1372 هـ. ق، دار العلم للجميع؛ ومن طبعة سنة 1382 هـ، دار صادر- دار بيروت: ص 134 إلى 139؛ وفي «شرح الديوان الكامل لابن الفارض» تصنيف الشيخين: حسن البورينيّ وعبد الغني النابلسيّ، (من طبعة دار التراث بيروت) ج 2، ص 108 إلى 136، ولأجل التركيب الأدبيّ لهذه اللاميّة، أو للمعاني العرفانيّة الراقية التي تحملها، فقد جاء شرحها بشكل كامل ووافٍ.
[13] الآية 21، من السورة 33: الأحزاب.
[14] آخر الآية 91، من السورة 6: الأنعام.
[15] الآية 54، من السورة 5: المائدة.
[16] الآيات 71 إلى 76، من السورة 38: ص، وهي: {إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ ، فَإِذا سَوَّيْتُهُ ونَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ، إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وكانَ مِنَ الْكافِرِينَ ، قالَ يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ ، قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ}.
[17] هكذا وردت في النسخة المسجّلة، والصحيح هو أو يختلي، وجاء في «أقرب الموارد»: الخلوة: المكان الذي يختلي فيه الرجل.
[18] جاء في «أقرب الموارد»: لَطَفَ به و- له (ن) لُطفاً: رفَق به، و- الله للعبد وبالعبد: رفَق به وأوصلَ إليه ما يُحبّ برفقٍ، و-: وعصمه فهو لطيف به، والاسم: اللطف، و- الشيء: دنا.
[19] جاء في «أقرب الموارد»: الفِطْنةُ بالكسر: الحِذق والفهم، قد تُفسَّر بجودة تهيّؤِ النفسِ لتصوّر ما يرِدُ عليها مِن الغير؛ ويُقابلُها الغَباوة. ج: فِطَن.
[20] مقتبس من الآيتَيْن 50 و51، من السورة 74: المدثّر: {كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ، فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ}.
[21] «البرهان في تفسير القرآن» ج 2، ص 930، الطبعة الحجريّة، سنة 1302 هـ؛ وقد روي هذه الرواية شيخنا الأقدم علي بن محمّد الخزّاز القمّيّ الرازيّ مع اختلاف طفيف في الألفاظ وبنفس السند دون واسطة ابن بابويه بل عن علي بن الحسين (أبيه) مباشرة، في كتاب «كفاية الأثر في النصّ على الأئمّة الاثني عشر» ص 255 إلى 259، طبعة انتشارات بيدار، سنة 1401 هـ.
[22] جاء في «أقرب الموارد»: الحاصلُ مِن كلّ شيء: ما بقي وثبت وذهب ما سِواه، يكونُ من الحساب والأعمال ونحوها. وحاصل الشيء: بقيّته؛ ج: حواصل. الحاصل أيضاً: ما خلَص من الفضّة من حجارة المعدن، ويقال للذي يُخلِّصُه: مُحصِّل.
و جاء في النسخة المصحّحة والمطبوعة للشيخ المصطفويّ (مركز نشر كتاب- طهران) سنة 1379 هـ، ص 52 و53، باب 76: يَجْمَعُ فَوَاضِلَ الأعْمَالِ.
و في نسخة الملّا عبد الرزّاق الجيلانيّ الشارح لـ «لمصباح الشريعة» الذي صحّحه السيّد جلال الدين المحدّث الارمَويّ وطبعته (انتشارات دانشگاه طهران) سنة 1344 هـ ج 2، ص 136: فَوَاضِل.
[23] لا وجود لكلمة عِلم في «المستدرك».
[24] في نسخة «البحار» و«مصباح الشريعة» لحجّة الإسلام المصطفويّ كذا: في تَقْوِيمِ مَا بِهِ العِلْمُ والأعْمَالُ، والعَامِلُ والمَعْمُولِ بِالعَمَلِ. وأمّا في نسخة «شرح المصباح» للملّا عبد الرزّاق الجيلانيّ، وتصحيح الارمويّ، ج 2، ص 137، فقد وردت العبارة الآنفة كذا: في تَقْوِيمِ مَا بِهِ العِلْمُ والأعْمَالُ والعَامِلُ والمَعْمُولُ والعَمَلُ.
و لهذا نقلنا العبارات التي تَلَت العبارة المذكورة هنا عن نسخة الملّا عبد الرزّاق الجيلانيّ.
[25] «بحار الأنوار» ج 70، ص 245، طبعة الدار الإسلاميّة؛ وفي طبعة الكمبانيّ القديمة: ج 15، من القسم الثاني، ص 86، باب الإخلاص ومعنى قُربه تعالى؛ وفي «مستدرك الوسائل» ج 1، ص 10، الطبعة الحجريّة، مقدّمة العبادات، باب وجوب الإخلاص في العبادة والنيّة، من «مصباح الشريعة»؛ وكتاب «أسرار الصلاة» للشهيد الثاني، ص 125، الطبعة الحجريّة، طهران سنة 1312، ضمن بيان أسرار النيّة من «مصباح الشريعة»؛ و«مصباح الشريعة» ص 52 و53، الباب 76، من طبعة مركز نشر كتاب، بتصحيح وتعليق حجّة الإسلام والمسلمين الحاجّ الشيخ حسن المصطفويّ.
و قد أضاف الملّا عبد الرزّاق الجيلانيّ هنا شرحاً وهذه ترجمته: «و نسبَ الإتيان إلى الموت لا إلى المخاطب بسبب مرارة الموت وأن الموت ليس ممّا يمكن للإنسان أن يصله فيرضى به، إذن ففي قصّة الموت نرى وصول الموت إليه لا وصوله هو إلى الموت. أو هو إشارة إلى عِظَمِ منزلة الموت باعتبار الأهوال التي تسبقه وتخلفه. اي أنّه بسبب كون الموت مخيفاً ومهولًا فإنّ وصول العبد الضعيف إليه مُتعسّر أو قل مُتعذِّر، فإذا وقع (الموت) فإنّ ذلك مُتصوّر من قِبَل الموت لا من قِبَل العبد؛[ كما نُقِلَ] عن الخواجة جمال الدين محمود الشيرازيّ والذي كان من جملة تلاميذ الملّا جلال الدوانيّ أنّه قال لُاستاذه يوماً: يا شيخنا! هل سيأتي علينا يوم يمكن لنا أن نصل فيه إلى الفضيلة وبالجملة نرتقي فيه درجات العِلم فنكون في عداد الفضلاء؟! فقال استاذه: لن تصلوا إلى الفضل أبداً، لكنّ الفضل نفسه سيصلكم! اي أن الفضيلة والعِلم سينزلان تدريجيّاً ويصلان إليكم.
و يفسّر الصوفيّة اليقين بمرتبة الوصول إلى الحقّ. اي أن مَن وصل الحقّ عن طريق الرياضات والمجاهدات وهجر المتعلّقات البدنيّة ورفض الغواشي الهيوليّة سقطت عنه العبادات ورُفعَ عنه التكليف؛ وهذا ممّا لا معنى له على الإطلاق؛ إذ أنّه لو كان الوصول إلى أعلى مراتب الرياضة وأقصى درجاتها ينتج عنه سقوط التكاليف لكان سقوطها أوجب للأنبياء والأوصياء».
[26] «بحار الأنوار» طبعة الكمبانيّ: ج 9، ص 580؛ وطبعة آخوندي: ج 41، ص 295، الرواية رقم 18، وذكر المرحوم الشيخ جعفر الشوشتريّ القسم الأوّل من الرواية في كتاب «خصائص الحسين» عليه السلام، ص 115 و116، الطبعة الحجريّة.
[27] «خصائص الحسين» ص 112 و113، الطبعة الحجريّة، سنة 1303 هـ.
[28] صدر الآية 78، من السورة 4: النساء.
[29] مقطع من الآية 154، من السورة 3: آل عمران.
[30] جاء في «أقرب الموارد»: تَعِسَ (ل) تَعْساً: لغةٌ فهو تَعِسٌ مثل تَعِب. وتَتعدَّى هذه بالحركة وبالهمزة فيُقال: تَعَسَه اللهُ وأتعَسَه. ومنه: هو منحوسٌ متعوسٌ، تَعْساً له، اي ألزَمه اللهُ هلاكاً، وهو مفعول مطلقٌ عاملُه محذوفٌ.
[31] «خصائص الحسين» ص 119 و120؛ وهذه الآية هي مقطع من الآية 42، من السورة 8: الأنفال.
[32] «خصائص الحسين» ص 123.
 الاكثر قراءة في التوحيد
الاكثر قراءة في التوحيد
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية












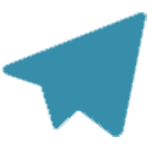
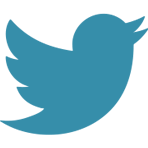

 (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام) قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)
قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)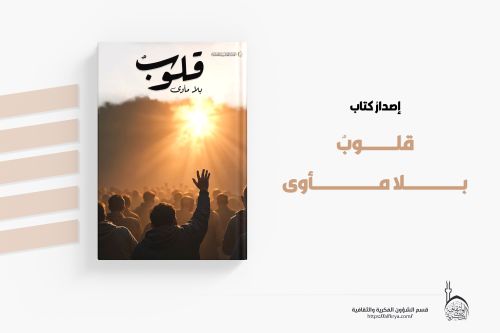 قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)
قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)