الخوف-حين يكشف الإنسان حدوده ومعناه
قراءة ثقافية تحليلية في النفس والسلطة والوعي الديني
الأستاذ الدكتور نوري حسين نور الهاشمي
28/12/2025
يُعدّ الخوف ظاهرة إنسانية مركّبة، تتجاوز بعدها النفسي لتتداخل مع السياقات الاجتماعية والسياسية والدينية. ولا يمكن فهمه بوصفه استجابة فردية فحسب، بل بوصفه عنصرًا مؤثرًا في تشكيل الوعي والسلوك داخل المجتمعات.
يقدّم هذا المقال قراءة ثقافية تحليلية لمفهوم الخوف، من خلال تتبّع تمظهراته في النفس الفردية، ودوره في الخطاب السلطوي، ودلالاته في الوعي الديني، سعيًا إلى مقاربة الخوف بوصفه مفهومًا كاشفًا لعلاقة الإنسان بحدوده ومعناه.
الخوف لحظةُ انكشاف، يواجه فيها الإنسان هشاشته التي يحاول — بكل ما يملك من عقلٍ وخبرةٍ واعتداد — أن يخفيها تحت طبقات من الصلابة المصطنعة. وقد يبدو الخوف في ظاهره انفعالًا فطريًا يشترك فيه الإنسان مع الحيوان، لكنه في جوهره أعمق بكثير من مجرد ردّ فعلٍ غريزي؛ إذ يعبّر عن علاقة الكائن بحدوده، وعن وعيه بما يهدد وجوده أو كرامته أو أحلامه. ولذلك فإن الخوف، بقدر ما يبدو ضعفًا، هو أيضًا علامة حياة، ودليل على أن النفس ما تزال قادرة على الإحساس بما قد يجرحها، وعلى أن القلب لم يتحوّل إلى حجرٍ لا يتأثر بشيء. ولعلّ القرآن أشار إلى هذه الحقيقة حين ربط بين الإحساس والخشية والحياة القلبية، فقال تعالى:
﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾، فكان الخوف هنا ثمرة وعي، لا أثر رعب.
من الناحية النفسية، يتشكّل الخوف عبر تفاعلٍ معقّد بين التجربة والذاكرة والخيال. فالإنسان لا يخاف من الشيء كما هو، بل من صورته في ذهنه. وقد يشتدّ الخوف حين يأتي من أمرٍ لم يحدث بعد، إذ يبالغ الخيال في تضخيم ما قد يقع، فيخلق سيناريوهاتٍ لا وجود لها. وهذا النوع من الخوف — الخوف من الغد — هو الأكثر إنهاكًا للنفس، لأن الخطر الحقيقي محدود الملامح، بينما الخطر المتخيَّل بلا وجه، وكل ما لا وجه له يصبح أكثر قدرة على بثّ الرعب. ولعلّ القرآن يصف هذا القلق حين يقول تعالى:
﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ﴾، فيكون الخوف جزءًا من امتحان الوعي الإنساني، لا حالةً عارضة خارجة عن معنى الوجود.
لكن الخوف ليس تجربة فردية خالصة؛ فالمجتمع يعلّم أبناءه كيف يخافون، وممَّ يخافون. وفي المجتمعات التي تعيش الحروب أو التوتر السياسي والاقتصادي، يصبح الخوف جزءًا من الثقافة اليومية. ينام الناس على أخبار القتل، ويستيقظون على أخبار الفساد، ويكبر الأطفال وهم يتعلّمون أن العالم مكان غير آمن، وأن الأبواب تُغلق باكرًا، وأن الثقة ترفٌ نادر. في مثل هذه البيئات، لا ينمو الخوف كحالة طارئة، بل يتحوّل إلى طريقة حياة، ويغدو الحذر فضيلة اجتماعية، ويتعامل الناس مع المستقبل بوصفه احتمالًا مفتوحًا على الأسوأ، مصداقًا لقوله تعالى:
﴿وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾، إذ تتراكم المخاوف الصغيرة حتى تصنع قلقًا جمعيًا ثقيلًا.
وعلى المستوى السياسي، تلعب السلطة دورًا محوريًا في صياغة الخوف. فثمة أنظمة تجعل منه أداة حكم، تبثّه في النفوس ليبقى الناس خاضعين، لأن الخائف لا يسأل ولا يحتج ولا يتحرّك. وقد نبّه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا المعنى بقوله في الحديث الصحيح: «أفضلُ الجهاد كلمةُ حقٍّ عند سلطانٍ جائر»، لأن كسر الخوف هو الخطوة الأولى في استعادة الكرامة. وفي المقابل، تنجح أنظمة أخرى في تحويل الخوف إلى دافعٍ للتماسك، عبر خطاب يربط المصير العام بالمصير الفردي، فيتحوّل الخوف من عزلةٍ خانقة إلى شعورٍ بالمشاركة والمسؤولية.
ومع ذلك كله، يبقى البعد الديني للخوف من أكثر الأبعاد تعقيدًا وثراءً في التجربة الإنسانية. فالخوف من الله، كما تقدّمه النصوص، ليس خوفًا من العقوبة بقدر ما هو وعي بالعظمة، وشعور بالمسؤولية أمام عدلٍ لا يغيب عنه شيء:
﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، في توازنٍ دقيق بين الرهبة والرجاء. وفي مدرسة الإمام علي بن أبي طالب والأئمة الأطهار عليهم السلام، يتسامى الخوف من مستوى الرهبة إلى مستوى المعرفة. فلم يكن الإمام علي عليه السلام يخاف الله خوف العبد المرتعد، بل خوف المحبّ الذي يخشى البعد عن منبع النور، فقال في كلمته الخالدة: «ما عبدتك خوفًا من نارك ولا طمعًا في جنتك، ولكن وجدتك أهلًا للعبادة فعبدتك». فهذا الخوف ليس رعبًا، بل احترام يوقظ القلب ويضع الإنسان أمام ذاته وقفة صدق.
وفي خطبه وكلماته، ميّز الإمام علي عليه السلام بين الخوف الذي يُعمِي والخوف الذي يُنقِذ؛ فحذّر من الخوف المشلّ الذي «يُعمي ويُصمّ»، وفتح في الوقت نفسه أفقًا آخر حين قال: «من خاف شيئًا هرب منه، ومن خاف الله هرب إليه». أما الأئمة من بعده عليهم السلام، فقد ربطوا الخوف بمحاسبة النفس لا بالهلع من المصير؛ إذ رُوي عن الإمام الصادق عليه السلام أن الخوف الحقيقي هو أن يلقى الإنسان ربَّه مقصّرًا، لا أن يخاف الموت أو الفقر، في انسجامٍ مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الكَيِّسُ من دانَ نفسَه وعملَ لما بعد الموت».
ورغم هذا البعد الروحي، يبقى الخوف تجربة سياسية وإنسانية في آنٍ واحد. فالإنسان يخاف على وطنه كما يخاف على نفسه، وعلى كرامته كما يخاف على جسده. بل إن الخوف الجماعي قد يتحوّل إلى محرّك للتغيير حين يقترن بالغضب من الظلم. وما من طاغيةٍ سقط في التاريخ إلا بعد أن فقد الناس خوفهم منه، لا بعد أن اشتدّ بطشه، مصداقًا لقوله تعالى:
﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾، حيث يصبح كسر الخوف شرطًا للإيمان بالقدرة على التغيير.
ومع ذلك، فليس الخوف دائمًا هزيمة؛ فقد يكون حماية. فالخوف من الانزلاق الأخلاقي يحفظ الإنسان من الخطأ، والخوف من فقدان الأحبة يجعله ألين قلبًا، والخوف من الزمن الضائع يدفعه إلى العمل. وحتى في مسار المعرفة، كان الخوف من الجهل دافعًا للاكتشاف. وهنا يتحوّل الخوف إلى وعي منظّم، لا إلى قيدٍ خانق.
وتبدأ المشكلة حين يتحوّل الخوف إلى سجنٍ داخلي يمنع الإنسان من أن يحب أو يجرّب أو يتغيّر. فالخوف، مهما تعدّدت وجوهه، يظل في العمق بحثًا عن أمان. وليس في الدنيا أمانٌ مطلق؛ ومن ثمّ فإن إدراك هذه الحقيقة هو ما يكسر الخوف، لا إنكاره. وحين يفهم الإنسان خوفه، يتحوّل إلى تواضعٍ حكيم، لا إلى شلل.
وفي النهاية، الخوف ليس عيبًا، بل العيب أن نصير أسرى له. فالإنسان حين يفهم خوفه ويحتويه، ويصالح ضعفه، يصبح أقرب إلى حقيقته وأقدر على النجاة. وكما قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: «اعرف الحق تعرف أهله»، يمكن القول أيضًا: اعرف خوفك تعرف نفسك؛ لأن الخوف هو الباب الذي يقف عنده الإنسان ليرى داخله بوضوحٍ أكبر، لا ليهرب من العالم، بل ليعود إليه أكثر ثباتًا.

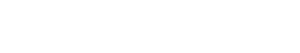




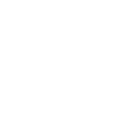














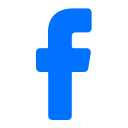

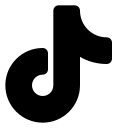








.png) د.فاضل حسن شريف
د.فاضل حسن شريف .png) منذ ساعتين
منذ ساعتين 











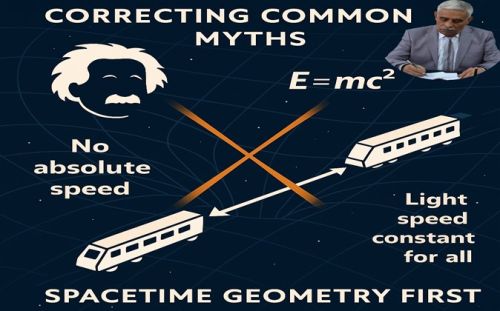




 إستعراض موجز لحياة السيدة زينب الكبرى
إستعراض موجز لحياة السيدة زينب الكبرى الحسين بين الأمس واليوم
الحسين بين الأمس واليوم العيد في زمن كورونا
العيد في زمن كورونا EN
EN