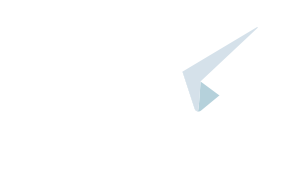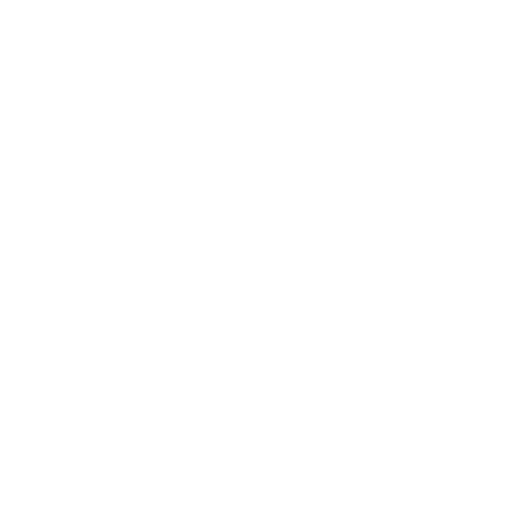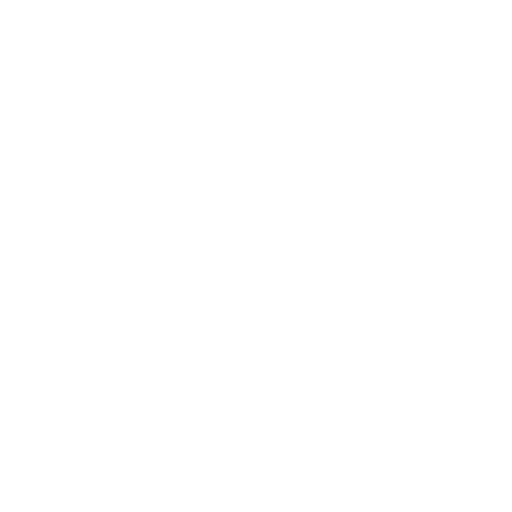المسائل الفقهية


العبادات


التقليد


الطهارة


احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها


التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به


الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض


الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس


الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة


الصلاة


مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)


افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)


الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)


الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم


الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف


الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*


الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد


الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر


الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه


الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين


زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة


ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة


احكام عامة


المعاملات


التجارة والبيع

المكاسب المحرمة والمكروهة وملحقاتها

آداب التجارة

عقد البيع وشروطه

شروط المتعاقدين

التصرف في اموال الصغار وشؤونهم

البيع الفضولي

شروط العوضين

الشروط التي تدرج في عقد البيع

العيوب والخيارات واحكامها

ما يدخل في المبيع

التسليم والقبض

النقد والنسيئة والسلف

المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية

الربا

بيع الصرف

بيع الثمار والخضر والزرع

بيع الحيوان

الإقالة

أحكام عامة


الشفعة

ثبوت الشفعة

الشفيع

الأخذ بالشفعة

بطلان الشفعة

أحكام عامة


الإجارة

شروط الاجارة وأحكام التسليم

لزوم الاجارة

التلف والضمان

أحكام عامة

المزارعة

المساقاة

الجٌعالة

السبق والرماية

الشركة

المضاربة

الوديعة

العارية


اللقطة

اللقيط

الضالة

اللقطة

الغصب

احياء الموات

المشتركات


الدين والقرض

الدين

القرض

الرهن


الحجر

الصغر

الجنون

السفه

الفلس

مرض الموت

أحكام عامة

الضمان

الحوالة

الكفالة

الصلح

الإقرار

الوكالة

الهبة


الوصية

الموصي

الموصى به

الموصى له

الوصي

أحكام عامة


الوقف

عقد الوقف وشرائطه

شرائط الواقف

المتولي والناظر

شرائط العين الموقوفة

شرائط الموقوف عليه

الحبس واخواته

أحكام عامة

الصدقة


النكاح

أحكام النظر والتستر واللمس

حكم النكاح وآدابه

عقد النكاح واوليائه وأحكامه

أسباب التحريم

النكاح المنقطع

خيارت عقد النكاح

المهر

شروط عقد النكاح

الحقوق الزوجية والنشوز

احكام الولادة والاولاد

النفقات

نكاح العبد والاماء

أحكام عامة


الطلاق

شروط الطلاق والمطلٍق والمطَلقة

أقسام الطلاق

الرجعة وأحكامها

العدد

احكام الغائب والمفقود

أحكام عامة

الخلع والمباراة

الظهار

الايلاء

اللعان


الايمان والنذور والعهود

الأيمان

النذور

العهود

الكفارات


الصيد والذباحة

الصيد

الذباحة والنحر

أحكام عامة


الأطعمة والاشربة

الاطعمة والاشربة الحيوانية

الاطعمة والاشربة غير الحيوانية

أحكام عامة


الميراث

موجبات الارث وأقسام الوارث

أنواع السهام ومقدارها واجتماعها

العول والتعصيب

موانع الارث

ارث الطبقة الاولى

ارث الطبقة الثانية

ارث الطبقة الثالثة

ارث الزوج والزوجة

الارث بالولاء

ميراث الحمل والمفقود

ميراث الخنثى

ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

ميراث اصحاب المذاهب والملل الاخرى

الحجب

المناسخات

مخارج السهام وطريقة الحساب

أحكام عامة

العتق

التدبير والمكاتبة والاستيلاد

القضاء

الشهادات


الحدود

حد الزنا

اللواط والسحق والقيادة

حد القذف

حد المسكر والفقاع

حد السرقة

حد المحارب

أحكام عامة

القصاص

التعزيرات

الديات


علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية


الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة


المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء


القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة


المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء


الفقه المقارن


كتاب الطهارة


احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع


احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء


الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه


الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء


المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة


الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها


كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد


افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر


الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة


كتاب الزكاة

احكام الزكاة


ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة


زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم


كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم


كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر


اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس
الإشتراك واستعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى
المؤلف:
ناصر مكارم الشيرازي
المصدر:
أنوَار الاُصُول
الجزء والصفحة:
ج 1 ص 146 - 158.
26-8-2016
4938
ولا بدّ فيه من تقديم اُمور:
الأمر الأوّل: في إمكان وضع الألفاظ المشتركة وعدمه، ثمّ في وقوعه بعد ثبوت إمكانه.
ففيه ثلاث مذاهب: مذهب القائلين بالإمكان، ومذهب القائلين بالاستحالة، ومذهب القائلين بالوجوب.
المذهب الأوّل: فاستدلّ له بوجوه أحسنها وقوع الاشتراك في اللّغة، وأدلّ دليل على إمكان شيء وقوعه، ووقوعه أمر وجداني ثابت بمثل التبادر ونحوه من سائر علائم الحقيقة، مضافاً إلى أنّ الإمكان يثبت بنفي أدلّة القائلين بالامتناع والوجوب كما سيأتي.
أمّا القائلين بالامتناع: فاستدلّوا له بدليلين:
الدليل الأوّل: ما ذكره غير واحد من أنّ الاشتراك مخالف لحكمة الوضع لأنّ به لا يحصل التفهيم والتفهّم.
وفيه: أوّلا: أنّه يمكن حصول التفهّم بالقرينة ولا حاجة إلى كونها لفظيّة حتّى يستشكل بأنّه تطويل بلا طائل بل يمكن كونها مقاميّة أو حاليّة، مضافاً إلى أنّه ليس من قبيل التطويل بل قد يكون موافقاً للفصاحة والبلاغة.
وثانياً: أنّه قد تقتضي الحكمة إطلاق الكلام مجملا مبهماً، والتكلّم من وراء الحجاب وغائباً عن الأغيار، ولا إشكال حينئذ في ثبوت الحاجة.
الدليل الثاني: (وهو مبني على كون الوضع بمعنى التعهّد والالتزام وكون الوضع تعييناً) استحالة أن يتعهّد الإنسان أوّلا على أن يستعمل اللفظ في أحد المعنيين للفظ كلّما استعمله في
كلامه، ثمّ يتعهّد ثانياً كذلك بالنسبة إلى المعنى الآخر، لأنّ أحد التعهّدين مناقض للآخر.
أقول: يمكن التعهّد والالتزام بأنّه كلّما استعمل هذا اللفظ أراد أحد هذين المعنيين، وأمّا تعيين أحدهما بعينه فهو إنّما يكون بالقرينة فلا يلزم حينئذ محذور التناقض.
وأمّا القائلين بالوجوب: (وهو في المقام بمعنى اللابدّية) فاستدلّوا له بأنّ الألفاظ محدودة والمعاني غير متناهية ولولا الألفاظ المشتركة لوقعنا في ضيق وحرج بالنسبة إلى المعاني التي لم توضع بإزائها ألفاظ، فلابدّ لنا من المصير إلى الاشتراك.
والجواب عنه:
أوّلا: إن كان المراد من عدم التناهي، عدم التناهي حقيقة فلا ترتفع الحاجة إلى غير المتناهي بالمتناهي ولو زيد عليه ألف مرّة كما لا يخفى، وإن كان المراد منه الكثرة.
ففيه: أنّ الألفاظ أيضاً كثيرة بل تتجاوز مئات الملايين كما يظهر لنا بمحاسبة ساذجة، بملاحظة ثلاثين حرفاً من الحروف الهجائيّة (لو فرضنا كونها ثلاثين حرفاً) وضربها في نفسها
(30 × 30 = 900) ليحصل منه التراكيب الثنائيّة، ثمّ ضرب العدد الحاصل في الثلاثين أيضاً ليحصل به الكلمات الثلاثيّة (900 × 30 = 27000)، ثمّ ضرب العدد الحاصل في الثلاث لإمكان تغيير موضع الحروف الثلاثة وإمكان تصوير كلّ كلمة ثلاثيّة على ثلاث صور، (27000 × 30 = 810000) وهكذا إلى آخره فيضرب العدد الحاصل في الثلاثين أيضاً ليتشكّل منه الكلمات الرباعيّة، ثمّ ضربه في الأربع، ثمّ ضربه في اثني عشر، ثمّ في الثلاثين أيضاً، ثمّ في خمسة وعشرين ثمّ ملاحظة كيفية الحركات الثلاثة (810000 × 30 = 2430000 × 4 = 9720000 × 12 × 30 × 25 × ...) وعليه فلا إشكال في كفاية الألفاظ عن المعاني بل أنّها أكثر من المعاني، أي تكون القضيّة على العكس، فيمكن أن يقال: إنّ الألفاظ غير متناهية عرفاً، والمعاني التي نحتاج إليها في حياتنا متناهية.
ثانياً: سلّمنا كون المعاني غير متناهية وكون الألفاظ متناهية إلاّ أنّ كلّية كثير من الألفاظ بل أكثرها توجب رفع المشكلة لأنّ مورد الحاجة كثيراً ما يكون هو الكلّي وأمّا الجزئيات والمصاديق فترتفع الحاجة إليها بتطبيق الكلّي على الفرد كما لا يخفى، فإنّا نحتاج إلى وضع اسم لكلّي الحجر أو الشجر أو الدار مثلا ولا نحتاج إلى وضع لفظ لأفرادها بل نتكلّم عنها بتطبيق كلّياتها عليها.
وثالثاً: لا ينحصر طريق حلّ المشكل في الاشتراك بل إنّ باب المجاز واسع.
فظهر: أنّ الحقّ إمكان الاشتراك لا وجوبه ولا امتناعه، كما أنّ الحقّ إمكان الترادف أيضاً لكونه مقتضى حكمة الوضع، فربّما تقتضي الفصاحة استعمال ألفاظ مترادفة في معنى واحد للتأكيد أو غيره.
الأمر الثاني: في علّة الاشتراك ومنشئه
لا إشكال في أنّه من البعيد جدّاً أن يكون منشأ اشتراك بعض الألفاظ وضع واضع واحد، فيضع لفظاً واحداً تارةً لمعنى واُخرى لمعنى آخر، بل يحتمل فيه وجهان آخران:
الوجه الأوّل: أن يكون المنشأ تعدّد الوضع التعييني بسبب تعدّد القبائل والطوائف في لغة واحدة كأن تضع قبيلة لفظاً في معنى، وتضع قبيلة اُخرى من نفس تلك اللّغة ذلك اللفظ في معنى آخر.
الوجه الثاني: الوضع التعيّني، فوضع لفظ العين مثلا في بدو الأمر للعين الباكية ثمّ استعمل في الجارية مجازاً بعلاقة الجريان، وصار بعد كثرة الاستعمال حقيقة، وكذلك بالنسبة إلى المتجسّس بعلاقة النظر وكونه بمنزلة البصر على الخصم، وهكذا بالنسبة إلى سائر معانيه.
أضف إلى ذلك ما يقع في الأعلام الشخصيّة، فإنّه كثيراً ما يختارون اسم «محمّد» لأفراد كثيرة، أو اسم فاطمة لعدّة بنات تبرّكاً بإسم النبي (صلى الله عليه وآله) وبنته الزهراء (سلام الله عليها) ، فيكون هذا من أسباب الاشتراك في الأعلام، أو يسمّون مسجداً باسم أمير المؤمنين (عليه السلام) في بعض البلاد، ومسجداً آخر بإسمه (عليه السلام) في بلدة اُخرى وهكذا.
لكن هنا أمر ينبغي التنبيه عليه، وهو أنّا وإن قلنا بإمكان المشترك ووقوعه لا سيّما في باب الأعلام إلاّ أنّ كثيراً من الألفاظ التي يتوهّم كونها مشتركاً لفظيّاً، مشترك معنوي أو من
قبيل الحقيقة والمجاز، نحو «القرء» فإنّ المعروف كونه مشتركاً لفظياً وإنّه وضع للطهر تارةً وللحيض اُخرى، مع أنّه مشترك معنوي وضع لمعنى انتقال المرأة من حال إلى حال، والانتقال له فردان: الانتقال من الطهر إلى الحيض وبالعكس، ويشهد عليه استعماله في مطلق الانتقال في لسان القرآن وكلمات بعض أهل اللّغة، ولعلّ لفظ «العين» بالنسبة إلى معانيها الكثيرة أيضاً كذلك، كما يشهد له عبارات المفردات للراغب في ذيل البحث عن كلمة «عين» وإليك نصّها
بالحرف: عين = العين الجارحة ... ويستعار العين لمعان هي موجودة في الجارحة بنظرات مختلفة، ويستعار للثُقب في المِزادة تشبيهاً بها في الهيئة وفي سيلان الماء منها، فاشتقّ منها سقاءٌ عيِّن ... والمتجسّس عين تشبيهاً بها في نظرها، وقيل للذهب عين تشبيهاً بها في كونها أفضل الجواهر، كما أنّ هذه الجارحة أفضل الجوارح، ومنه قيل: أعيان القوم لأفاضلهم، وأعيان الاُخوّة لبني أب واُم ... ويقال لمنبع الماء عين تشبيهاً بها لما فيها من الماء، وعن عين الماء اشتقّ «ماء معين» أي ظاهر للعيون ... ويقال لبقر الوحش «أعين» و «عيناء» لحسن عينيه. (انتهى).
ولا يخفى أنّ هذه العبارة تنادي بأعلى صوته أنّ العين ليس مشتركاً لفظيّاً، والظاهر عدم اختصاص هذا المعنى بهذه اللّفظة، بل يجري في كثير من الألفاظ التي يدّعي اشتراكها.
اللهمّ إلاّ أن يقال في خصوص لفظ «العين» إنّ ما ذكره الراغب في المفردات إنّما هو بيان لوجه استعمال العين في غير الجارحة المعروفة، والعلاقة الموجودة بينهما، ولكن بعد كثرة الاستعمال صار حقيقة فيها كما هو حقيقة في الجارحة المعروفة، فحصل الاشتراك اللّفظي.
وعلى كلّ حال نحن وإن قلنا بأنّ كثيراً من الألفاظ التي يتصوّر اشتراكها لفظاً تكون من المشترك المعنوي واقعاً، ولكن ما قد يظهر من بعض (مثل صاحب كتاب: «التحقيق في كلمات القرآن الكريم») من إرجاع جميع الكلمات المشتركة الواردة في القرآن الكريم إلى أصل واحد ممّا لا دليل عليه، ولا داعي له، ومن أقوى الأدلّة على نفي هذا القول بعض التكلّفات التي ارتكبها في كثير من اللغات المشتركة بداعي ارجاعها إلى أصل واحد.
الأمر الثالث: في إمكان وقوعه في كلام الله تعالى
ويدلّ عليه أوّلا: أنّه مقتضى بلاغة الكلام لأنّها تقتضي أحياناً إطلاق الكلام مجملا مردّداً، ولا إشكال في أنّ كلام الله تعالى أبلغ الكلمات.
وثانياً: ما قد يقال: إنّ أدلّ الدليل على إمكان شيء وقوعه، ولقد وقع استعمال المشترك في القرآن نحو لفظ العين فإنّه تارةً استعمل في العين الجارية في قوله تعالى { إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ} [الحجر: 45] واُخرى في العين الباكيّة في قوله تعالى: {وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ } [يوسف: 84] ولكن قد عرفت الإشكال في كون لفظ العين من المشتركات اللّفظيّة.
هذا تمام الكلام فيما أردناه من الاُمور الثلاثة بعنوان المقدّمة.
ولنرجع إلى البحث في استعمال المشترك في أكثر من معنى، الذي له أثرات مهمّة في الفقه والتفسير، وليس محل النزاع استعمال اللفظ المشترك في القدر الجامع بين المعنيين فإنّه لا مانع منه ولا خلاف فيه، بل البحث في استعمال لفظ واحد في آن واحد في كلّ من المعنيين في عرض واحد، كما أنّ النزاع يعمّ الحقيقة والمجاز أو الحقيقة والكناية أي استعمال لفظ واحد في معناه الحقيقي والمجازي أو في معناه الحقيقي والكنائي في عرض واحد، لعدم كون النزاع مختصّاً بالألفاظ المشتركة، ولتداخل الجميع في كثير من الأدلّة، وعليه فعنوان البحث «هل يجوز استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى سواء كان من باب الاشتراك، أو الحقيقة والمجاز أو الحقيقة والكناية؟».
الأقوال في مسألة استعمال المشترك في أكثر من معنى:
والأقوال فيها كثيرة يمكن جمعها في ثلاثة:
الأوّل: الجواز مطلقاً، الثاني: الاستحالة مطلقاً، الثالث: التفصيل تارةً بين المفرد والتثنية والجمع، واُخرى بين النفي والإثبات.
وقد ذهب كثير من الأعاظم إلى الاستحالة عقلا، بل هو المشهور بين المتأخّرين مثل المحقّق الخراساني والمحقّق النائيني (رحمهما الله) وغيرهما، وذهب إلى الجواز في التهذيب والمحاضرات وهو المحقّق المختار.
واستدلّ القائلون بالاستحالة بما حاصله: أنّ استعمال لفظ واحد في المعنيين يستلزم الجمع بين اللحاظين في آن واحد وهو محال.
توضيحه: أنّ حقيقة الاستعمال ليست عبارة عن جعل اللفظ علامة للمعنى حتّى يقال أنّه لا مانع من جعل لفظ واحد علامة لمعنيين أو الأكثر، بل هو فناء اللفظ في المعنى وجعله وجهاً ومرآة وعنواناً للمعنى، كأنّ ما يجري على اللسان هو نفس المعنى لا اللفظ، كما يشهد عليه سراية قبح المعنى إلى اللفظ وبالعكس، إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ استعمال لفظ واحد في معنيين يستلزم كونه فانياً في كلّ واحد مستقلا، ومن المعلوم أنّ لحاظه كذلك في معنى ينافي لحاظه في معنى آخر فلا يكون وجهاً لمعنيين وفانياً في اثنين إلاّ أن يكون اللاحظ أحول العينين.
ويرد عليه:
أوّلا: أنّ القول بكون حقيقة الاستعمال فناء اللفظ في المعنى كلام شعري لا دليل عليه، بل هي عبارة عن جعل اللفظ علامة للمعنى كما عرفت بيانه في محلّه، وأمّا قضيّة سراية القبح والحسن فليست من جهة الفناء بل هي ناشئة من كثرة الاستعمال وحصول الاُنس أو المنافرة بالنسبة إلى المعنى، ولذا لا يحسّ متعلّم اللّغة الجديدة قبحاً ولا حسناً في الألفاظ لعدم حصول كثرة الاستعمال والاُنس بالنسبة إليه.
ثانياً: سلّمنا كون اللفظ فانياً في المعنى لكن إنّما يستلزم المحال فيما إذا تحقّق اللحاظان في آن واحد، وأمّا ملاحظة المعنيين بلحاظين مستقلّين في آنين مختلفين قبل وقوع الاستعمال ثمّ استعمال اللفظ فيهما ثانياً فلا مانع منه ولا يلزم منه محذور ولا حاجة إلى لحاظ المعنيين في آن واحد، أي لا دليل على لزوم وحدة آن اللحاظ في الاستعمال.
وثالثاً: أنّ أدلّ دليل على إمكان شيء وقوعه، ولا ينبغي الإشكال في وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد في كلمات الفصحاء والبلغاء، كما يقال في جواب من شكى وجعاً في عينه الباكية وجفاف عينه الجارية: «أصلح الله عينك» ويراد منه كلا المعنيين، بل لا يخفى لطفه وأنّه يستحسنه الطبع والوجدان اللغوي، كما لا إشكال في أن يقول من دخل على زيد في داره ورأى جوده وسخائه مضافاً إلى كثرة رماده: «أنت كثير الرماد» بمعنيين فيريد المعنى الحقيقي والمعنى الكنائي معاً في استعمال واحد، وكقول الشارع في مدح النبي الأعظم(صلى الله عليه وآله) في شعر لطيف له:
المرتمى في الدجى والمبتلى بعمى *** والمشتكى ظمئاً والمبتغى ديناً
يأتون سدّته من كلّ ناحية *** ويستفيدون من نعمائه عيناً
فاستعمل لفظ العين في معان أربعة : الشمس والعين الباكية والعين الجارية والذهب(1).
لا يقال: إنّه استعمل حينئذ في الجامع بينهما وهو المسمّى بالعين فيكون من باب المشترك المعنوي، لأنّ استعماله في جامع من هذا القبيل في غاية الغرابة وخارج عن المحسنات الذوقيّة بل يوجب خروج تلك الأبيات عن جمالها ولطافتها إلى أمر مبتذل كما لا يخفى. مضافاً إلى كونه خلاف الوجدان، ولا فرق في ذلك بين كون العين مشتركاً لفظيّاً أو حقيقة في الجارحة ومجازاً في غيرها.
ورابعاً: الرّوايات الكثيرة الواردة في بيان أنّ للقرآن بطناً أو سبعة أبطن أو أكثر من ذلك ظاهرة في أنّ اللفظ الواحد استعمل في معان متعدّدة.
وقد جمعها العلاّمة المحقّق المجلسي(رحمه الله) في المجلّد 89 في كتاب القرآن في الباب 8 «أنّ للقرآن ظهراً وبطناً ...» وقد أورد فيها أكثر من ثمانين رواية كثير منها دليل على المطلوب.
منها: ما رواه عن المحاسن عن جابر بن يزيد الجعفي قال «سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن شيء من التفسير فأجابني ثمّ سألته عنه ثانيّة فأجابني بجواب آخر، فقلت: جعلت فداك كنت أجبتني في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم، فقال: ياجابر، إنّ للقرآن بطناً وللبطن بطن وله ظهر وللظهر ظهر»(2).
ومنها: ما رواه عن تفسير العياشي عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن هذه الرّواية «ما في القرآن آية إلاّ ولها ظهر وبطن ... ما يعني بقوله «لها ظهر وبطن» قال: ظهره تنزيله وبطنه تأويله، منه ما مضى ومنه ما لم يكن بعد، يجري كما تجري الشمس والقمر...»(3).
وقد رويت هذه الرّواية في الوسائل بعبارة أوضح عن فضيل بن يسار قال سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن هذه الرّواية: «ما من القرآن آية إلاّ ولها ظهر وبطن» فقال: ظهره تنزيله وبطنه تأويله منه ما قد مضى ومنه ما لم يكن يجري كما يجري الشمس والقمر ـ إلى أن قال ـ وما يعلم تأويله إلاّ الله والراسخون في العلم »(4).
إلى غير ذلك ممّا ورد في هذا المعنى، هذا من جانب.
ومن جانب آخر هناك روايات كثيرة وردت في تفسير آيات القرآن ممّا لا يحتمله ظاهره أو يعلم أنّه ليس بمراد من ظاهره، مثل تفسير «البحرين» في قوله تعالى {مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ} [الرحمن: 19] بأمير المؤمنين وفاطمة (عليهما السلام)، وتفسير «اللؤلؤ والمرجان» في قوله تعالى {يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ} [الرحمن: 22] بالحسنين (عليهما السلام)وكذلك تفسير «الماء المعين» في قوله تعالى: {أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ} [الملك: 30] بظهور الحجّة (عليه السلام) وتفسير قوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} [الحج: 29] (التفث بمعنى الوسخ) بلقاء الإمام (عليه السلام) حيث سأل عنه عبدالله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) فقال: أخذ الشارب وقصّ الأظفار وما أشبه ذلك، قال: جعلت فداك فإنّ ذريحاً المحاربي حدّثني أنّك قلت: ثمّ ليقضوا تفثهم لقى الإمام ... فقال: صدق ذريح وصدقت، إنّ للقرآن ظاهراً وباطناً ومن يحتمل ما يحتمل ذريح »(5) إلى غير ذلك من أشباهه.
ولا ريب أنّ الحسنين (عليهما السلام) ليسا معنىً حقيقيّاً للؤلؤ والمرجان، وكذلك المهدي (أنفسنا لنفسه الوقاء) ليس مصداقاً حقيقيّاً للماء المعين بل معناه الحقيقي هو المادّة السيّالة المخصوصة حتّى أنّ الماء المضاف من معانيه المجازيّة فكيف بغيره؟ فلا يبقى هنا مجال إلاّ الاستعمال في أكثر من معنى، كلّ واحد مستقلّ عن الآخر، معنى حقيقي ومعنى مجازي (وإن كان المجاز هنا أرقى من الحقيقة من حيث الجمال الأدبي وروعة البيان).
إن قلت: لِمَ لا يجوز استعماله في القدر الجامع المشترك بين المعنيين اشتراكاً معنويّاً كأن يقال: إنّ المراد بالماء المعين هو الذي يكون سبباً للحياة، والمراد باللؤلؤ والمرجان هو الشيء النفيس مادّياً كان أو معنويّاً، وكذلك «التفث» أعمّ من الوسخ الظاهري والباطني، فالأوّل يزول بقصّ الأظفار وأخذ الشارب وغيرهما، والثاني بملاقاة الإمام (عليه السلام)؟
قلنا: أوّلا: لازم ذلك أن تكون الآيات القرآنيّة محمولة على المجازات كلّها أو جلّها لأنّ جميعها يشتمل على البطون، ومن الواضح أنّ البطن معنى مجازي (كاستعمال الماء المعين في المهدي أرواحنا فداه) واستعمال اللفظ في القدر الجامع بين المعنى الحقيقي والمجازي استعمال
مجازي (لأنّ النتيجة تابعة لأخسّ المقدّمتين) ولا يمكن الالتزام بذلك.
وثانياً: لازم ذلك أن يكون قوله تعالى: (يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ)(مثلا) عامّاً شاملا لكلّ شيء نفيس، فلا ينحصر بوجود الحسنين (عليهما السلام) بل يشمل كلّ ما كان ثميناً معنويّاً، ولا يمكن الالتزام بذلك أيضاً، وكذلك الماء المعين يشمل جميع ما كان سبباً للحياة المعنويّة من العلم والتقوى والمعرفة، وكلّ إنسان له حظّ من المعنويات، وهل يلتزم القائل بذلك؟
وإن شئت قلت: الجامع بين خصوص «اللؤلؤ والمرجان» الظاهريين اللّذين هما المعنى الحقيقي لهذين اللّفظين بحسب المتبادر ونصّ أهل اللّغة، وبين وجود الحسنين (عليهما السلام) بحيث لا يشمل غيرهما، غير موجود، والموجود من القدر الجامع يشمل كلّ موجود له نفاسة وقيمة.
وثالثاً: حمل اللفظ على القدر الجامع بين المصاديق المادّية والمعنويّة (الحقيقيّة والمجازيّة وإن كان المجاز ما فوق الحقيقة) أمر يعرفه كلّ من له خبرة بمعنى الكلمات ولا يختصّ ذلك بالراسخين في العلم من الأئمّة المعصومين (عليهم السلام).
ويستفاد من جميع ذلك أنّ البطون ليست سوى معان مستقلّة اُريدت من الكلام إلى جنب المعنى الظاهري، وعلمها عند أهلها، فيكون من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وإن لم يكن كلّها معان حقيقيّة (فإنّ محلّ الكلام أعمّ).
إن قلت: أو لست تقول: إنّ استعمال اللفظ في أكثر من معنى وإن كان جائزاً ولكنّه يحتاج إلى القرينة، ولا نرى قرينة للبطون.
قلنا: نعم، ولكن اُقيمت القرينة لمن قصد افهامه من اللفظ وهم الأئمّة المعصومون الراسخون في العلم، وإرادة معنى من اللفظ في خطاب جميع الناس وإرادة معنى آخر (مضافاً إلى المعنى الأوّل) لأوحدي منهم مع إقامة القرائن له فقط ـ لا يعدّ أمراً مستنكراً كما لا يخفى.
وممّا ذكرنا يظهر أنّ ما أفاده المحقّق الخراساني(رحمه الله) لتوجيه روايات البطون غير مرضي عندنا فإنه قال:
1 ـ إنّ المراد من البطون معان اُخرى قد اُريدت في أنفسها في حال الاستعمال لا من اللفظ.
2 ـ يمكن أن يكون المراد لوازم المعنى المستعمل فيه اللفظ وإن كانت أفهامنا قاصرة عن ادراكها.
ولكن الجواب الأوّل عجيب منه، فإنّ لازمه أنّ المراد من بطون القرآن معان كانت
موجودة في ذهن المتكلّم فأرادها مقارناً للمعنى المستعمل فيه اللفظ من دون أي ربط بينهما ومن دون استعمال اللفظ في تلك المعاني، وهذا عجيب منه ومعلوم بطلانه.
وأمّا الجواب الثاني ففيه أنّه ينتقض بما يعدّ من بطون القرآن ولا يكون من لوازم المعنى الموضوع له، نحو كلمة «الجوار الخنّس» في الآية التي فسّرت في الرّواية بالإمام الغائب (أنفسنا له الفداء) مع كونه في اللّغة بمعنى الكواكب المتحرّكة التي تغرب وتحتجب عن النظر، ولا ملازمة بين المعنيين كما لا يخفى.
وأمّا القول بأنّه استعمل في معنى جامع ـ و يرد عليه ما سبق آنفاً من الإيرادات الثلاثة.
وممّا ذكرنا ظهر أمران:
الأوّل: أنّ استعمال اللفظ في أكثر من معنى وإن كان ممكناً إلاّ أنّه حيث كان مخالفاً لظاهر الكلام فيحتاج إلى القرينة المعيّنة للمعاني المرادة لا القرينة على المجاز كما في الأبيات المذكورة آنفاً، وبدونها لا يصحّ حمل اللفظ على المعنيين أو أكثر، بل يحمل على معنى واحد من معانيه، فإن كان هناك قرينة معيّنة فيها فهو وإلاّ كان مجملا.
نعم لا فرق بين أن تكون القرينة داخلية أو خارجيّة، فالداخلية مثل ما مرّ في ما مضت من الأبيات، فإنّ كلمة «في الدجى» وكلمة «ظمئاً» مثلا قرينتان على استعمال العين في الشمس والعين الجارحة، والخارجيّة نظير ما مرّ من تفسير الإمام (عليه السلام) في الآيات الثلاث.
الثاني: قد ظهر ممّا ذكرنا هنا أنّه لا فرق من ناحية العقل بين استعمال اللفظ في المعنيين الحقيقيين، أو المعنى الحقيقي والمجازي، أو الحقيقي والكنائي نفياً واثباتاً، لأنّ دليل الاستحالة المذكورة سابقاً كان منحصراً في امتناع اجتماع اللحاظين، وهو يتصوّر في كلّ واحد من التقادير، فبمنعه يثبت الجواز أيضاً في جميعها.
إلى هنا تمّ الدليل الأوّل للامتناع، وقد تبيّن ممّا ذكر في جوابه دليل المختار من جواز الاستعمال في أكثر من معنى.
وأمّا الدليل الثاني فهو ما قد يقال من أنّ الألفاظ وجودات تنزيلية للمعاني وكأنّ المعنى يوجد بإيجاد اللفظ، ولذلك قالوا بأنّ للوجود أنواعاً أربعة: وجوداً خارجياً، ووجوداً ذهنياً، ووجوداً كتبيّاً، ووجوداً لفظيّاً، فعدّ اللفظ أيضاً من أنواع الوجود، وحيث لا يكون لحقيقة واحدة وجودان خارجيان، فكذلك لا يكون للفظ واحد معنيان.
والجواب عنه: إنّ المراد من كون الألفاظ وجودات تنزيلية للمعاني تشبيه للألفاظ بالوجودات الخارجيّة، ويكون المقصود هيهنا أنّ وجود اللفظ علامة لوجود المعنى، وإلاّ لا إشكال في أنّ اللفظ ودلالته على معناه أمر اعتباري عقلائي ولا يقاس بالوجودات الحقيقيّة الخارجيّة، فإنّ هذا أيضاً من الموارد التي وقع فيها الخلط بين المسائل اللغويّة والمسائل الفلسفية، وعليه لا مانع من استعمال لفظ وإرادة معنيين.
وإن شئت قلت: سلّمنا كون اللفظ وجوداً تنزيليّاً للمعنى، ولكن أي مانع من تنزيل شيء واحد منزلة الشيئين، فإنّ التنزيل أمر اعتباري ولا مانع من اجتماع اُمور اعتباريّة عند استعمال لفظ واحد.
الثالث: إنّه باللفظ يوجد المعنى، واللفظ يكون علّة للمعنى ولا يصدر من العلّة الواحدة إلاّ معلول واحد.
وفيه: أنّ هذا أيضاً من أوضح مصاديق الخلط بين المسائل الفلسفية والحقائق الاعتباريّة، فإنّ قاعدة الواحد (على القول بها) مختصّة بالواحد البسيط الحقيقي التكويني كما مرّ غير مرّة، وأمّا وضع الألفاظ فأمر اعتباري محض ولا يجري فيه قانون العلّية فضلا عن قاعدة الواحد. هذا أوّلا.
وثانياً: سلّمنا ـ لكن ليس اللفظ في استعماله في أكثر من معنى تمام العلّة لإيجاد المعنى بل هو جزء للعلّة التامّة، والجزء الآخر هو القرينة ولا إشكال في أن يصير لفظ واحد بضمّ قرينة علّة لإيجاد معنى، وبضمّ قرينة اُخرى علّة لإيجاد معنى آخر فتأمّل(6).
هذا كلّه في أدلّة القائلين بالاستحالة العقليّة.
أمّا القائلون بعدم الجواز لغة وعرفاً فهم طائفتان: طائفة قالوا بعدم الجواز حقيقة والجواز مجازاً، وطائفة اُخرى قالوا بعدم الجواز حقيقة ومجازاً، والإنصاف أنّ طريق هاتين الطائفتين أسلم اشكالا من طريق القائلين بالاستحالة العقليّة وإن كانت مقالتهم أيضاً لا تخلو من الضعف والإشكال كما سيأتي.
واستدلّ الطائفة الاُولى بوجهين:
الأوّل: أنّ الوحدة جزء للموضوع له لأنّ اللفظ وضع للمعنى الواحد، فإذا استعمل في المعنيين استعمل في غير ما وضع له فيصير مجازاً.
الثاني: أنّ اللفظ وضع للمعنى في حال الوحدة، فكأنّ الواضع اشترط أن يستعمل اللفظ حال الوحدة، حيث إنّ اللغات توقيفيّة، فلابدّ لاستعمال اللفظ في المتعدّد إلى إذن من الواضع.
وأمّا الطائفة الثانيّة: فاستدلّوا لعدم الجواز حقيقة بنفس ما استدلّ به الطائفة الاُولى، ولعدم الجواز مجازاً بعدم وجود علاقة بين الواحد والمتعدّد لأنّهما ضدّان، لكون أحدهما مأخوذاً بشرط شيء والآخر بشرط لا، ولا إشكال في أنّهما متباينان، وأمّا علاقة الكلّ والجزء فلا تتصوّر هنا لأنّ الوحدة شرط للموضوع له وليست بجزء له.
والجواب: عن كلتا الطائفتين: إن كان المراد من قيد الوحدة أنّ اللفظ وضع لمعناه لأن يستعمل فيه باللحاظ الاستقلالي فإنّه حاصل في ما نحن فيه، لأنّ المراد من استعمال لفظ في أكثر من معنى استعماله في كلّ واحد بلحاظ مستقلّ لا في المجموع من حيث المجموع.
وإن كان المراد منها أنّ اللفظ وضع لأن يراد منه معنى واحد لا معنيان وإن كان يلاحظ كلّ واحد منهما مستقلا فهو دعوى بلا دليل.
وإن كان المراد أنّ اللفظ يستعمل في الاستعمالات المتعارفة في معنى واحد وهذا يوجب ظهور اللفظ في معنى واحد، فهو حقّ ولكنّه ظهور انصرافي، أي ينصرف اللفظ إلى الوحدة لا ظهور حقيقي بحيث يكون في غيره مجازاً، لأنّ منشأ الظهور هنا كثرة الاستعمال في العرف لا التبادر الذي يكون من علائم الوضع، فليست الوحدة جزءاً للموضوع له بل اللفظ ظاهر في معنى واحد ولا بدّ لاستعماله في الأكثر من قرينة معيّنة للأكثر وصارفة عن المعنى الواحد.
وأمّا القائلون بالتفصيل بين التثنية والجمع والمفرد فتمسّكوا لعدم الجواز في المفرد بما مرّ من اعتبار الوحدة أيضاً فقالوا: إنّ التثنية أو الجمع في حكم تكرار اللفظ فلا ينافيان قيد الوحدة فإنّ «العينين» مثلا بمعنى عين وعين.
والجواب عنه: أنّه لا إشكال في أنّ معنى التثنية هو الفردان من معنى واحد، وكذلك الجمع فإنّه أفراد من كلّي واحد كما أنّ المفرد فرد واحد من ذلك المعنى فالتثنية والجمع في حكم تكرار الفرد لا تكرار اللفظ.
إن قلت: فما تقول في «زيدان» مع أنّ المفرد فيه جزئي لا يتصوّر فيه الأفراد؟
قلت: الوجدان حاكم على أنّ المراد من «زيدان» فردان من كلّي «المسمّى بزيد».
وأمّا القائلون بالتفصيل بين النفي والإثبات فاستدلّوا بأنّ ما وقع في حيّز النفي يفيد معنى الجمع فدليلهم هو الدليل، والجواب أيضاً هو الجواب.
_______________
1. ومن طريف ما ينبغي ذكره في هذا المجال ما أنشده الشاعر الفارسي وقال:
«از در بخشندگى و بنده نوازى ـ مرغ هوا را نصيب ماهى دريا» حيث يمكن أن يراد منه خمس معان مختلفة في نفس الوقت، كلّ واحد أحسن من غيره: أحدها: أن يراد كون بعض الطير نصيباً لأسماك البحر (كما نقل أنّ هناك سمكة تشبه بالسفرة المبسوطة على وجه الماء) ثانيها: أنّ بعض الأسماك يكون نصيباً لطير الهواء. ثالثها: أنّ نصيب الطير هو الهواء كما أنّ نصيب السمك هو الماء. رابعها: أنّ الله جعل كليهما نصيب الإنسان. خامسها: أنّ لكلّ من الطير والسمك نصيباً ورزقاً يختصّ به ـ لكن الشاعر العربي استعمل لفظ العين في معان أربعة، والشاعر الفارسي استعمل مجموع الجملة في معان مختلفة.
2. بحار الأنوار: ج89، ص91، ح37.
3. المصدر السابق: ص94، ح47.
4. بحارالانوار: ج 89، ص97، ح64.
5. نفس المصدر: ص83: ح15 (ملخّصاً).
6. ووجه التأمّل أنّ هذا غير معقول، لأنّه كيف يمكن ويتصوّر أن يصير شيء واحد في آن واحد جزءً لعلّتين تامّتين؟
 الاكثر قراءة في المباحث اللفظية
الاكثر قراءة في المباحث اللفظية
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية











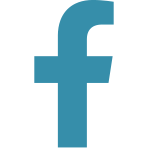
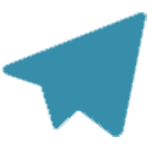
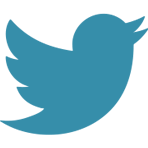

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)