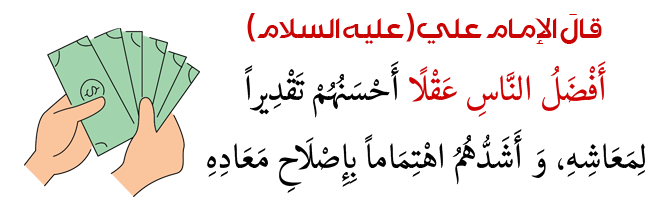
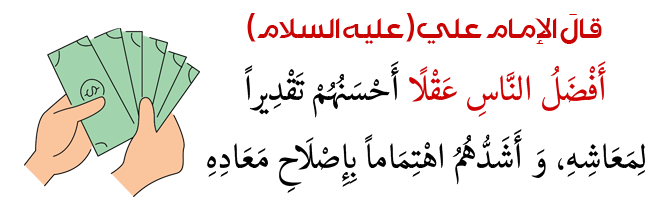

 المسائل الفقهية
المسائل الفقهية
 الطهارة
الطهارة
 احكام الاموات
احكام الاموات 
 التيمم (مسائل فقهية)
التيمم (مسائل فقهية)
 الجنابة
الجنابة 
 الطهارة من الخبث
الطهارة من الخبث 
 الوضوء
الوضوء
 الصلاة
الصلاة
 مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
 افعال الصلاة (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
 الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
 الصوم
الصوم 
 الاعتكاف
الاعتكاف
 الحج والعمرة
الحج والعمرة
 الجهاد
الجهاد
 الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
 الخمس
الخمس 
 الزكاة
الزكاة 
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة 
 ماتكون فيه الزكاة
ماتكون فيه الزكاة 
 علم اصول الفقه
علم اصول الفقه
 الاصول العملية
الاصول العملية 
 المصطلحات الاصولية
المصطلحات الاصولية 
 القواعد الفقهية
القواعد الفقهية
 المصطلحات الفقهية
المصطلحات الفقهية
 الفقه المقارن
الفقه المقارن
 كتاب الطهارة
كتاب الطهارة 
 احكام الاموات
احكام الاموات
 احكام التخلي
احكام التخلي
 الاعيان النجسة
الاعيان النجسة
 الوضوء
الوضوء
 المطهرات
المطهرات
 الحيض و الاستحاظة و النفاس
الحيض و الاستحاظة و النفاس
 كتاب الصلاة
كتاب الصلاة 
 افعال الصلاة
افعال الصلاة
 الصلوات الواجبة والمندوبة
الصلوات الواجبة والمندوبة
 كتاب الزكاة
كتاب الزكاة 
 ماتجب فيه الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
 زكاة الفطرة
زكاة الفطرة
 كتاب الصوم
كتاب الصوم 
 كتاب الحج والعمرة
كتاب الحج والعمرة
 اعمال منى ومناسكها
اعمال منى ومناسكها |
أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-9-2016
التاريخ: 5-9-2016
التاريخ: 2-10-2019
التاريخ: 5-9-2016
|
الحقّ إمكان العلم بالإجماع ، بل وقوعه (1) وثبوته في الجملة (2) ؛ فإنّا نعلم قطعا اتّفاق الامّة على بعض الأحكام ، كوجوب الصلاة ومثلها ، واتّفاق الإماميّة على بعضها كحلّيّة المتعتين وشبهها (3) ، واتّفاق الحنفيّة على انعقاد البيع الفاسد (4) ، والشافعيّة على عدمه (5).
وما ذلك إلاّ لحصوله وثبوته عنهم.
وحصول هذا العلم إمّا بالتسامع وتطابق الأخبار عليه ، سواء كان الطريق متواترا أو آحادا. أو تتبّع أقوال خواصّ الامّة أو المذهب ، وربّما حصل من مشاهدة أعيان المجمعين وسماع أقوالهم إن اكتفي بالقول ، ومع القرائن الدالّة على مطابقة آرائهم لأقوالهم إن اشترط الرأي (6) ، وهذا يمكن في أزمنة أصحاب الحجج فقط ، ولا يتناول غيرها.
ثمّ كلّ إجماع ليس ممّا يعلم ثبوته ، بل له مراتب مختلفة ؛ لأنّه إمّا قطعي أو ظنّي.
والأوّل إمّا بديهيّ للخواصّ والعوامّ من الامّة أو المذهب ، أو لخواصّ أحدهما ، كالاتّفاق على مسح الرّجلين (7) ؛ فإنّ ثبوته بديهيّ عند خواصّ الإماميّة (8) وإن لم يكن كذلك عند عوامّهم.
أو نظريّ ، وهو أن يحصل للمجتهد العلم به (9) بعد بذل جهده واستفراغ وسعه : إمّا بأن لا يظفر على مخالف وادّعاه عدد التواتر أيضا ، وله اتّصال بالبديهيّ.
والقول بأنّه لا يثبت بالتواتر إلاّ ما كان محسوسا ، والإجماع تطابق آراء المجتهدين وهو غير محسوس (10) ، ضعيف ؛ لأنّ المتواتر قول كلّ واحد منهم ، وهو محسوس ودالّ على الرأي، فالقطع بأقوالهم يستلزم القطع بآرائهم ؛ ومنع الاستلزام ـ لاحتمال وجود مانع كتقيّة ونحوها ـ مشترك الورود بينه وبين الخبر ، مع أنّ الأصل (11) عدمه.
وإمّا بأن لا يظفر على مخالف وادّعاه أيضا جماعة لم يبلغوا عدد التواتر ، وكانوا من أهل التدقيق والفحص الشديد.
وإمّا بمجرّد أن لا يظفر بالمخالف وإن لم يضمّ إليه الادّعاء. فإنّ الحقّ ـ كما يأتي (12) ـ أنّ حصول العلم حينئذ ممكن له إذا بالغ في الفحص وبذل الجهد ولم يعثر على مخالف ، وحصل له بعض القرائن والأحوال أيضا. وليسمّ هذا بالإجماع الاستنباطي ، أو التتبّعي.
والثاني إمّا أن يحصل به الظنّ القويّ ، بأن لا يعثر على مخالف بعد فحص لم يبلغ حدّا يفيد العلم ، سواء نقله أيضا جماعة لم يبلغوا حدّ التواتر ولم يكونوا من أهل الدقّة والفحص ، أم لا. ويختلف درجات هذا الظنّ في الموارد باختلاف القرائن والخصوصيّات.
وإمّا أن يحصل به الظنّ المتوسّط أو الضعيف. وموارد كلّ منهما ظاهرة.
وكلّ واحد من هذه الإجماعات إذا لم يكن له معارض من الأدلّة الأخر ، يتعيّن العمل به للمجتهد، كما يأتي (13) ؛ لأنّ الظنّ الحاصل منه ليس أضعف من الظنّ الحاصل من أخبار الآحاد. وإن ضمّت إليه أدلّة أخر صار وجوب العمل به أوضح.
نعم ، العمل في بعض موارد الأخير (14) إذا لم يضمّ إليه دلالة اخرى محلّ تأمّل. وما يصحّ أن يوجد له معارض إذا وجد له ، ينبغي الترجيح على ما يقتضيه نظر المجتهد. هذا إذا لم يوجد لكلّ منها مخالف (15).
وأمّا إذا وجد مخالف ، فربّما حصل القطع بعدم وجود مخالف سوى مخالف نادر ، كالقطع بأنّه لم يخالف في حرمة القياس سوى ابن الجنيد (16) ، وفي استحباب دعاء رؤية هلال رمضان سوى ابن أبي عقيل (17). وحينئذ لا يضرّ هذا المخالف ، ولا يخرجه عن الحجّيّة ، كما يأتي (18).
وربّما حصل الظنّ القويّ أو الضعيف بعدم مخالف غيره.
و(19) ربّما لا يحصل به ظنّ أصلا ، كما إذا ادّعى بعضهم الإجماع على حكم مع ظهور مخالف غير نادر ، بل قد يكون الشهرة على خلافه.
وربّما ادّعى هذا البعض أو بعض آخر الإجماع على خلافه ، كما اتّفق ذلك في كثير من المسائل ، وقد ضبطنا كثيرا من الإجماعات المتناقضة (20) في بعض رسائلنا (21).
ثمّ لكلّ من هذه الأقسام أيضا إمّا أن يوجد معارض أو لا.
وعلى التقديرين إمّا أن يكون له معاضد أو لا. وعلى جميع الأقسام والتقادير يلزم الترجيح والعمل بحسب ما يقتضيه نظر المجتهد.
ثمّ الإجماع المنقول إمّا يفيد القطع أو الظنّ بعدم مخالف بحيث يتعيّن العمل بمضمونه ـ كما تقدّم (22) ـ فحكمه ظاهر. وإن لم يكن كذلك فيجيء حكمه (23).
وبما ذكرنا ظهر أنّه لا بدّ للمجتهد من التتبّع والتفحّص في كلّ إجماع ليعلم أنّه من أيّ قسم ، ثمّ يحكم بما يقتضيه ، وليس له أن يقلّد غيره من المدّعين للإجماع ، بل لا بدّ له من التتبّع ؛ لأنّ الظاهر أنّ كلّ من يدّعي إجماعا على حكم حصل له العلم ، أو الظنّ به من تتبّع الأقوال والقرائن. ومثل هذا ربّما أفاد لبعض علما ولآخر ظنّا ، وربّما لم يفد لآخر شيئا.
هذا ، والحقّ أنّ العلم بالإجماع بكلّ من النقل والتتبّع وكليهما ممكن في الجملة في كلّ عصر ؛ لأنّ فتاوى أعيان القدماء والمتأخّرين محفوظة في الكتب المصنّفة ، فإذا ظهر في حكم من الأحكام المهمّة اتّفاقهم ولم نظفر بالتتبّع التامّ على مخالف له ، علم أنّه مذهب كلّ الإماميّة ؛ إذ العادة لم تجر بأنّ ما لا يكون كذلك لم يقع فيه خلاف ، مع مخالفة أذهانهم ومباينة سلقهم.
واحتمال أن يكون مخالف من المتقدّمين لم يصل خلافه إلى المتتبّع ؛ لخروج قوله عن الكتب المصنّفة ، ينافي اهتمامهم في تتبّع الأقوال وضبطها حتّى الأقوال الشاذّة في المسائل النادرة.
فيتمكّن المجتهد بتتبّع أقوالهم ـ وإن كان بوجدان بعضها في كتب غير قائله ـ أن يظفر باتّفاقهم على حكم وإن لم يعثر على نقل إجماع منهم.
ومن الأصحاب من قصر إمكان الاطّلاع عليه بكلّ من النقل والتتبّع على العصر المقارب لظهور الأئمّة ؛ نظرا إلى إمكان حصول العلم حينئذ بأقوالهم بالتتبّع ؛ لقلّتهم ووجود فتاويهم فيه؛ لأنّ كتب أصحاب الأئمّة كانت حينئذ موجودة ، وخصّص أمثال زماننا بإمكان الاطّلاع عليه من جهة النقل فقط ؛ لعدم إمكان حصول العلم بأقوالهم حينئذ بالتتبّع ؛ لكثرتهم وانتشار أقوالهم ، وعدم وجود مصنّف من كلّ منهم ، واضمحلال كتب أصحاب الأئمّة ، ولم يضبط أصحاب التصانيف أقوال جميعهم في كلّ حكم ، وإلاّ صارت بحيث لا تعدّ كثرة ، فلا يمكن الاطّلاع على جميعها بالتتبّع ولو باستعانة نقل الخلف عن السلف ؛ لأنّ غاية ما يمكن حينئذ الاطّلاع على مذاهب أرباب التصنيف ومعظمهم من المتأخّرين ، ويبقى مذاهب القدماء وأصحاب الأئمّة في حيّز الجهل.
فكلّ إجماع يدّعى من زمان انتشار الأقوال ، كزمان المفيد وما قاربه إلى زماننا هذا ، إمّا أن يكون مستندا إلى نقل متواتر أو آحاد ، أي يكون حدوث ادّعائه من الزمان السابق عليه ، أو لا ، أي يكون حدوث ادّعائه من عصر المفيد وما تأخّر عنه. والثاني ليس حجّة ؛ لما ذكر (24) ، والأوّل حجّة ؛ لاستناده إلى ادّعاء العصر السابق ؛ فإنّ نقلهم حجّة ؛ لتمكّنهم من الاطّلاع على الاتّفاق ؛ لقلّة المجمعين ووجود فتاويهم. فإذا اطّلع بعض من في عصر المعصوم ـ مثلا ـ بالتتبّع على اتّفاق الأصحاب على حكم ، فنقله يكون حجّة لمن تعقّبهم ، ونقلهم ـ إذا اطّلعوا عليه أيضا بالتتبّع ، أو من نقل من تقدّم ـ حجّة لمن بعدهم ، وهلمّ جرّا إلى زمان انتشار الأقوال ؛ فإنّ نقل أهله حينئذ حجّة لمن تعقّبهم إذا كان مستندا إلى نقل السابقين. وإذا كان مستندا إلى تتبّعهم ، لم يكن حجّة لمن بعدهم ؛ لعدم تمكّنهم من العلم بأقوال السابقين ، بل المعاصرين أيضا ؛ لكثرتهم وانتشار أقوالهم (25).
وفيه : ما عرفت من أنّ أرباب التصانيف بذلوا جهدهم في ضبط الأقوال ، ونقل كلّ متأخّر قول من تقدّمه ، فلم يخرج قول من ضبطهم ، فيتمكّن أهل كلّ عصر عن العلم بها ، وأصحاب الأئمّة لم يكن من عادتهم أن يصنّفوا كتبا يذكرون فيها فتاويهم ، بل دأبهم أنّ كلّ ما يسمعونه من المعصوم يسندونه إليه ، ولا يقتصرون على مجرّد الفتوى ، كما لا يخفى على المتتبّع لأقوالهم. وأكثر ما أسندوه نقله حفّاظ الأخبار ، كالمحمّدين الثلاثة ، فإن أمكن استنباط مذاهبهم من كتبهم يمكن استنباطها من كتب نقلة الحديث ، مع أنّهم ـ لشدّة اهتمامهم في ضبط الأقاويل ـ نقلوا ما اشتهر من فتاويهم ، ولذا نقل فتاوى جعفر والحسن ابني سماعة ، وعليّ بن أسباط ، وعليّ بن الحسين ، وابن حذيفة في باب الخلع من التهذيب (26) ، وفتاوى الحسين بن سماعة ، وعليّ بن إبراهيم بن هاشم ، ومعاوية بن حكيم وغيرهم في باب عدّة النساء منه (27) ، وفتوى جميل بن درّاج في باب المرتدّ والمرتدّة منه (28) ، وفتاوى فضل بن شاذان (29) ، ويونس بن عبد الرحمن في كتاب الميراث من الفقيه (30). وقس عليها غيرها ممّا تطّلع عليه بعد التتبّع. وقد أكثر عنهم النقل في الكافي (31).
ولو سلّم أنّه لم يقع التصريح بخصوص قول كلّ واحد من السابقين ، نقول ـ كما قال بعض أهل التحقيق (32) : إنّ أقوالهم لا تخرج عن أقوال اللاحقين ؛ لأنّ نقلة الأخبار وحفظة الآثار ـ على كثرتهم وانتشارهم في أقطار الأرض ـ لطول مساعيهم وتوفّر دواعيهم ، أخذوا العلم والرواية عن أصحاب الأئمّة ، ولحقهم آخرون وأخذوا عنهم ، وكذلك تعقّب الخلف السلف ، والآتي الماضي ، وهلمّ جرّا إلى زمن المشايخ المتأخّرين الذين دوّنوا الفقه ، وضبطوا الأقوال ، وميّزوا بين الخلاف والوفاق ، فلا يكون قول من أقوال المتقدّمين خارجا من قولهم وإن لم يقع التصريح به بخصوصه ، فالأقوال في كلّ حكم منحصرة بالأقوال المضبوطة في الكتب الموجودة عندنا الآن ، فإذا تفحّصنا فيها ووجدنا اتّفاق ما فيها من الأقوال على حكم ، علمنا اتّفاق جميع الأصحاب عليه وعدم مخالف له.
ومع قطع النظر عن ذلك كلّه نقول : هنا مقدّمة مسلّمة عند المحقّقين من أهل الكلام والاصول والميزان تسمّى بالقطعيّات العاديّة (33) يستعملونها في المطالب العظيمة يثبت بها مطلوبنا ، وهي أنّه قد يمكن بنحو من التتبّع حصول الاطّلاع على اتّفاق جميع خواصّ طائفة على حكم وهو أن يتتبّع أحد أقوال بعض مشاهيرهم ، فوجدها متطابقة على حكم ، ولم يجد منهم مخالفا ، وانضمّ إليه بعض القرائن الدالّة على الاتّفاق ، فإنّه يجد من نفسه حينئذ العلم به وإن لم يحط بأقوال الكلّ خبرا ؛ لأنّ العادة تحكم بأنّه لو كان فيه مخالف ، لظهر منه أثر فيما بينهم ، فلو وجدنا بالتتبّع تطابق أقوال جماعة من مشاهير القدماء والمتأخّرين على حكم ، فيمكن أن يحصل لنا العلم بالاتّفاق عليه بالمقدّمة المذكورة وإن لم يتتبّع أقوال جميعهم.
ثمّ إنّه ليس المراد أنّه يمكن لكلّ مجتهد تحصيل العلم بالتتبّع بالوفاق في جميع الأحكام الوفاقيّة ؛ فإنّه محال عادة ، بل المراد إمكان ذلك في الجملة.
هذا، مع أنّه لمّا كان العبرة عندنا في ثبوت الإجماع بدخول قول المعصوم ، فكلّ اتّفاق حصل منه العلم به يكون حجّة وإن لم يكن اتّفاق الكلّ ، بل وإن علم مخالفة البعض ، كما يأتي (34).
ولا يخفى أنّه على اعتبار النقل في زمان انتشر فيه الأقوال ، يلزم عدم العلم بشيء من الإجماعات.
بيان ذلك : أنّه لا ريب في انتشار الأقوال في عصر المفيد وما قاربه ، وفي أنّ ابتداء حدوث نقل الإجماع إنّما كان فيه ؛ لعدم نقل الإجماع على حكم ممّن تقدّمه إلاّ ممّن شذّ فيما شذّ ، وفي هذا العصر وبعده لا يمكن العلم بالإجماع ، لا بالتتبّع على ما هو الفرض ، ولا بالنقل ؛ لعدم ثبوته ممّن تقدّمهم ، مع أنّه إن وصل نقل إجماع ممّن تقدّمهم إلى طبقة منهم ، لا يمكن أن يفيد العلم أو الظنّ لهم وإن كان متواترا ؛ لأنّه يتوقّف على تتبّع أقوال المعاصرين ومن تقدّمهم من طبقاتهم ، وهو غير ممكن.
هذا ، واحتجّ من أنكر إمكان العلم به مطلقا (35) بأنّه يتوقّف على المشافهة ، أو التواتر (36) ، وهما متعذّران ؛ لانتشارهم شرقا وغربا ، مع احتمال خفاء بعضهم عمدا لئلاّ يتّفق أو يخالف ، أو كذبه في قوله : رأيي كذا ، أو رجوعه قبل قول الآخر به ، أو كونه في مطمورة (37) لا يعرف له أثر إمّا لخموله ، أو أسره ، أو طول غيبته (38).
والجواب : أنّه تشكيك في مقابلة الضرورة ؛ فإنّ اتّفاق كلّ أمّة على ضروريّات دينهم ، واجتماع كلّ فرقة على بديهيّات مذهبهم ممّا يعرفه خواصّهم وعوامّهم بالضرورة ، ولا ريب في أنّه لم يحصل (39) من تفحّص أعيانهم وسماع أقوالهم منهم مشافهة ، بل حصوله من التسامع وتواتر الأخبار عليه كما سبق (40).
وكما يجوز ذلك في الضروريّات للخواصّ والعوامّ ، يجوز في القطعيّات النظريّة للخواصّ فقط، وأيّ استبعاد في حصول القطع في بعض الموارد للخواصّ ، أو بعضهم فقط بعد تجويز حصوله في بعضها لهم وللعوامّ أيضا؟. ولو صحّ المنع في الثاني ، لصحّ في الأوّل أيضا من دون فرق ، مع أنّ منكره كافر. ثمّ طريق حصول العلم للعوامّ منحصر بما ذكر ، وللخواصّ به وبالتتبّع ، كما تقدّم (41).
والإيراد عليه بأنّ العلم بالإجماع على الضروريّات والقطعيّات النظريّة ـ كتقديم القاطع على المظنون ـ وإن كان ممكن الحصول ؛ لأنّ حصوله ليس من جهة النقل والفحص ، بل من طريق العقل ؛ لأنّ حقيقة الحكم لمّا كانت ظاهرة للعقل يحكم بعدم مخالفة أحد من العقلاء ، والإجماع فيها لا يفيد شيئا ؛ لظهور الحكم عند العقل مع قطع النظر عنه ، ولذا يحكم به على ثبوت الإجماع دون العكس ، فهي لا تنتهض نقضا على الدليل المذكور ، ومحلّ البحث ما ليس للعقل سبيل إليه ، كأكثر المطالب الفقهيّة التي يستدلّ عليها بالإجماع ويحصل العلم بها منه ، ولا يمكن الاطّلاع على الإجماع عليها ؛ لما ذكر في الدليل (42).
فساده ظاهر (43) ؛ لأنّ أكثر الضروريّات ، كوجوب الصلاة والصوم وغيرهما لا سبيل للعقل إليها ، فلا يحكم بثبوتها فضلا عن الحكم بثبوت الإجماع عليها. وفيما له إليه سبيل لا يمكن له أيضا الحكم بالإجماع عليه ؛ لأنّ أكثر القطعيّات النظريّة التي يجزم بها العقل ممّا وقع فيه الخلاف ؛ فإنّ أجلى القطعيّات عندهم ثبوت الصور الذهنيّة ، وعدم جواز الترجيح بلا مرجّح ، وتخلّف (44) المعلول عن العلّة التامّة ، مع أنّه خالف في كلّ منها جماعة كثيرة (45).
والعلم بالإجماع لا يتوقّف على تفحّص أشخاص المجمعين وسماع أقوالهم منهم مشافهة حتّى يرد ما ذكر في دليل الخصم ، بل الطريق إليه أحد الوجوه التي أشرنا إليها ، وهي تجري في القطعيّات (46) وغيرها.
___________
(1) عطف على « إمكان » والضمير راجع إلى العلم دون الإجماع.
(2) معناه إيجاب جزئي من حيث المعلوم والعالم.
(3) راجع : المعتبر 2 : 785 ، والمهذّب البارع 3 : 313.
(4) بداية المجتهد 1 : 193.
(5) المصدر.
(6) أي القسم الثاني من الإجماع المحصّل.
(7) راجع : المعتبر 1 : 148 ، وتمهيد القواعد : 55 ، المسألة 11.
(8) قاله السيّد المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة 2 : 127 ـ 130 ، والمحقّق الحلّي في معارج الاصول : 132 ، والفاضل التوني في الوافية : 153.
(9) أي بالوقوع.
(10) راجع معالم الدين : 175.
(11) والمراد به استصحاب عدم المانع المحتمل.
(12) في ص 352.
(13) في ص 352.
(14) أي الإجماع المظنون بالظنّ المتوسّط أو الضعيف.
(15) أي وإن كان له معارض. توضيحه : أنّ المراد بالمعارض هو الدليل من العقل والكتاب والسنّة ، والمراد بالمخالف هو قول أو إجماع آخر مخالف لهذا الإجماع ، فيمكن الجمع بين عدم المخالف للإجماع ووجود المعارض له كما هو ظاهر عبارة المصنّف.
(16) حكاه عنه الفاضل التوني في الوافية : 236 ، والوحيد البهبهاني في الرسائل الاصوليّة : 267 و 268.
(17) حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة 3 : 366 ، المسألة 94.
(18) في ص 352.
(19) هذا من أقسام قوله : « والثاني » والضمير في « به » راجع إلى الإجماع لا المخالف.
(20) والمراد به هو المتخالفة وليس معناه الاصطلاحي ؛ فإنّ الإجماعين من المدّعيين ليسا متناقضين.
(21) لم نعثر على رسالته.
(22) في ص 350.
(23) في ص 365.
(24) أي لانتشار الأقوال وعدم الحصول على جميع الأقوال.
(25) أشار إليه الشيخ حسن في معالم الدين : 175.
(26) تهذيب الأحكام 8 : 97 ، ذيل الحديث 328.
(27) المصدر : 124 ، ذيل الحديث 431.
(28) المصدر 10 : 137 ، ذيل الحديث 544.
(29) الفقيه 4 : 259 ، ذيل الحديث 5603 ، و 286 ، ذيل الحديث 5650.
(30) لم نعثر على فتاوى يونس بن عبد الرحمن في الفقيه ولكن روى أحاديث عن الأئمّة (عليهم السلام) وهي في الحقيقة فتاواه كما في الفقيه 4 : 230 ، ح 5544 و 280 ، ح 5625.
(31) الكافي 6 : 92 ـ 96 ، باب الفرق بين من طلّق على غير السنّة وبين المطلّقة إذا خرجت وهي في عدّتها أو أخرجها زوجها.
(32) راجع معالم الدين : 175.
(33) راجع : العدّة في أصول الفقه 1 : 13 ، والقواعد الجليّة : 394 ، وشرح المواقف 1 : 62.
(34) في ص 357.
(35) أي سواء كان المعلوم إجماعا محصّلا أو منقولا.
(36) التواتر في المنقول والمشافهة في المحصّل.
(37) المطمورة : حفرة يطمر فيها الطعام أي يخبأ. الصحاح 2 : 726 ، « ط م ر ».
(38) حكاه الفخر الرازي في المحصول 4 : 22 ، والآمدي عن أحمد بن حنبل في الإحكام في أصول الأحكام 1 : 256.
(39) أي العلم بالاتّفاق.
(40) تقدّم في ص 349.
(41) تقدّم آنفا.
(42) راجع شرح مختصر المنتهى 1 : 24 و 25.
(43) جواب للإيراد.
(44) عطف على « الترجيح ».
(45) راجع : المعتمد 2 : 315 ، وتهذيب الوصول : 254 ، ونهاية السؤل 4 : 446.
(46) في « ب » : « العقليّات ».



|
|
|
|
أمراض منتصف العمر.. "أعراض خطيرة" سببها نقص المغنيسيوم
|
|
|
|
|
|
|
لماذا تتناقص أعداد النحل عالميا؟
|
|
|
|
|
|
|
ممثل المرجعية العليا: العتبة الحسينية تخطط لإنشاء مراكز متخصصة للكشف المبكر عن (سرطان الثدي) بعموم العراق
|
|
|