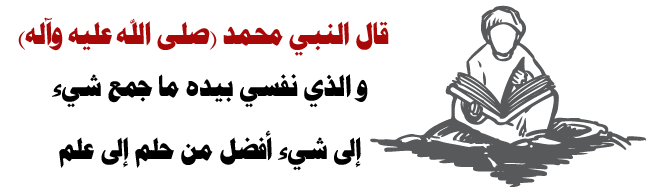
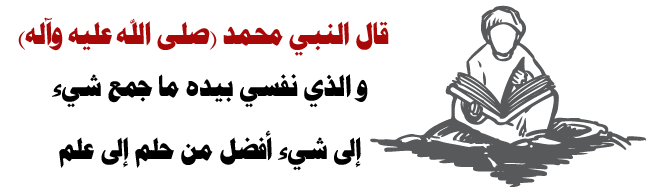
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-06-2015
التاريخ: 28-12-2015
التاريخ: 10-04-2015
التاريخ: 12-08-2015
|
هو عبد اللّه بن الشّمر بن نمير القرطبيّ، كان أبوه الشّمر من موالي بني أميّة و من أهل العلم بالعربية.
نشأ عبد اللّه بن الشّمر جامعا لكثير من الخصال التي تحبّبه إلى الناس: لطيف المعاشرة جامعا لفنون من العلم و الأدب. و قد صحب عبد الرحمن بن الحكم قبل أن يلي عبد الرحمن الإمارة (سنة 206-٨٢٢ م) ثمّ بعد أن تولّى الإمارة. و قد كان في كلّ هذه الحقبة نديما لعبد الرحمن و منجّما له و شاعره (راجع نفح الطيب 3:613) .
و لمّا غزا عبد الرحمن بن الحكم أرض جيليقية (1) ، سنة 225(840 م) ، كان عبد اللّه بن الشّمر معه. ثمّ توفّي ابن الشّمر بعيد ذلك.
كان عبد اللّه بن الشّمر متفنّنا في عدد من العلوم بارعا في التنجيم خاصّة جيّد الشّعر مطبوعا. و فنون شعره، فيما يبدو، المديح و العتاب و الوصف و الهجاء.
مختارات من شعره:
- خرج عبد الرحمن بن الحكم مرّة لصيد الغرانيق (و الغرنوق طائر مائي يشبه الكركيّ) ، و كان البرد شديدا، فقال ابن الشّمر، و كان معه:
ليت شعري أ من حديد خلقنا... أم نحتنا من صخرة صمّاء
كلّ عام في الصيف نحن غزاة... و الغرانيق صيدنا في الشتاء
إذ ترى الأرض-و الجليد عليها... واقع- مثل شقّة بيضاء
و كأنّ الأنوف تُجدع منّا... بالمواسي لزعزع و رخاء (2)
نطلب الموت و الهلاك بإلحا... ح، كأنّا نشتاق وقت الفناء
- جرى ذات يوم حديث طويل بين عبد الرحمن بن محمّد و وزيره في الموازنة بين جارية و عقد من الجوهر (اللؤلؤ) كانت تلبسه، فطلب عبد الرحمن من ابن الشّمر أن يقول شيئا في هذا المعنى فقال:
أتقرن حصباء اليواقيت و الشذرِ... إلى من تعالى عن سنا الشّمس و البدرِ (3)
إلى من برت قدما يد اللّه خلقه... و لم يك شيئا غيره أبدا يبري (4)
فأكرم به من صبغة اللّه جوهرا... تضاءل عنه جوهر البر و البحر (5)
____________________
1) جيليقية: الطرف الشمالي الغربي من شبه جزيرة الأندلس.
2) تجدع: تقطع. المواسي: جمع موسى: سكّين حادّة. الزعزع: الريح الشديدة. الرخاء: الريح الليّنة. -إذا اشتدّ البرد و تجمّدت الأعضاء (كالأذن و الأنف) يسهل انفصالها.
3) قرن: جمع، (شبّه، وازن بين شيئين) . الحصباء: الحصا، الحجارة الصغيرة. الشذرة: القطعة الصغيرة من الذهب، الخرزة الصغيرة يفصل بها بين الحبّتين من اللؤلؤ في العقد. السنا: ضوء البرق.
4) برت-برأت: خلقت. و لم يكن غيره (أي اللّه) يبري (يبرأ) شيئا.
5) الجوهر: اللؤلؤ.
 |
|
| دلَّت كلمة (نقد) في المعجمات العربية على تمييز الدراهم وإخراج الزائف منها ، ولذلك شبه العرب الناقد بالصيرفي ؛ فكما يستطيع الصيرفي أن يميّز الدرهم الصحيح من الزائف كذلك يستطيع الناقد أن يميز النص الجيد من الرديء. وكان قدامة بن جعفر قد عرف النقد بأنه : ( علم تخليص جيد الشعر من رديئه ) . والنقد عند العرب صناعة وعلم لابد للناقد من التمكن من أدواته ؛ ولعل أول من أشار الى ذلك ابن سلَّام الجمحي عندما قال : (وللشعر صناعة يعرف أهل العلم بها كسائر أصناف العلم والصناعات ). وقد أوضح هذا المفهوم ابن رشيق القيرواني عندما قال : ( وقد يميّز الشعر من لا يقوله كالبزّاز يميز من الثياب ما لا ينسجه والصيرفي من الدنانير مالم يسبكه ولا ضَرَبه ) . |
 |
|
| جاء في معجمات العربية دلالات عدة لكلمة ( عروُض ) .منها الطريق في عرض الجبل ، والناقة التي لم تروَّض ، وحاجز في الخيمة يعترض بين منزل الرجال ومنزل النساء، وقد وردت معان غير ما ذكرت في لغة هذه الكلمة ومشتقاتها . وإن أقرب التفسيرات لمصطلح (العروض) ما اعتمد قول الخليل نفسه : ( والعرُوض عروض الشعر لأن الشعر يعرض عليه ويجمع أعاريض وهو فواصل الأنصاف والعروض تؤنث والتذكير جائز ) . وقد وضع الخليل بن أحمد الفراهيدي للبيت الشعري خمسة عشر بحراً هي : (الطويل ، والبسيط ، والكامل ، والمديد ، والمضارع ، والمجتث ، والهزج ، والرجز ، والرمل ، والوافر ، والمقتضب ، والمنسرح ، والسريع ، والخفيف ، والمتقارب) . وتدارك الأخفش فيما بعد بحر (المتدارك) لتتم بذلك ستة عشر بحراً . |
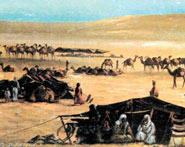 |
|
| الحديث في السيّر والتراجم يتناول جانباً من الأدب العربي عامراً بالحياة، نابضاً بالقوة، وإن هذا اللون من الدراسة يصل أدبنا بتاريخ الحضارة العربية، وتيارات الفكر العربية والنفسية العربية، لأنه صورة للتجربة الصادقة الحية التي أخذنا نتلمس مظاهرها المختلفة في أدبنا عامة، وإننا من خلال تناول سيّر وتراجم الأدباء والشعراء والكتّاب نحاول أن ننفذ إلى جانب من تلك التجربة الحية، ونضع مفهوماً أوسع لمهمة الأدب؛ ذلك لأن الأشخاص الذين يصلوننا بأنفسهم وتجاربهم هم الذين ينيرون أمامنا الماضي والمستقبل. |
|
|
|
|
هل يمكن للدماغ البشري التنبؤ بالمستقبل أثناء النوم؟
|
|
|
|
|
|
|
علماء: طول الأيام على الأرض يزداد بسبب النواة الداخلية
|
|
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يشرك طلبة الدورات الصيفية بمحفلٍ قرآني في محافظة بابل
|
|
|