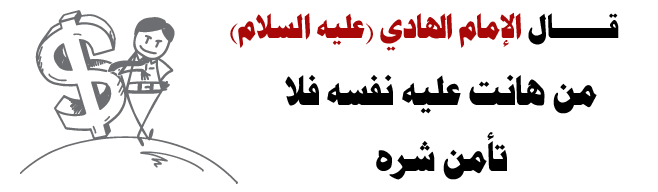
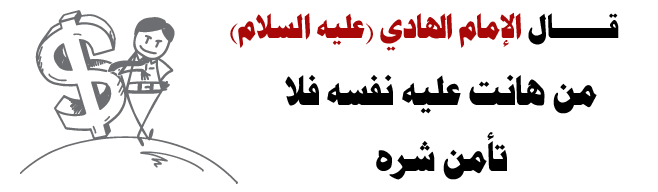
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-06-2015
التاريخ: 29-06-2015
التاريخ: 28-2-2018
التاريخ: 2-3-2018
|
أبو الحسن الضرير وكان أبوه أيضا ضريرا من أهل الأندلس هكذا قال الحميدي علي بن أحمد وفي كتاب ابن بشكوال ((علي بن إسماعيل)) وفي كتاب القاضي صاعد الجياني ((علي بن محمد)) في نسخة وفي نسخة علي بن إسماعيل فاعتمدنا على ما ذكره الحميدي لأن كتابه أشهر. مات ابن سيدة بالأندلس سنة ثمان وخمسين وأربعمائة عن ستين سنة أو نحوها.
قال القاضي الجياني: كان مع إتقانه لعلم الأدب
والعربية متوفرا على علوم الحكمة وألف فيها تأليفات كثيرة ولم يكن في زمنه أعلم
منه بالنحو واللغة والأشعار وأيام العرب وما يتعلق بعلومها. وكان حافظا وله في
اللغة مصنفات منها كتاب المحكم والمحيط الأعظم رتبه على حروف المعجم اثنا عشر مجلدا
وكتاب المخصص مرتب على الأبواب كغريب المصنف وكتاب شرح إصلاح المنطق وكتاب الأنيق
في شرح الحماسة عشرة أسفار وكتاب العالم في اللغة على الأجناس في غاية الإيعاب نحو مائة سفر بدأ بالفلك وختم بالذرة
وكتاب العالم والمتعلم على المسألة والجواب وكتاب الوافي في علم أحكام القوافي
وكتاب شاذ اللغة في خمس مجلدات وكتاب العويص في شرح إصلاح المنطق وكتاب شرح كتاب
الأخفش وغير ذلك.
قال الحميدي وابن بشكوال: روى ابن سيدة عن أبيه
وعن صاعد بن الحسن البغدادي. قال أبو عمر الطلمنكي: دخلت مرسية فتشبث بي أهلها
ليسمعوا عني غريب المصنف فقلت لهم انظروا من يقرأ لكم وأمسك كتابي فأتوني برجل
أعمى يعرف بابن سيدة فقرأه علي من أوله إلى آخره من حفظه فعجبت منه.
وقال الحميدي: كان ابن سيدة منقطعا إلى الأمير
أبي الجيش مجاهد بن عبد الله العامري ثم حدثت له نبوة بعد وفاته في أيام إقبال
الدولة ابن الموفق فهرب منه ثم قال يستعطفه: [الطويل]
(ألا هل إلى تقبيل راحتك اليمنى ... سبيل فإن
الأمن في ذاك واليمنا)
(ضحيت فهل في برد ظلك نومة ... لذي كبد حرى وذي
مقلة وسنا)
(ونضو زمان طلَّحته ظباته ... فلا غاربا أبقين
منه ولا متنا)
(غريب
نأى أهلوه عنه وشفّه ... هواهم فأمسى لا يقر ولا يهنا)
(فيا ملك الأملاك إني محلأ ... عن الورد لا عنه
أذاد ولا أدنى)
(تحيفني دهري فأقبلت شاكيا ... أما دون شكواي
لغيرك من يعنا)
(فإن تتأكد في دمي لك نية ... بصدق فإني لا أحب
له حقنا)
(إذا ما غدا من حر سيفك باردا ... فقدما غدا من
برد نعمائكم سخنا)
(وهل هي إلا ساعة ثم بعدها ... ستقرع ما عمرت من
ندم سنا)
(وما لي من دهري حياة ألذها ... فتعتدها نعمى
علي وتمتنا)
(إذا ميتة أرضتك منا فهاتها ... حبيب إلينا ما رضيت
به عنا)
وهي طويلة وقع عنه الرضا مع وصولها إليه فرجع.
 |
|
| دلَّت كلمة (نقد) في المعجمات العربية على تمييز الدراهم وإخراج الزائف منها ، ولذلك شبه العرب الناقد بالصيرفي ؛ فكما يستطيع الصيرفي أن يميّز الدرهم الصحيح من الزائف كذلك يستطيع الناقد أن يميز النص الجيد من الرديء. وكان قدامة بن جعفر قد عرف النقد بأنه : ( علم تخليص جيد الشعر من رديئه ) . والنقد عند العرب صناعة وعلم لابد للناقد من التمكن من أدواته ؛ ولعل أول من أشار الى ذلك ابن سلَّام الجمحي عندما قال : (وللشعر صناعة يعرف أهل العلم بها كسائر أصناف العلم والصناعات ). وقد أوضح هذا المفهوم ابن رشيق القيرواني عندما قال : ( وقد يميّز الشعر من لا يقوله كالبزّاز يميز من الثياب ما لا ينسجه والصيرفي من الدنانير مالم يسبكه ولا ضَرَبه ) . |
 |
|
| جاء في معجمات العربية دلالات عدة لكلمة ( عروُض ) .منها الطريق في عرض الجبل ، والناقة التي لم تروَّض ، وحاجز في الخيمة يعترض بين منزل الرجال ومنزل النساء، وقد وردت معان غير ما ذكرت في لغة هذه الكلمة ومشتقاتها . وإن أقرب التفسيرات لمصطلح (العروض) ما اعتمد قول الخليل نفسه : ( والعرُوض عروض الشعر لأن الشعر يعرض عليه ويجمع أعاريض وهو فواصل الأنصاف والعروض تؤنث والتذكير جائز ) . وقد وضع الخليل بن أحمد الفراهيدي للبيت الشعري خمسة عشر بحراً هي : (الطويل ، والبسيط ، والكامل ، والمديد ، والمضارع ، والمجتث ، والهزج ، والرجز ، والرمل ، والوافر ، والمقتضب ، والمنسرح ، والسريع ، والخفيف ، والمتقارب) . وتدارك الأخفش فيما بعد بحر (المتدارك) لتتم بذلك ستة عشر بحراً . |
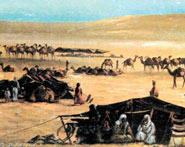 |
|
| الحديث في السيّر والتراجم يتناول جانباً من الأدب العربي عامراً بالحياة، نابضاً بالقوة، وإن هذا اللون من الدراسة يصل أدبنا بتاريخ الحضارة العربية، وتيارات الفكر العربية والنفسية العربية، لأنه صورة للتجربة الصادقة الحية التي أخذنا نتلمس مظاهرها المختلفة في أدبنا عامة، وإننا من خلال تناول سيّر وتراجم الأدباء والشعراء والكتّاب نحاول أن ننفذ إلى جانب من تلك التجربة الحية، ونضع مفهوماً أوسع لمهمة الأدب؛ ذلك لأن الأشخاص الذين يصلوننا بأنفسهم وتجاربهم هم الذين ينيرون أمامنا الماضي والمستقبل. |
|
|
|
|
مقاومة الأنسولين.. أعراض خفية ومضاعفات خطيرة
|
|
|
|
|
|
|
أمل جديد في علاج ألزهايمر.. اكتشاف إنزيم جديد يساهم في التدهور المعرفي ؟
|
|
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تنظّم دورةً حول آليّات الذكاء الاصطناعي لملاكاتها
|
|
|