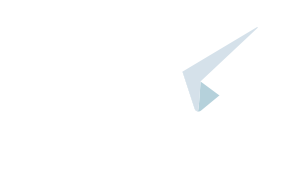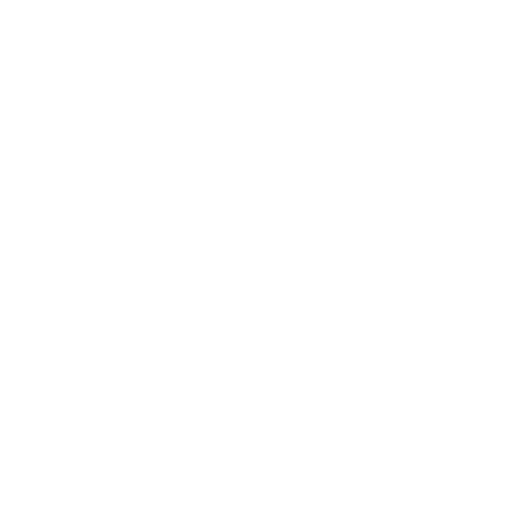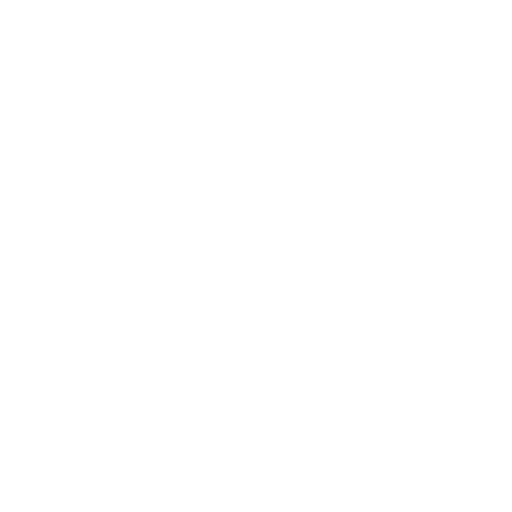تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم


علوم القرآن

أسباب النزول


التفسير والمفسرون


التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل


مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج


التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين


القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة


تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن


الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة


قصص قرآنية


قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله


سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة


حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية


العقائد في القرآن


أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية


التفسير الجامع


حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص


حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة


حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر


حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن


حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات


حرف الدال

سورة الدخان


حرف الذال

سورة الذاريات


حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن


حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة


حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ


حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح


حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف


حرف الضاد

سورة الضحى


حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق


حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر


حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية


حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق


حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش


حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون


حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل


حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد


حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس


حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة


حرف الواو

سورة الواقعة


حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس


آيات الأحكام

العبادات

المعاملات
موانع الفهم والحجب الصادّة للقرآن عند الامام الخميني
المؤلف:
جواد علي كسار
المصدر:
فهم القرآن دراسة على ضوء المدرسة السلوكية
الجزء والصفحة:
ص 326- 375 .
5-05-2015
8416
يبدأ الإمام فصله عن الحجب والموانع بعبارات تبعث على توتر النفس وإثارتها، وشدّ العقل وانتباهه ارتقابا لأمر خطير : «نتلوالقرآن الشريف أربعين عاما، وليس ثمّ ثمرة أونفع يحصل من ذلك مطلقا سوى أجر القراءة وثوابها» (1).
بداية تذكّرنا في حدّة إثارتها ببداية الغزالي للموضوع، وهويكتب : «أكثر الناس منعوا عن فهم معاني القرآن لأسباب وحجب» (2) إذ المحصّل بين الاثنين واحد، هواحتجاب الأكثرية عن النفوذ إلى دائرة القرآن.
ما هي أسباب ذلك ؟ وما هوالسبيل إلى تخطّيها ؟ بالقدر الذي يتصل بالبحث يعود السبب إلى ترسّخ موانع الفهم وتراكم الحجب بين الإنسان والقرآن، ومن ثمّ يكمن الحلّ بمعالجة هذه الحجب وإزالتها والتخلّي عن الموانع. والخطوة الأولى في ذلك كله تكمن بوعي المسألة ومعرفة الموانع والحجب. يكتب الإمام منبّها : «واحد آخر من الآداب المهمّة التي ينبغي الالتزام به لكي تتحقّق الاستفادة، هورفع موانع الاستفادة الذي نعبّر نحن عنه بالحجب بين المستفيد والقرآن». ثمّ يردف موضّحا :
«وهذه الحجب كثيرة نشير إلى بعضها» (3) ، ثمّ يبدأ باستعراضها على طريقته الخاصّة.
أبرز ما أشار إليه الإمام من هذه الموانع والحجب، هو:
1- حجاب غياب قصدية التعلّم
في هذه النقطة ينطلق الإمام من مسألة مبدئية أوإطار منهجي لم أعثر له على مثيل في موضوع بحثنا عند الغزالي أوالشيرازي. فما دام الحديث يدور عن فهم القرآن والحجب المانعة عن ذلك، فالإمام يطالب بدءا بتأسيس العلاقة بين المستفيد والقرآن على نحوخاص منتج، حتّى لا يتورّط بالحجب التي تعطّله عن الفهم.
علاقة الإنسان مع القرآن ينبغي أن تتأسّس على آصرة التعلّم بحيث يكون الإنسان قاصدا أن يفهم من القرآن ويتعلّم منه، كما المفروض أن لا يتخلّى الإنسان عن هذه الآصرة في أي مرحلة من مراحل تعاطيه مع كتاب اللّه، ذلك أنّ الإنسان يعيش حالة التعلّم من القرآن أبدا مهما كانت المرحلة التي بلغها.
قصد التعلّم عند الإمام يأتي تاليا لمعرفة الإنسان لمقاصد القرآن وسابقا أوممهّدا لموضوع الحجب والموانع، إذ يكتب منبّها إليه بعد أن يستعرض أبرز المقاصد : «الآن وبعد أن عرفت مقاصد هذه الصحيفة الإلهية ومطالبها، ثمّ مسألة مهمّة ينبغي أن تأخذها بنظر الاعتبار يفضي الالتفات إليها إلى أن ينفتح أمامك طريق الاستفادة من الكتاب الشريف، وتنفرج على قلبك أبواب حكمه ومعارفه؛ وتلك المسألة هي أن تنظر إلى الكتاب الإلهي الشريف بقصد التعلّم، وأن تعدّه كتاب تعليم
وإفادة، وترى نفسك موظّفا بالتعلّم والإفادة منه» (4).
على هذا القصد ينبغي أن تتأسّس علاقة الإنسان المستفيد مع كتاب اللّه لكي تنفتح عليه أبواب معارفه وعطاياه، ومن دون ذلك ستؤصد أمامه الأبواب ومن ثمّ يكون ذلك أول عهده بالحجب والموانع. على خلفية غياب القصد التعليمي يفسّر الإمام ضآلة ما ينتج عن علاقتنا مع القرآن : «والسبب في أنّ استفادتنا من هذا الكتاب العظيم ضئيلة جدا يعود إلى غياب هذا القصد، فنحن لا نتعامل معه بقصد التعليم والتعلّم، بل غالبا ما تقتصر علاقتنا مع القرآن على القراءة وحسب، نقرأ القرآن لغرض نيل الثواب والأجر، لهذا لا نهتمّ إلّا بجهاته التجويديّة، فقصدنا أن نتلوالقرآن صحيحا لينالنا الثواب، نحن نقنع بهذا القدر وتجمد علاقتنا مع القرآن عند هذه التخوم من دون أن نتخطّاها» (5).
طبيعي لا يعني الإمام إهمال تلأوة القرآن الكريم في النسق الذي تمليه قواعد التجويد، فهذه مسألة خارجة عن موضوع البحث. البحث يدور حيال فهم القرآن وموانع ذلك، ومن يروم الفهم عليه أن يؤسّس علاقته مع كتاب اللّه على قصديّة التعلّم، وقصديّة التعلّم لا علاقة لها بالتلأوة وآدابها كغاية، فحيث يكون التعلّم هوالمقصود، فالإنسان يقرأ القرآن ليتجأوز القراءة إلى الفهم، لا أن يمكث عند تخوم التلأوة وينشغل بآداب التجويد. فنحن إذن بإزاء موضوعين لكلّ واحد منهما قصده الذي يؤسّس له، ولوازمه التي تترتب عليه.
لكن هل يعني تأسيس العلاقة مع القرآن على قاعدة قصديّة التعلّم ، الانخراط في العلوم الجزئية والاستغراق بالمقدمات والعكوف عليها ؟ ليس هذا هوالمقصود، لأنّ مثل هذا الانخراط التفصيلي وإن كان يريح الذات ويوحي لها بأوهام الامتلاء والاكتفاء ويوقعها داخل أشراك الغرور والاستغناء، إلّا أنّه لا يعدوهوالآخر أن يكون حجابا مانعا عن الولوج إلى لباب المعاني والاقتراب من مقاصده.
2- الغرور والإحساس الكاذب بامتلاء الذات
يعيش الإنسان غالب الأحيان إحساسا مضخّما بذاته، يفضي به أخلاقيا إلى التعالي والغرور ومعرفيا إلى العزوف عن الفهم والتعلّم واكتفائه بما عنده. هذا الإحساس الوهمي يطغى على المشتغلين بمختلف حقول العلم بما في ذلك العلوم الدينية، وهومن البلاءات التي تصيب العاملين بالفكر والمعرفة والعلم، خاصّة إذا ما أحرز الإنسان تقدّما في أحد الاختصاصات، إذ سيطغى عليه إحساسه بالتفوّق فيكسبه حالة من القناعة بما عنده والرضا عن الذات، ويعيش الاستغناء عن معرفة بقية حقول العلم وربما ازدراءها والاستخفاف بأصحابها.
وحيث يمثّل هذا الشعور الوهمي بالاكتفاء حالة عامّة تشمل المهتمّين بمختلف حقول العلم والمعرفة، فلا معنى أن نستثني منه المشتغلين في حقول الدراسات القرآنية وعامّة اطر المعرفة الدينية، بل ربما فاق الابتلاء به في هذا الوسط ما تعانيه بقية الأوساط العلمية والمعرفية، للملابسات الخاصّة التي يعيشها الجوالديني.
قد تنشأ الذاتية المتضخّمة من خلل أخلاقي وقد تقترن بالممارسة العلمية ذاتها وتكون نتيجة مصاحبة لها، لكنّها على كلا التقديرين تنتهي إلى إلحاق الضرر ببنية المعرفة القرآنية بعد أن تتحوّل إلى مانع أوحجاب. يكتب الإمام : «من الحجب الكبيرة حجاب الذاتية والغرور وتضخّم الذات، حيث يرى الإنسان المتعلّم نفسه بواسطة هذا الحجاب مستغنيا لا يحتاج إلى الاستفادة» (6). وهذه الخصلة هي «من أهمّ كبريات مكايد الشيطان الذي يوحي للإنسان بالكمالات الموهومة على الدوام ويدعه راضيا بما عنده قانعا به، مستخفّا بما وراءه عازفا عن كلّ ما سواه» (7).
ينتقل الإمام بعد ذلك ليتابع تجليات هذه الحالة ومصاديقها، وكيف تبرز على صعيد مختلف علوم القرآن وما يتصل بدائرته الفسيحة من معارف، دون أن تستثني أحدا : «مثلا :
1- يقنع الشيطان أهل التجويد بذلك العلم الجزئي [علم التجويد] ويزيّنه لهم ويسقط بقية العلوم من أعينهم، ويوهمهم بتطبيق عنوان حملة القرآن على أنفسهم [حتّى يظنّوا أنّهم بحظّهم من علم التجويد هم حملة القرآن وحسب] ومن ثمّ يحرمهم من فهم الكتاب الإلهي المنوّر والإفادة منه.
2- كما يرضي أصحاب الاهتمام الأدبي بتلك القشور والشكليات الخالية من اللب، ويوحي لهم أنّ القرآن بتمام شئونه يتمثّل بما عندهم وحسب.
3- ويشغل أهل التفاسير المألوفة بوجوه القراءات والآراء المختلفة لأرباب اللغة، ووقت النزول وشأن النزول، والمدني والمكّي، وعدد الآيات والحروف وأمثال هذه الامور.
4- كما يعمد أيضا إلى إقناع أهل العلوم وإرضائهم بمعرفة فنون الدلالات ووجوه الاحتجاجات وأمثال ذلك» (8).
لوعدنا خطوة إلى الوراء لوجدنا هذا النص يلتقي مع ما ذكره الغزالي في الحجاب الأول من حجب الفهم الأربعة، ولخصه بقوله : «أولها : أن يكون الهمّ منصرفا إلى تحقيق الحروف بإخراجها من مخارجها، وهذا يتولّى حفظه شيطان وكلّ بالقرّاء ليصرفهم عن فهم معاني كلام اللّه عزّ وجلّ، فلا يزال يحملهم على ترديد الحرف يخيّل إليهم أنّه لم يخرج من مخرجه» (9). بيد أنّ الإمام وسّع في مداه وساقه إلى مجالات أرحب، حيث لم يقف بهذا الحجاب على علم التجويد وأهله وحسب، بل امتدّ به حتّى غطّى مجالات الدراسات الأدبية واللغوية، وعلوم القرآن والحجاجات الكلامية، وأي نزعة استغراقية تجرّ الإنسان إليها وتبعده عن مقاصد القرآن حتّى لوانطلقت باسم الفلسفة والعرفان (10).
مع صدر الدين الشيرازي تكتسب تعرية هذا الحجاب ونقده صياغة اخرى تتمثّل بمهاجمة الشيرازي للنزعة الظاهرية، التي يكتفي فيها الإنسان بالمقدّمات والعلوم الجزئية وأوائل المفهومات ويغتر بهذا الحشد عن النفوذ إلى حريم المعاني، فالمطلوب من هذه جميعا أن تكون خوادم لما بعدها، والمقصود من الظاهر أن يكون طريقا إلى الباطن وحقائق القرآن. يكتب : «معظم الآفات الحاجبة للإنسان عن درك حقايق القرآن الاغترار بظواهر الأخبار، والاحتجاب بأوائل الأنظار، من دقائق العلوم الجزئية ومعارف الأحكام الفرعية، وإلّا فما من شيء إلّا وفي القرآن ما يكشف عن حقيقة ذاته» (11). لكن استغراق الإنسان بالقشور والمقدمات والعلوم الجزئية والفته بالمشهور يحرمه من بلوغ اللب، وفاقا لقاعدة : «وبالقشر لا ينال إلّا القشر» (12). في الواقع يتقارب هذا النص الذي يهاجم فيه الشيرازي العكوف على العلوم الجزئية والاستغراق بالمقدمات عن بلوغ المقصد، مع نصّ للإمام الخميني يؤكّد المدلول ذاته مع إيضاحات أكثر : «وإذا ما قصدنا التعلّم فسنبذل عنايتنا بالنقاط البديعية والبيانية، ووجوه إعجازه. وإذا ما تخطّينا ذلك إلى ما هوأرفع منه فلن تتجاوز اهتماماتنا [القرآنية] الجوانب التاريخية، وأسباب نزول الآيات وأوقاتها، ومكّية السور والآيات ومدنيّها، واختلاف القراءات، واختلافات المفسّرين من العامّة والخاصّة، وإلى ما غير ذلك من الامور العرضية الخارجة عن المقصد، التي تستوجب بنفسها الاحتجاب عن القرآن والغفلة عن الذكر الإلهي» (13).
الحقيقة لا يتجه النقد في نطاق هذه الرؤية إلى العلوم التمهيدية والمقدّمات في نفسها، وإنّما هويبتغي التعامل معها في نطاقها الوظيفي كمقدمات أوخوادم وآلات، بحيث لا يصار للإطناب بها فتتحوّل إلى غاية تصدّ عن المقصد وحجاب يمنع عن الفهم وهويورث صاحبه الانتفاخ والغرور، ويدعه يعيش إحساس الاستغناء والرضا عن الذات.
3- النزعات اللغوية المضخّمة
القرآن نصّ عربي، ومن ثمّ فللغة العربية وآدابها وظيفتها التي تنهض بها إزاء هذا النص. هذه حقيقة واضحة لا ريب فيها، يزيدها أهمّية دعوة الإسلام نفسه إلى تعلّم هذه اللغة من زأوية أنّها كلام اللّه : «تعلّموا العربية فإنّها كلام اللّه الذي كلّم به خلقه» (14).
لكن تبقى هناك مسافة كبيرة بين التوفّر على موضع الحاجة من قواعد اللغة وآدابها في فهم معاني القرآن ودرك مراميه، وبين اختزال القرآن إلى نصّ لغوي والتعامل معه على هذا الأساس. في نطاق الفهم الأول تكون اللغة وآدابها محض آلة كالمنطق بالنسبة للتفكير بشكل عام، وكاصول الفقه بالنسبة إلى الفقه وكالرجال بالنسبة للحديث وهكذا. أمّا في نطاق الفهم الثاني فتتحول اللغة وآدابها إلى هدف مطلوب بذاته، بحكم أنّ القرآن نفسه هونص لغوي. كما تكون العربية وعلومها وآدابها في نطاق الفهم الأول محطة عابرة يتجأوزها الإنسان بعد أن يستنفد طاقاتها، في حين ليست هي كذلك مع الفهم الثاني حيث تملأ اللغة جميع اهتمامات الإنسان وتشغل آدابها وعيه ومداركه، وتطغى على جميع أبعاد عنايته بالقرآن وتصبغها بلونها ما دام يعي القرآن نصا لغويا وحسب.
الحقيقة أنّ هذه النظرة التي تتعاطى مع اللغة وآدابها على نحومضخّم يستغرق جل الاهتمامات، موجودة عند القدماء كما عند المحدثين، وربّما هي التي عناها الغزالي وحذّر منها قبل قرابة ألف عام، بقوله : «وقد انتهى الجهل بطائفة إلى أن ظنّوا أنّ القرآن هوالحروف والأصوات» (15).
لكن حتّى من دون هذا التمييز في بنية القرآن وحقيقة الظاهرة القرآنية، فما أكثر من انجرّ من الماضين إلى علوم اللغة وآدابها وأطنب في التصنيف بها وتحرّي
تفصيلاتها، حتّى إذا ما انتهينا إلى المحدثين، نجد أنّ هذه النزعة اكتسبت مع بعض الاتجاهات الحديثة والمعاصرة منحى تنظيريا يسجّل صراحة أنّ : «القرآن نص لغوي» (16) وحسب، وإنّه لا مفهوم لهذا النص خارج طبيعته اللغوية، ذلك : «إنّ البحث عن مفهوم (النص) ليس في حقيقته إلّا بحثا عن ماهية (القرآن) وطبيعته بوصفه نصا لغويا» (17). يسأوق هذا النص بصراحة بين ماهية القرآن وطبيعته وبين بنيته اللغوية، ويجعل أحدهما مسأويا للآخر.
في نطاق رؤية كهذه تؤسّس لنفسها على هذه المبادئ من الطبيعي أن يكون البحث اللغوي بضروبه المختلفة، هوالطريق الوحيد المفضي إلى إدراك القرآن ووعي الحقيقة القرآنية، ويتحوّل إلى ضرورة لا مناص منها، وليس إلى مجرّد مرحلة ومحطّة أوفي الأقل خيار من بين عدة خيارات كلها مؤدية ومشروعة. نقرأ في نص دال يعبّر عن هذه الرؤية بجرأة وصراحة : «إنّ اختيار منهج التحليل اللغوي في فهم النص والوصول إلى مفهوم عنه ليس اختيارا عشوائيا نابعا من التردّد بين مناهج عديدة متاحة، بل الأحرى القول إنّه المنهج الوحيد الممكن من حيث تلاؤمه مع موضوع الدرس ومادته» (18)، ومن ثمّ فإنّ «الدراسة الأدبية ومحورها مفهوم (النص) بحقيقته اللغوية هي الكفيلة بتحقيق وعي علمي» (19) بالقرآن دون بقية
المناهج والدراسات.
المدرسة الوجودية أوالسلوكية ومن تأثّر بها هي أشدّ من واجه هذه النزعة وحذّر منها في الماضي كما في الحاضر، كما سنلمس ذلك عمّا قليل في نصوص الإمام الخميني من المعاصرين، وصدر الدين الشيرازي من الأقدمين مع إشارات دالّة للغزالي الذي رام الانفتاح على هذه المدرسة خاصّة أواخر سني عمره، فكان له بعض نصيب من معارفها منحه قدرة فائقة على التنظير في المعرفة القرآنية وفي جوانب اخر من المعارف الدينية.
يجمع رموز هذه المدرسة في موقفهم الرافض لنزعة التوغّل التفصيلي الزائد في اللغة وآدابها، بين منطلقين :
الأول : هومنطلقهم الخاص الذي ينسجم مع مبادئهم في الفهم. فهذا الاتجاه لا يتعامل مع القرآن كنص لغوي وحسب كما مرّ معنا في الفصول السابقة خاصة الخامس، وإنّما له حقيقة ما ورائية، وقد مرّ بتنزّلات كثيرة حتّى صار في صيغته الأخيرة المتمثّلة بحلّة الألفاظ وكسوة الحروف، وما صيغته النصية التي بين أيدينا إلّا التنزّل الأخير للحقيقة القرآنية.
المطلوب من الإنسان الذي يناظر القرآن ويوازيه وجوديا أن لا يمكث عند هذه الألفاظ ويعكف على القشرة الأخيرة، وإنّما يرتقي على خطّ وجودي صاعد إلى مأوراء الحروف والألفاظ، ثمّ يواصل رقيه ليعيش معاني القرآن وحقائقه على قدر سموّه الوجودي والتكاملي. هذا النمط من الفهم يقتضي طبيعيا بحكم بنيته وانسجامه المنطقي الخاص به، عدم تضخيم جانب اللغة وآدابها، ويكتفي منها بالنزر القليل الذي يدع الإنسان يفهم ظاهر النص القرآني الذي هونص لغوي عربي في نهاية المطاف، فهما صحيحا منسجما مع قواعد اللغة، ثمّ يغادر هذه المنطقة إلى ما هوأرقى حيث تبرز لوازم وأدوات اخرى كما مرّ تفصيلا في الفصل الخامس أثناء الحديث عن نظرية مراتب الفهم.
الثاني : أجل، القرآن نص لغوي، هذه حقيقة لا يستراب بها، بيد أنّ ذلك لا يسوّغ العكوف على اللغة، لأنّ للنص اللغوي هذا آفاقا مديدة تشمل الكون والإنسان والحياة، وله معارف تعمّ عالمي الغيب والشهادة، يكفينا في ذلك ما وصف به نفسه : {تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ}[ النحل : 89] وقوله : {وتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ}[ الأعراف : 145] كما قوله : {ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ}[ الأنعام : 38].
ومن السنة : «إنّ العزيز الجبار أنزل عليكم كتابه وهوالصادق البار، فيه خبركم وخبر من قبلكم وخبر من بعدكم، وخبر السماء والأرض» (20). وكذلك : «إنّ اللّه تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كلّ شيء، حتّى واللّه ما ترك شيئا تحتاج إليه العباد» (21).
نص بهذه المثابة له كلمة فصل في مسائل العقيدة من مبدأ ومعاد ورحلة الإنسان ما بينهما ومصيره بعد ذلك، إلى عناية فائقة بالجانب الروحي والحياة المعنوية، إلى بيان الأحكام الفقهية، وطواف في حركة المجتمع والتأريخ ودراسة سنن نهوض الأمم وأفولها، واهتمام متميّز بتربية الإنسان وتفجير مكنوناته واستعداداته الداخلية، إلى إشارات في الطبيعة والعلوم وغير ذلك؛ كيف يمكن أن تستوفيه اللغة وحدها أوأن تكون هي المنهج الأفضل لإدراك معارفه واكتناه معانيه؟ وكيف يصحّ أن تكون اللغة والدراسات الأدبية هي السبيل الوحيد للتعامل مع هذا الطيف الواسع من الموضوعات والمعارف والمعاني؟ إنّ للغة على أيّ حال طاقات محدودة لا تتعدّاها، ولها وظيفة خاصّة تنهض بها، لتترك المجال لما بعدها.
أزيد من ذلك تفيدنا الدراسات الحديثة عن النص، أنّ النص الديني وإن كان نصا لغويا إلى أنّه يمثّل «حالة خاصّة من النص اللغوي» بحيث يتجأوز «من حيث مبناه ومعناه وأثره، حدود اللغة إلى ما بعدها وما فوقها وما وراءها، لما يتضمّنه من معان سامية» (22). وهكذا «يمكن القول إنّ النص جهاز عبر لغوي، يتجأوز اللغة إلى العالم الرحيب خارجها» (23).
على ضوء هذه الخلفية جاء تحذير الإمام من تضخيم النزعة اللغوية وما يصاحبها من اهتمامات تفصيلية تتراكم وتعلو، حتّى تحجب معارف القرآن ومعانيه وتتحوّل إلى غاية مطلوبة بذاتها. لقد مرّت علينا بعض نصوص الإمام التي حذّر فيها من استهلاك الجهود وتضييع العمر بالاستغراق بجهات : «الفصاحة والبلاغة والنكات البيانية والبديعية» (24)، وقد كان المهمّ أنّه أسّس لهذا النقد على ضوء رؤية تفيد أولا بأنّ للقرآن حقيقة خارج هذه الألفاظ هي التي ينبغي للإنسان أن يطلبها، وتتحرّك ثانيا على هدي نظرية المقاصد، فللقرآن مقاصد أساسية ينشدها صاحب الكتاب جلّ جلاله هي التي ينبغي تحرّيها، والاستغراق في اللغة وآدابها ليس فقط لا يشفي غليل النفس في بلوغ مقاصد القرآن، بل هويبعد عنها ويصدّ العقول والنفوس عن تحصيلها خاصة بعد أن تتراكم وتتحوّل إلى سدّ منيع يحول بين الإنسان والقرآن، ذلك لأنّ : «صاحب هذا الكتاب ليس السكاكي والشيخ حتّى يكون مقصده جهات البلاغة والفصاحة، ولا سيبويه والخليل حتّى يكون منظوره جهات النحووالصرف، ولا المسعودي وابن خلّكان حتّى يكون مبتغاه البحث في أطراف تأريخ العالم، كما أنّ هذا الكتاب ليس مثل عصا موسى ويده البيضاء أوروح عيسى التي تحيي الأموات لكي تكون الغاية منه الإعجاز والدلالة على صدق النبي الأكرم وحسب، وإنّما هذه الصحيفة الإلهية هي كتاب إحياء القلوب بالحياة الأبدية العلمية والمعارف الإلهية» (25). ثمّ يعرج إلى تعداد بقية المقاصد كما مرّ الكلام فيها تفصيلا في فصل مقاصد القرآن.
ينقلنا هذا النص على الفور إلى ما كان سجله رمز آخر من رموز المدرسة التي ينتمي إليها الإمام، ويعبّر عن اعتزازه به على الدوام، أعني به صدر الدين الشيرازي الذي تنأول هذا الحجاب وشدّد نكيره على نزعة التراكم اللغوي، وعرّض بمن : «يكون مستغرقا بعلم العربية ودقائق الألفاظ، مصروف العمر في تحقيقها» لأنّ : «المقصود الأصلي من إنزال القرآن ليس إلّا سياقة الخلق إلى جوار اللّه بتكميل ذواتهم وتنوير قلوبهم بنور معرفة اللّه وآياته، دون صرف الأوقات في نحوالكلام وتحسين الألفاظ وعلم البلاغة وفن البديع، فإنّ ذلك من التوابع التي بها يقع الاحتجاج على المنكرين» (26) ، ومن ثمّ فهي مطلوبة بالعرض لا بالذات، وعلى قدر الحاجة إليها دون مبالغة وإطناب.
للمقصد في هذه المدرسة مكانة عظيمة، وهوأصل في طليعة الاصول التأسيسية التي ترجع إليها، والمفسّر في هذه المدرسة هومن «يفهمنا (المقصد) من النزول» (27) لأنّ التفسير عندها هو«شرح المقاصد» (28)، ومقاصد القرآن لا نأخذها من اللغة، بل هذه الأخيرة تعزلنا عنها : «من تدبّر في إعراب ألفاظه [القرآن] ودقائق عربيته ونكاته البديعية، وهوبمعزل عن أسرار حكمته ومقاصده الأصلية من المعارف الإلهية ... إلى غير ذلك من المعارف التي هي الغرض الأصلي من إنزال الكتاب والوحي والإلهام والخطاب ... فهوأحرى بهذا التمثيل» (29) الذي يكون مثله فيه كالحمار يحمل أسفارا.
صحيح أنّ النص مصدر المعرفة، بيد أنّ الصحيح أيضا أنّ الحرفية اللغوية لا تفجّر حيويّة النص وتسفر بالتالي عن مكنوناته وما وراءه من معان وحقائق، بل هي
تكبّل الإنسان وتغلّه عن إدراك المقاصد، شأنها في ذلك شأن بقية المقدّمات والعلوم إذا تجأوزت حدّها وتخطّت وظيفتها كخوادم وآلات : «فمن أراد أن يقف على أنّه لم طوّلت الباء في «بسم اللّه» ومدّت السين؟ أولم حذفت الألف في الخطّ هاهنا وأثبتت في قوله «باسم ربك»؟ أولم أسقطت الألف بعد اللام في «اللّه» أوهل تفخّم لام الجلالة أم لا فليرجع إلى أهل الخطّ والقراءة» (30) ليكون ذلك مبلغه من الكتاب.
كذلك «من أراد أن يعرف بم تعلقت الباء وبأي محذوف ارتبطت، ولم قدّر المحذوف متأخّرا ... أوكيف بنيت الباء على الكسرة ومن حق حروف المعاني التي جاءت على حرف واحد أن تبنى على الفتحة التي هي أخت السكون نحوكاف التشبيه ولام الابتداء ووأوالعطف وفائه وغير ذلك، وإنّ كلمة الجلالة اسم هي أوصفة مشتقّة أم جامدة، فليرجع إلى مطالعة التفاسير المشهورة سيّما «الكشاف» فإنّه كامل في بابه فائق على أترابه» (31).
إذا أردنا أن نستعير من أبي حامد الغزالي تمييزه علوم القرآن إلى ما يندرج تحت علوم القشر والصدف وما يندرج تحت علوم اللباب، فإنّ علوم العربية بجميع طبقاتها تدخل في «علوم الصدف والقشر» (32)، وإنّ ذوي الاهتمامات اللغوية «كلهم يدورون على الصدف والقشر وإن اختلفت طبقاتهم» (33). المهمّ أن لا يطيل الإنسان مكوثه في منطقة الصدف والقشر، بل يتجأوز إلى اللباب، فإذا مكث يكون قد خرج باللغة وآدابها عن مهمّتها كواسطة إلى غيرها ومرحلة ينبغي تجأوزها بعد استنفاد أغراضها وطاقاتها. وهذا هومعنى أن تتحوّل اللغة وآدابها إلى حجاب ومانع يصدّ عن الفهم، ويدفع بالإنسان إلى الخسران وأن يكون مصداقا لقوله (سبحانهـ) : {مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً}[ الجمعة : 5]. فمن «لم يطّلع من القرآن إلّا على تفسير الألفاظ، وتبيين اللغات ، ودقائق العربية والفنون الأدبية وعلم الفصاحة والبيان وعلم بدائع اللسان، وهوعند نفسه إنّه من علم التفسير في شيء، وأنّ القرآن إنّما أنزل لتحصيل هذه المعارف الجزئية، فهوأحرى بهذا التمثيل ممّن لا خبر له أصلا لا من إعراب الألفاظ، ولا من حقائق المعاني مع اعترافه بعجزه وقصوره» (34).
ثمّ أردف مستشهدا بهذين البيتين لأبي سعيد الضرير (35) :
زوامل للأشعار لا علم عندهم بجيّدها إلّا كعلم الأباعر (36)
لعمري ما يدري المطي إذا غدا بأسفاره إذ راح ما في الغرائر (37)
بودّي أن أختم الكلام عن هذه الفقرة بنص دالّ للإمام، يسجّل فيه : «هل ترانا إذا ما أنفقنا عمرنا في التجويد والجهات اللغوية والبيانية والبديعية، نكون قد حرّرنا هذا الكتاب الشريف من المهجورية؟ وهل ترانا إذا تعلّمنا ضروب القراءات وأمثال ذلك، نكون قد تخلّصنا من عار هجر القرآن؟ وهل إذا تعلّمنا وجوه إعجاز القرآن
وفنونه ومحسّناته، نكون قد نجونا من شكوى رسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم؟ هيهات، إذ لا يعدّ أيّ واحد من هذه الامور مورد عناية القرآن ومنزّله العظيم جلّ شأنه» (38). ثمّ ينعطف النص لبيان أنّ القرآن هوكتاب يتوفّر على الشئون الإلهية، وهوحبل اللّه المتّصل بين الخالق والمخلوق، والمهمّ فيه أن تتأسّس علاقة الإنسان معه على اسس معنوية وغيبية تهدف إلى تحصيل العلوم الإلهية والمعارف الدينية، والتربّي في ظل علومه ودعواته وحكمه ومواعظه، لينتهي بعد ذلك كله إلى القول محذّرا : «وإلّا فإنّ الغور في صورة ظاهر القرآن [عبر اللغة وما سبق أن أشار إليه] هوإخلاد إلى الأرض أيضا، وهومن وسأوس الشيطان التي ينبغي الاستعانة باللّه منها» (39).
4- النعرة العلمية الاصطلاحية
يأتي الحديث عن النعرة العلمية والاصطلاحية كحجاب في امتداد النقطة السابقة، ذلك أنّ نزعة التضخّم في المقدّمات والعلوم الجزئية لا تقتصر على اللغة وحدها بل تمتدّ لتشمل جميع العلوم وكلّ المعارف. كلّ عملية توغّل في العلوم التي تتّصل بالقرآن تزيد عن حدّها تبعد صاحبها عن المقصد، تماما كالإنسان الذي يحفر في الأرض، فهويبتعد عن النور ويموج في غياهب الظلمات كلّما ازداد توغلا في العمق وابتعد عن السطح.
النقد في هذا الاتجاه الذي يرتفع صاحبه على ركام من الاصطلاحات لا يوفّر علما من العلوم ولا اتجاها من الاتجاهات، بل يشمل كلّ ما من شأنه أن يتحوّل إلى موانع وحجب وسدود متراكمة تحول دون الاستبصار بالقرآن، ويهاجم النزعة الشكلانية بتمظهراتها كافة، مهما كان أداتها ومجالها الذي تتحرّك فيه.
يعبّر الإمام عن هذا النقد بقوله : «ويقنع [الشيطان] أهل العلوم بمعرفة فنون الدلالات ووجوه الاحتجاجات وأمثال ذلك فقط». ثمّ ينعطف مباشرة ليسجّل أنّ هذه النزعة تعمّ حتّى تستوعب الفلاسفة والعرفاء حين تحاصر عقولهم بالاصطلاحات، بحيث لا يعودون يرون القرآن ولا يفقهونه إلّا من خلال هذا الكمّ المتراكم من المصطلحات التي تفرزها صناعتهم وعلومهم، هذا إذا توفّرت لهم الفرصة للإطلالة على القرآن، إذ أنّ هذه العلوم تستغرق أصحابها في الأغلب وتستهلك أوقاتهم وجهودهم وأعمارهم؛ إنّها تشغلهم بالنظر إلى الطريق والمكث فيه عن الوصول إلى المقصد والغاية. يضيف سماحته مستأنفا : «حتّى أنّه [الشيطان] يحبس الفيلسوف والحكيم والعارف بالمصطلح المألوف في حجاب الاصطلاحات والمفاهيم الغليظة وأمثال ذلك» (40).
هذا ما كان كتبه الإمام عن النعرة العلمية وحجاب الاصطلاحات والنزعة الشكلانية في العلوم، عند ما درس المسألة في كتاب «آداب الصلاة» عام 1361 هـ. بيد أنّه عاد إلى الفكرة ذاتها بعد قرابة الأربعين عاما وبحث في أطرافها على نحوأوفى خلال دروسه التفسيرية التي دأب على إلقائها أسبوعيا أوائل عام 1400 هـ بعد عودته المظفّرة إلى مدينة قم غداة انتصار الثورة. في الدرس الثاني من تلك الدروس ركّز على هذا الحجاب بكثافة، عند ما راح يقول : «من الحجب الكبيرة هذا العلم نفسه، فهويشغل الإنسان ويلهيه بهذه المفاهيم العقلية الكلية، ومن ثمّ يصدّه عن الطريق». يضيف : «كلّما ازداد العلم صار الحجاب أكثر غلاظة» (41).
على أنّ المسألة تأخذ أبعادا أكثر تعقيدا من خلال الإحساس الكاذب الذي يسأور الإنسان كلّما توغّل في علم من العلوم أكثر، إذ يعيش من خلال تضلّعه بذلك العلم واختصاصه بصناعته وإحاطته بمصطلحاته حالة من الامتلاء الوهمي من جهة والاستخفاف ببقية العلوم والاختصاصات من جهة اخرى، بل لا يعدّها علوما أساسا، فما عنده هوالعلم (بألف ولام التعريف) وما عند الآخرين لا شيء :
«يحسب الإنسان مع أيّ علم يحصل عليه ويكون قد أدركه ودرسه، أنّ الكمالات بأجمعها منحصرة بذلك العلم. يخيّل للفقيه أنّه لا شيء في العالم غير الفقه، ويخيّل للعارف أنّه لا شيء غير العرفان، ويخيّل للفيلسوف أنّه لا شيء غير الفلسفة، كما يخيّل للمهندس أنّه لا شيء في هذا العالم غير الهندسة» (42).
على أنّ هناك وجوها اخر لهذا الحجاب تبرز هذه المرّة بالتصوّر الآحادي لمفهوم العلم الناشئ من ألفة الإنسان لمصدر واحد في المعرفة ووحشته أوعدم معرفته ببقية المصادر، ممّا يقوده إلى الإنكار كنتيجة للتصوّر الاختزالي : «أوإنّه [الإنسان] يقصر العلم على المشاهدة والتجربة وأمثال ذلك، فهذا هوالعلم وما سواه لا يعدّه علما؛ هذا حجاب كبير للجميع. الحجب كثيرة بيد أنّ أغلظها جميعا هوحجاب العلم هذا» (43).
تصدر هذه الرؤية من تعليل يسير لوظيفة العلم بالنسبة لموضوعنا الذي نحن فيه متمثّلا بفهم القرآن، مفرط بوضوحه. فوظيفة العلم ببساطة هوأن يكون وسيلة ومقدّمة لبلوغ المقصد لا فرق بين العلوم العقلية والنقلية : «فالعلوم الشرعية والعلوم العقلية؛ هذه [العلوم] التي يطلق عليها هؤلاء المساكين اسم الذهنيات، هذه التي يطلق عليها هؤلاء المحجوبون (الذهنيات) وهي ذهنيات حقا، بمعنى أنّه لا عينية لها؛ ما هي إلّا وسيلة لبلوغ المقصد» (44). وفي نص آخر قصير ودال نقرأ لسماحته :
«جميع العلوم وسيلة» (45). والمشكلة تبرز عند ما تنقلب هذه العلوم إلى ضدّها، فبدلا من أن توصل الإنسان إلى المقصد تصدّه عنه، وبدلا من أن تكون وسيلة ومقدّمة تتحوّل إلى هدف وغاية.
أجل، هذه هي المشكلة، وبقدر ما يتعلّق الأمر بدائرة الدراسات الإسلامية فإنّ هذا المحذور لا يوفّر أي علم من العلوم المتدأولة في هذا المجال : «فالعلوم الرسمية (36) جميعها على هذا النحو، إذ هي تحجب الإنسان عمّا ينبغي أن يصير إليه، إنّها تورث الغرور» (47).
العلم يتحوّل إلى حجاب عند ما يصدّ عن المعرفة ويمنع من الهداية، ومن ثمّ يسدّ الطريق بوجه الإنسان : «بمعنى أنّ ما ينبغي العثور عليه من خلال ذلك الطريق [العلم] يتحوّل بنفسه إلى مانع؛ فالعلم الذي ينبغي له هداية الإنسان ينقلب إلى مانع عن الهداية» (48).
والعلّة لا تكمن بالعلم بل بالإنسان الذي يفتقر إلى التهذيب والأخلاقية التي تحصّنه من السقوط في هوّة التعالي والغرور والإحساس بالامتلاء والاكتفاء :
«ينبغي أن لا يجرّ الاشتغال بالعلم إلى أن يكون سببا لغفلتنا عن اللّه، وينبغي أن لا يصير الاشتغال بالعلم سببا لنشوء حالة من الغرور ينجم عنها صدّنا عن مبدأ الكمال. هذا الغرور الموجود في الملالي [إشارة إلى طلبة العلوم الدينية والحوزات العلمية] سواء أولئك الذين يتوفّرون على العلوم المادية والطبيعية أوأولئك الذين يتوفّرون على العلوم الشرعية والعقلية» (49).
لا يعرف هذا الداء اختصاصا بعلوم دون اخرى، بل هوكالنار تسري في الهشيم يشمل الجميع. فهولا يختصّ بعلوم القشور دون علوم اللباب بحسب تصنيف الغزالي، ولا بعلوم اللغة دون العلوم الشرعية، بل ولا بعلم التفسير والأكثر من ذلك علم التوحيد الذي يكتسب في دائرة تصنيف العلوم الإسلامية قيميا وصف أشرف العلوم.
فحتّى أشرف العلوم يمكن أن يتحوّل إلى حجاب إذا قعد بالإنسان عن بلوغ المقصد، انسجاما مع القاعدة التي تفيد : «أنّ العلم الذي هومقدّمة لبلوغ المقصود يتحوّل إلى رادع يصدّ الإنسان عن المقصد» (50). وما يتحوّل إلى رادع عن المقصد لا يعدّ علما بل هوحجاب، يستوي في ذلك : «العلم الشرعي، وعلم التفسير وعلم التوحيد، فعلم التوحيد يتحوّل إلى مانع حين يسلك طريقه إلى قلب غير مهيّأ وغير مهذّب؛ علم التوحيد هذا يتحوّل [في مثل هذه القلوب] إلى غلّ وقيد، وكذا بالنسبة
إلى العلوم الشرعية. فهذه جميعا وسائل، والمسائل الشرعية هي وسيلة وحسب، هي وسائل للعمل، والعمل وسيلة أيضا. جميعها وسيلة لمقصد واحد هوأن تتيقّظ هذه النفس» (51).
على ضوء هذا الفهم يكتسب النص الصدرائي التالي كامل مدلولاته، ونحن نقرأ فيه : «ربّ رجل أديب أريب، له اطلاع تام على علم اللغة والفصاحة، والاقتدار على صنعة البحث والمجادلة مع الخصام في علم الكلام، وهومع براعته في فصاحته لم يسمع حرفا من حروف القرآن بما هوقرآن، ولا فهم كلمة واحدة.
وكذلك أكثر المشتغلين بالبحث البحت المغترّين بلامع سراب الحكمة، المحرومين من شراب المعرفة في كأس القرآن المبين ... لعدم حواسهم الباطنية التي هذه الحواس الدنيأوية قشور لها، وبالقشر لا ينال إلّا القشر، وأمّا اللباب فلا يناله إلّا أولوالألباب» (52).
كما يتضح أيضا مدلول اتفاق الجميع على مقولة : «إنّ العلم حجاب» التي ينقلها الغزالي عن الصوفية، ثمّ يعقّب عليها بقوله : «وأرادوا بالعلم العقائد التي استمرّ عليها أكثر الناس بمجرّد التقليد، أوبمجرّد كلمات جدلية حرّرها المتعصّبون للمذاهب وألقوها إليهم. فأمّا العلم الحقيقي الذي هوالكشف والمشاهدة بنور البصيرة فكيف يكون حجابا وهومنتهى الطلب؟» (53). وبعد الغزالي بخمسة قرون جاء صدر الدين الشيرازي ليتبنّى الموقف ذاته وبعبارة الغزالي نفسها في كتابه عن مقدمات التفسير (54).
أمّا في عصرنا الحاضر فقد سجل الإمام الخميني نصا : «العلم هوالحجاب الأكبر» (55)، وذلك في نطاق الرؤية التي مررنا على عناصرها فيما سبق. مهما اختلفت التفسيرات فإنّ المحصّلة تكاد تكون واحدة، فسواء تخلّف العلم عن أداء دوره كوسيلة ومقدّمة لأسباب تعود إلى بنية المعرفة ذاتها وكحصيلة للممارسة العلمية نفسها، أوكان ذلك بسبب يرجع إلى بنية الإنسان وتكوينه التربوي والأخلاقي فإنّ النتيجة واحدة ما دمنا في مرحلة وصف المشكلة، وإن كان الأمر يختلف في مرحلة المعالجة والتجأوز.
لا يخفى أنّ الإمام يميل إلى تفسير المشكلة على أساس أخلاقي لا صلة له بطبيعة العلم أوبالممارسة العلمية نفسها، فالمتلقّي أوالفاعل الإنساني هوالمسئول ولا جريرة للعلم في ذلك، بسبب ضعفه الأخلاقي والروحي : «عند ما يرد العلم إلى قلب غير مهذّب يفضي إلى تراجع الإنسان. فكلّما تراكم العلم أكثر كانت المصيبة به أكبر. فعند ما تكون الأرض مالحة وسبخة فهي لا تثمر مهما بذر بها من بذور» (56).
هنا يكون العلم حجابا، بل هوالحجاب الأكبر.
5- قناع المذهبيات الفكرية والتعصبات الباطلة
بعد نقد النزعات المتضخّمة في اللغة وغيرها، والتحذير الشديد من الاتجاه الجدلي- الاصطلاحي المتلبّس بالعلم، وبعد نقد حجاب العلم نفسه، تصل نظرية الحجب أوموانع الفهم إلى مفصل أساسي آخر عانى منه الفكر الإسلامي على طول مساره ولا يزال، بما في ذلك الفكر القرآني باتجاهاته المتنوّعة وأطيافه المختلفة.
لأسباب يعرفها الجميع صاغ كلّ فريق من الفرقاء الأساسيّين في تاريخ المسلمين الفرقي علم الكلام الخاص به، ومن ثمّ أسّس لرؤية معرفية مستقلّة في فهم الإسلام وبخاصّة القرآن، بحيث تحوّل القرآن إلى ساحة فسيحة لمنظومات فكرية وكلامية ومعرفية مختلفة. على أنّ المسألة لم تقف عند هذه التخوم، بل اضيف إليها أيضا خطوط التقاطع والصراع بين المرجعيات المعرفية الثلاث المتمثّلة بالفقهاء والفلاسفة والعرفاء، ليتّسع ميدان النص القرآني على هذه الإسقاطات الفكرية والمنهجية التي تجيء إليه من الاختلاف والصراع الفرقي من جهة وتعدّد المرجعيات المعرفية وصراعها من جهة اخرى، ليتحوّل إلى مضمار لا يتخلّف عنه اتجاه ولا فرقة ولا مذهب ولا مرجعية من كلّ ما حفل به تأريخ المسلمين ولا يزال. وبتعبير دالّ للشيرازي بعد إشارات مسهبة لإسقاطات المذاهب على التفسير، بل على علم القرآن عامّة : «الغرض من هذا الكلام أنّ علم القرآن مختلف، فالأذواق فيه متفأوتة حسب اختلاف أهل الإسلام في المذاهب والأديان، وكلّ حزب بما لديهم فرحون» (57).
على أنّ انعكاس الاختلاف على النص القرآني يأتي في غالب الأحيان مركّبا، تجتمع فيه حصائل الصراع بين فريق وآخر ومرجعية معرفية ومرجعية اخرى كما هوالحال مثلا في الخلاف الأشعري- المعتزلي، أوالشيعي- الأشعري، أوما بين الفلاسفة- المتكلّمين وما إلى ذلك، مضافا إليه حصائل الصراع الناشئة داخل الاتجاه الفرقي الواحد أوالمرجعية المعرفية الواحدة. ففي المنظومة الشيعية مثلا هناك أنساق معرفية تتوزّع هذا الفريق إلى فلاسفة وعرفاء وفقهاء، والاصطكاك الكائن بين هذه الأنساق يعكس نتائجه على النص القرآني، مضافا إلى الممارسة الإدراكية الذهنية وما ينجم عن العمل النظري نفسه من تبعات تأخذ موقعها في ثقافة الفكر القرآني.
هذا الخليط المتراكم المتكوّن من سليم وسقيم، وصحيح وخاطئ وحق وباطل يعلوأمام الإنسان ويتحوّل إلى بناء شاهق يحجب القرآن ويمنع من رؤيته على غضاضته الأولى. ثمّ تتعقّد المشكلة وتكتسب أبعادا مضاعفة حينما يضاف إلى هذا الخليط من الأفكار والأنظار والاطر، التعصّبات التي تتخندق حول الأفكار والأنظار والرجال، وتتحوّل إلى قناع كثيف يغذّيه الجهل والتقليد والاتباع الأعمى فيزيد من سمكه وصلابته، خاصّة وإنّه : «ليس من الطوائف المنتسبة إلى العلم والأدب شرّ على العلماء المحقّين، ولا أضر على الأنبياء الهادين، ولا أشد عدأوة للمؤمنين بالحقيقة، ولا أفسد للعقول من كلام هؤلاء المجادلة وخصوماتهم وتعصّباتهم في الآراء والمذاهب» (58).
في نص تنظيري مبكّر لبعض جوانب هذا المشهد، نقرأ في وصفه : «ثانيهما [ثاني الحجب] : أن يكون مقلدا لمذهب سمعه بالتقليد وجمد عليه وثبت في نفسه التعصّب له، بمجرّد الاتباع للمسموع من غير وصول إليه ببصيرة ومشاهدة. فهذا شخص قيّده معتقده عن أن يتجأوزه، فلا يمكنه أن يخطر بباله غير معتقده فصار نظره موقوفا على مسموعه». ليس هذا وحده وحسب، فالتقليد والاتباع وغياب الاستقلال بالنظر والإبداع فيه، لا يتوقّف عند حدود الجمود على الموروث، بل يولّد أيضا حساسية ضدّ التجديد والإبداع. فإذا كان جوهر عملية الإبداع هي مجأوزة المألوف أوإعادة النظر به، فإنّ الحساسية النفسية التي يورثها الجمود على الموروث الآتي من تقليد المذاهب والرجال، تتحوّل إلى حجاب يمنع من مسايرة لمعات الذهن وخطرات العقل وما تفرزه حركة الفكر، ليقعد بالإنسان عند موروثه :
«فإن لمع برق على بعد وبدا له معنى من المعاني التي تباين مسموعه، حمل عليه شيطان التقليد حملة وقال : كيف يخطر هذا ببالك وهوخلاف معتقد آبائك؟ فيرى أنّ ذلك غرور من الشيطان فيتباعد منه ويحترز عن مثله». على حين لوسمح الإنسان بتفاعل لمعات الذهن وتوارد المعاني على عقله، لا نجرّ ذلك إلّا كشوفات جديدة يتوالد منها معنى «ثان وثالث ولتواصل، ولكن يتسارع إلى دفع ذلك عن خاطره لمناقضته تقليده الباطل» (59).
أكثر من ذلك أنّ للحق مراتب ودرجات، وله مناهج متعدّدة ومنطلقات متنوّعة. لكن المبدأ في ذلك كله هوالظاهر، أوأوائل المفهومات، فقد يكون ما عند الإنسان رأيا سليما ونظرا صحيحا يمثّل الحقّ، إلّا أنّه يتطابق مع المرتبة الأولى فيه، ولا يجوز لهذه المرتبة أن تدفع ما سواها من المراتب أوالدرجات، وإلّا لتعطّلت عملية نموالمعرفة، وماتت المعارف. نقرأ في تتمة النص أعلاه : «وقد يكون [ما عند الإنسان] حقا ويكون أيضا مانعا من الفهم والكشف» كيف؟ لأنّ : «الحقّ الذي كلف الخلق اعتقاده له مراتب ودرجات، وله مبدأ ظاهر وغور باطن، وجمود الطبع على الظاهر يمنع من الوصول إلى الغور الباطن» (60).
على أنّ التنزيه وعدم التشكيك بالنوايا لا يبقى موقفا مطلقا لا يقبل الاستثناء، فهناك «المفسدون» عن قصد وسبق إصرار، وأكثر هؤلاء «من مجادلة أهل الكلام والمتعصّبة لمذاهب أخذوها تلقّفا وتقليدا من غير بصيرة» (61). من خصائص هؤلاء أنّهم : «يجادلون أهل الدين والورع بالشبهات، وينبذون كتب اللّه وراء ظهورهم، ويفرغون إلى الآراء والمذاهب بعقولهم السخيفة وآرائهم الفاسدة، ويضعون لمذاهبهم قياسات متناقضة واحتجاجات مغالطية مموهة، فيضلّون العقول السليمة عن سنن الحقّ ومسلك الدين» (62).
مشكلة هذا الصنف ليست في البيان ولا حتّى في القدرة الذهنية المحضة، ولكن في الجهل الناشئ عن عدم صبّ الفعالية العقلية في إطارها الصحيح : «وإنّك لتجد من فيهم جودة عبارة وفصاحة بيان وسحر كلام، ما يقدر أن يصوّر الباطل في صورة الحقّ بالوصف البليغ ويصوّر الحقّ في صورة الباطل، وهومع ذلك جاهل القلب ميّت النفس عن إدراك حقائق الأشياء، بعيد الذهن عن فهم المعارف العقلية» (63).
أمّا الإمام الخميني، فهويرجع هذا الحجاب ويردّه إلى عاملين إدراكي يتمثّل بضعف الاستعداد العقلي، والثاني ذاتي- ثقافي ناشئ عن الاتباع والتقليد، وعنده أنّ الثاني أغلب في تفسير الظاهرة من الأول : «من الحجب الاخرى، حجاب الآراء الفاسدة والمسالك والمذاهب الباطلة. وهذا الحجاب ينشأ تارة من سوء استعداد الإنسان نفسه، وفي الأغلب من التبعية والتقليد». يضيف : «إنّ هذا من الحجب التي حجبتنا بالأخصّ عن معارف القرآن. مثلا إذا رسخ اعتقاد ما في قلوبنا لمحض الاستماع من الوالدين أوكنتيجة للأخذ من بعض جهلة أهل المنبر، فإنّ هذه العقيدة لا تلبث أن تتحوّل إلى حاجب ما بيننا وبين الآيات الإلهية الشريفة. وبعد ذلك لوجاءت الوف الآيات والروايات مناهضة لتلك العقيدة، ترانا إمّا إنّنا نصرف تلك الآيات والروايات عن ظاهرها أولا ننظر إليها بعين الفهم. الأمثلة عن هذه الحالة كثيرة في مجال العقائد والمعارف، بيد أنّني أعرف عن عدّها، لأنّني أعرف أنّ هذا الحجاب لا يخرق بكلام مثلي» (64).
الهدف الذي تتوخّاه المدرسة بإثارة الكلام عن هذا الحجاب، هومواجهة الشكلانية والسطحية في التعامل مع النص القرآني وشنّ معركة لا هوادة فيها على الاتباع والتقليد والجمود على الموروث، والتسليم إلى المرجعيات المذهبية والأطر المنهجية والكلامية والفكرية المتوارثة، بغية تثوير النص وتفجير مكنوناته والتوغّل إلى طبقات المعاني الغائرة وراء الظاهر، انسجاما مع مقاصد القرآن كما تفهمها هذه المدرسة، ولكي يكون القرآن هوباب معرفة اللّه.
هذه المعاني والأهداف تحضر بوضوح مشهود في المثال الذي يضربه الإمام لهذا الحجاب. فبرغم أنّه يقرّر العزوف عن ذكر الأمثلة كما مرّ معنا آنفا، إلّا أنّه سرعان ما يستدرك قائلا : «بيد أنّني سأكتفي بالإشارة إلى مثال منها من حقل العقائد والمعارف بحكم أنّه سهل المأخذ. يلحظ أنّه وبرغم هذا الكمّ من الآيات الراجعة إلى لقاء اللّه ومعرفة اللّه، ومع هذا العدد من الروايات حيال الموضوع مضافا اليهما هذا الكمّ من الإشارات والكنايات والصراحات التي تنطوي عليها أدعية الأئمة عليهم السّلام ومناجاتهم، يلحظ أنّهم صاروا إمّا إلى تأويل كلّ تلك الآيات والروايات وما هوموجود بالأدعية والمناجاة وتوجيهه [بدفعه عن مقصده] أوأنّهم لا يردون هذا المضمار أساسا ولا يتعرفون على المعارف التي هي قرّة عين الأنبياء والأولياء. كلّ ذلك قد حصل لمجرد فشوهذه العقيدة التي أشاعها العامّيون في هذا المجال والمبتدءون، التي تفيد أنّ طريق معرفة اللّه مغلق بالمطلق، وذلك بعد ما قاسوا باب معرفة اللّه ومشاهدة الجمال بذلك الوجه الممنوع، بل الممتنع المتمثّل بباب التفكّر في ذات اللّه». يضيف : «إنّه ممّا يبعث على الأسف الكبير لأهل اللّه، أنّ بابا من المعرفة يمكن القول فيه إنّه يمثّل غاية بعثة الأنبياء ومنتهى مطلوب الأولياء، قد سدّوه على الناس على نحوبحيث يعدّ التفوّه به كفر محض وزندقة صرفة. لقد سأوى هؤلاء معارف الأنبياء والأولياء بخصوص الذات وأسماء الحقّ وصفاته بمعارف العوام والعجائز، بل تخطّوا هذه التخوم أحيانا، وأحدهم يقول : إنّ لفلان عقائد عامية حسنة، فيا ليت لي مثل عقيدته العامية تلك!
أجل، هذا الأمر صحيح لأنّ هذا المسكين الذي يتفوّه بهذا الكلام خسر العقائد العامية من جهة، وهوإلى ذلك يعدّ بقية المعارف التي هي معارف الخواصّ وأهل اللّه باطلة. هذه الامنية تشبه امنية الكفار على ما تحكيه عنهم الكريمة الإلهية :
{ويَقُولُ الْكافِرُ يا لَيْتَنِي كُنْتُ تُراباً}[ النبأ : 40] ». ثمّ يضيف مشيرا إلى التبعات العظيمة التي تترتب على هذا الحجاب : «إذا أردنا أن نذكر الآيات والأخبار التي تدور حيال لقاء اللّه تفصيلا لكي تتبيّن فضيحة هذه العقيدة الفاسدة، التي ظهرت مع الجهالة والغرور الشيطاني، لاحتاج الأمر إلى كتاب مستقلّ، فضلا عمّا إذا أردنا أن نذكر المعارف التي تقع وراء ستار النسيان إثر هذا الحجاب الشيطاني الغليظ، حتّى يتضح بأنّ هذا الحجاب هوأحد مراتب مهجورية القرآن وعزلته، وربما كان أكثرها أسفا» (65).
بعد تفصيلات اخرى يذكرها الإمام عن هذا الحجاب ينتهي إلى أنّ العكوف على التقليد والتعصب للظاهر ورفض ما وراء ذلك، هوأيضا من مصاديق :
«الإخلاد إلى الأرض، ومن وسأوس الشيطان التي ينبغي الاستعاذة منها باللّه» (66).
وإنّ مصادرة ما عند الآخرين عبر قناع المذهبية الفكرية وأن لا يرى الإنسان شيئا إلّا من قناة مذهبه ومن خلال إطاره الفكري والمنهجي، بحيث حتّى لولمع له معنى خارج الإطار دفعه بقوّة التقليد وعصبية الانتماء إلى المذهب الفكري؛ هومن أبرز مصاديق مهجورية القرآن التي اشتكاها رسول اللّه على ندرة شكواه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وفاقا لما نطق به الحقّ في قوله سبحانه : {وقالَ الرَّسُولُ يا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً} [ الفرقان : 30].
6- حجاب التفسير والجمود على أقوال المفسّرين
تحوّل النص القرآني في تأريخ الفكر الإسلامي إلى منتج لعدد كبير من المعارف والعلوم، يأتي التفسير في طليعتها. بيد أنّ المشكلة أنّ الثقافات التي تولّدت من حول النص تحوّلت إلى سياج رفيع وفرضت حصارها عليه، على النحوالذي وأدته بعد أن أنشبت عوامل التشويه فيه.
هذه الظاهرة لم تستثن التفسير، فبقدر ما كانت ولادة التفسير حركة انعكاسية للنص القرآني، فإنّ نموهذه الظاهرة واستفحالها عاد ليتحوّل بالتفسير أحيانا إلى سور منيع يفرض بحصاره على النص القرآني، حتّى غابت في أغلب الأحيان إمكانية معاينة النص الأصلي، إلّا من خلال التفسير وعبر منظوره ومنهجياته ومفاهيمه وتراكماته المذهلة وتقاطعاته العجيبة. على أنّ التفسير أفاد كثيرا من متاخمته للنص القرآني المقدّس ليستمدّ منه بعض قداسته ويحقّق لنفسه موقعا راسخا في العقول والنفوس وفي حركة التعامل مع القرآن، حتّى غدا للتفسير سلطة لا تقلّ في هيبتها وسطوتها عن سلطة النص القرآني نفسه إن لم تفقها، مع أنّ التفسير مهما بلغ شأوه لا يزيد عن كونه اجتهادا إنسانيا في منطقة الفكر الديني، من المفروض أن لا يتعدّى دوره الكشف عن مقاصد القرآن لا طمسها وتشويهها وتغييبها (67).
تزداد مشكلة التفسير أكثر إذا أخذنا بنظر الاعتبار ما مرّ معنا في الفقرة السابقة من مساهمة كلّ المذهبيات الفرقية (شيعة، أشاعرة، معتزلة) والفكرية (فلاسفة، متكلمين، صوفية، عرفاء) والمنهجية (علميا، اجتماعيا، سياسيا) في هذا النشاط العلمي والفكري، إذ سيكون الإنسان أمام موروث تفسيري متكوّن من إسقاطات فكرية ومنهجية لا عدّ لها ولا حصر، ذلك أنّ كلّ اتجاه يسعى إلى أن يقرأ في القرآن مصادراته ومسبقاته الذهنية الثابتة عنده سلفا، كما أنّ كلّ عصر يسقط على النصّ القرآني حاجاته ويصوغها بثوب التفسير وهكذا.
بإزاء ذلك كلّه ليس غريبا أن يتمّ تنأول التفسير بوصفه حجابا ومانعا عن الفهم، وفاقا لقاعدة أنّ كلّ ما يخرج عن المقصد ينقلب إلى الضدّ ويستحيل إلى حجاب ومانع، خاصة مع ملاحظة الملابسات التي رافقت العصور الأولى لانبثاق التفسير وتقعيده كممارسة علمية لها اصولها ومبادئها، وتحولها في الأغلب إلى موروث ثابت ومقدّس لا يسمح بتجأوزه وتخطيه.
على سبيل المثال لقد شهد المجال القرآني خلطا عجيبا بين مكانة الصحابي وتفسيره وبين مكانة التابعي وتفسيره، وذلك على النحوالذي يرسل بإهاب التقديس والثبات والتفوّق المعرفي النهائي لتفسير الصحابي أوالتابعي أوتفسير الأوائل عموما، مع أنّه لا ملازمة بين الاثنين. فمكانة الصحابي أوالتابعي يحسمها البحث الكلامي ولا علاقة بذلك بالتفسير كبحث معرفي، ومهما تكن المنزلة التي يمنحها البحث الكلامي للصحابي فإنّ ذلك لا يوجب بالضرورة مكانة مماثلة في التفسير. هكذا شأن بقية المفارقات.
هذا المنحى في التحذير من تحوّل التفسير إلى مانع وآراء المفسّرين إلى سلطة تجمّد تدفّق المعرفة القرآنية وتحول دون نموّها، انطلق باكرا خاصّة مع الغزالي الذي كتب في آخر الحجب التي ذكرها : «رابعها : أن يكون قد قرأ تفسيرا ظاهرا، واعتقد أنّه لا معنى لكلمات القرآن إلّا ما تنأوله النقل عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما، وإنّ ما وراء ذلك تفسير بالرأي وإنّ من فسّر القرآن برأيه فقد تبوأ مقعده من النار، فهذا أيضا من الحجب العظيمة» (68).
سلطتا السلف والمأثور
يتوغّل النص الغزالي في حجاب التفسير حتّى يلامس قاعدته التحتية التي يشيد بناءه عليها، متمثّلة بالارتكاز إلى سلطتي المأثور والسلف خاصّة الصحابة منهم. فبعد أن يومئ إلى الانبهار وكيف يتحوّل إلى حجاب يثير قضيتين أساسيتين، هما :
الأولى : الجمود على الظاهر والتمنّع من ممارسة الفهم والاجتهاد بذريعة الخوف من الانزلاق إلى هوة التفسير بالرأي الممنوع. وهذا حجاب عظيم استوفينا الحديث عنه في الفصل الرابع قاد من جهة إلى تعطّل انطلاق التفسير الدرائي في واقع المسلمين وضعف حضوره بعد ذلك، كما تحوّل من جهة ثانية إلى سلطة لإرهاب المسلمين وصدّهم عن التعامل المباشر مع كتاب اللّه، ممّا أفضى إلى حرمان عظيم وساهم على نحوفاعل بهجر القرآن وتهميشه.
الثانية : العكوف على المأثور والمرأوحة في نطاق قول الصحابي وتفسيره وتفاسير الأوائل من التابعين وغيرهم، حتّى «غلب على طبائع أكثر الناس أنّ لا معنى للقرآن إلّا ما نقل عن ابن عباس وسائر المفسّرين» (69).
الحقيقة أنّ هناك تفاعلا سلبيا بين العاملين عاد بنتائج مدمّرة على بنية المعرفة القرآنية ونموّها، عطّلت الإنسان من الانطلاق مع آفاق النص القرآني وما ينطوي عليه من معان متكثرة رحيبة. فما دام المرء يخشى السقوط في هوة الرأي الممنوع فهوعاكف على النقل، وبعكوفه يجمّد الممارسة الدرائية وإعمال الاجتهاد في الفهم بذريعة النهي عن التفسير وهكذا، لينتهي الحال بالإنسان إلى أن يعيش «الجمود والوقوف على ما قرأه من التفاسير، وأن يعتقد أنّ لا معنى لكلمات القرآن إلّا ما يتنأوله على النقل عن ابن عباس وقتادة ومجاهد ومقاتل وغيرهم، وإنّ ما وراء ذلك تفسير بالرأي، وإنّ من تجأوز عن النقل منهم فورد عليه مفاد : من فسّر القرآن برأيه فقد تبوّأ مقعده من النار» (70).
يحذّر الشيرازي من توغّل هذه النزعة في النفوس وغلبتها على العقول، ويعزوبعض مناشئها إلى هيمنة التقليد، وهويخاطب أصحابها بالقول : «فإن كنت لا تقوى على احتمال ما يقرع سمعك من هذا النمط [من المعاني والإشارات [ما لم يسند التفسير إلى قتادة أومجاهد أوالسدي، فالتقليد غالب عليك» (71).
أمّا الإمام الخميني فيرى أنّ حجر التعامل مع القرآن على ما كتبه المفسّرون وفهموه، ومنع الآخرين من التدبّر في آياته والتفكير بنصوصه بذريعة التفسير الممنوع ، يعني عمليا تعطيل القرآن وهجره بالكامل : «من الحجب الأخر المانعة عن الاستفادة من هذه الصحيفة النورية، الاعتقاد بأنّه لا يحقّ لأحد أن يستفيد من القرآن الشريف غير ما كتبه المفسّرون وباستثناء ما فهموه.
لقد خلطوا عملية التفكّر بالآيات الشريفة والتدبّر بها بالتفسير بالرأي الذي يعدّ ممنوعا، وعن طريق هذا الرأي الفاسد والعقيدة الباطلة عطّلوا القرآن الشريف من جميع ضروب الإفادة، وجعلوه مهجورا بالكامل، على حين أنّ الاستفادات الأخلاقية والإيمانية والعرفانية لا صلة لها بالتفسير أساسا فضلا عن أن تكون تفسيرا بالرأي» (72).
عند هذه النقطة ينعطف الإمام إلى تضييق دائرة التفسير بالرأي المنهي عنه في هامش ضئيل وهويميل إلى حمله على آيات الأحكام وحسب، ليخلص إلى رسم ثلاث دوائر في التعامل مع القرآن تحدثنا عنها تفصيلا في الفصل الرابع، ونعيد الإشارة إليها إجمالا، كما يلي :
الدائرة الأولى : دائرة التفسير بالرأي الممنوع، وهي ضيّقة جدا لا تكاد تتعدّى آيات الأحكام والتعبديّات.
الدائرة الثانية : دائرة التفسير، وهذه وإن كانت أكبر من التي سلفت إلّا أنّها لا تستوعب غير المفسّرين. والقرآن لم ينزل إلى المفسّرين خاصة بل هوخطاب عام للإنسانية جمعاء فضلا عن المسلمين، ومن ثمّ لا معنى لحصر نطاق التعامل مع القرآن من قناة المفسّرين وحدهم، ورمي ما يقع خارج ما فهموه بعدم المشروعية أونعته بالتفسير بالرأي المنهي، لا سيّما بعد أن حدّد الإمام حيّز التفسير بالرأي المنهي.
الدائرة الثالثة : وهي دائرة فسيحة جدّا تستوعب الناس جميعا، وتستقطب إليها عددا كبيرا من الاتجاهات وضروب المعارف.
في هذه الدائرة يجوز لكلّ إنسان بل يجب عليه أن يتعامل مع القرآن مباشرة ويغترف من عطاياه.
كما يدخل فيها ما يكون من لوازم الكلام وبيان مصاديق المفاهيم، وما يتسق مع البرهان والدليل العقلي، وما يكون بحكم اللطائف التي تقوم عليها شواهد سمعية (73)، وغير ذلك ممّا فصّلنا الحديث عنه في موضعه.
أثناء حديثه عن هذا الحجاب يفتح الإمام المجال واسعا أمام الممارسة العقلية التي تقع خارج نطاق التفسير فضلا عن أن تكون تفسيرا بالرأي، وهويسجّل نصّا : «وإلّا فإنّ إثبات الصانع والتوحيد والتقديس وإثبات المعاد والنبوّة، بل مطلق المعارف هوحقّ طلق للعقول ومن مختصاته» (74)، قبل أن يعرج على نقد بعض الاتجاهات النصوصية التي تجعل من النقل أساسا لإثبات الأصل (75).
7- حجاب المعاصي
تنتمي الحجب التي تمّ استعراضها حتّى الآن إلى جهة التعامل المنهجي مع القرآن كنصّ نتعاطاه إدراكيا عبر الممارسة الذهنية والنظر العقلي، وإن كان بعضها لا يخلومن إشارة إلى مناشئ أخلاقية كما هوالحال في التعاطي مع العلم كحجاب.
فالتركيز على حجب كالبعد الآحادي في العلم أواحتكار الحقيقة أوتضخيم النزعات اللغوية والعكوف على النقل وقول الصحابي ومرجعيات السلف عامة، جاءت كلّها في أفق عقلي بحت تقريبا وكموانع إدراكية نظرية لا صلة لها بطهارة القلب وتزكية الباطن كعلّة في وجودها أوعدمها. ولذلك اختفت لغة المدرسة الوجودية أوالعرفانية، ولم تبرز أدبياتها ومنظوراتها في فهم القرآن ما خلا إشارات عابرة.
لكن مع الحجاب أوالمانع الجديد وما يليه ستعود هذه اللغة ببناها وشروطها واستحقاقاتها لتسجّل حضورها بكثافة، حتّى يمكن القول جريا على تقسيمات المدرسة ذاتها وأسلوبها في عدم الاكتفاء بالجانب العقلي النظري وحده بل الانتقال منه إلى ما بعده؛ إنّ البحث في موانع الفهم راح هوالآخر ينتقل إلى طور آخر هوطور القلب بعد أن استنفد طاقاته في الطور العقلي والجانب الإدراكي.
مع هذا الحجاب والمانع تعود إلينا اللغة الوجودية التي عشنا معها طويلا في الفصل الخامس، وتبرز أمامنا بكامل طاقاتها ونحن نقرأ نصا : «معاني القرآن من الملكوت، وكلّ ما غاب عن الحواس ولم يدرك إلّا بنور البصيرة فهومن الملكوت» (76). فما دامت معاني القرآن من طبيعة ملكوتية فهي تدرك بالنور والبصيرة، وهذان يحجبان بالشيطان والذنوب والكدورات النفسية والانكباب على الدنيا، وما يفضي إليه ذلك كلّه من عمى في البصيرة وخلود إلى عالم الملك.
هنا يخرج القرآن عن ثوبه اللفظي وكيانه اللغوي، ويتجأوز مداه العقلي كنص مدرك بأدوات النظر العقلي، لنكون إزاء ظاهرة وجودية ينبغي مقاربتها بغير أدوات اللغة والإدراك العقلي. للقرآن هنا أسرار «تحتها معان مدفونة لا تنكشف إلّا للموفّقين» (77). والموفّقون هم أهل القلوب وسطعات النور العقلي.
ومع أنّ الحاصل عمليا أنّ قلّة قليلة هي التي تستطيع التعامل مع القرآن على هذا المستوى ومن خلال هذا الأفق النفسي الرفيع، إلّا أنّ هذه المدرسة لا تخفي إيمانها بإمكان الجميع في بلوغه «لأنّ النفوس بحسب أصل فطرتها صالحة لقبول نور الإيمان وفيض الرحمن، إذا لم تطرأ لها ظلمة تفسدها أوحجاب يحجبها عن إدراك الحقّ، كما في قوله تعالى {وطُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ} [ التوبة : 87] ، وقوله : {بَلْ رانَ عَلى قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ} ، فإذا أعرضت نفس إنسانية عن دواعي البدن والاشتغال بما تحتها من الشهوة والغضب والحس والتخيّل، وتوجّهت وولّت بوجهها تلقاء عالم الملكوت الأعلى اتصلت بالسعادة القصوى، ورأت عجايب الملكوت وآيات اللّه الكبرى، كما قال تعالى : {لَقَدْ رَأى مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْكُبْرى} [النجم : 18] » (78).
فالطريق إذا مفتوح لكنّه غير مطروق بكثرة لغلبة المعاصي، وبتعبير الإمام :
«من الحجب الاخرى المانعة عن فهم القرآن الشريف والاستفادة من معارف هذا الكتاب الإلهي ومواعظه، حجاب المعاصي والكدورات الناشئة عن الطغيان والكبر بإزاء ساحة قدس ربّ العالمين، ممّا يؤدّي إلى حجب القلب عن إدراك الحقائق» (79).
القلب أوالروح الإنساني هوبمنزلة المرآة التي ينبغي أن تحافظ على صقالتها ونقائها الذاتي، كما ينبغي أيضا أن لا يحجبها حائل عن المطلوب حتّى تؤدّي غرضها على ما يرام، والذنوب لا سيّما الكبر والإصرار على المعاصي والانكباب على الدنيا هي في طليعة ما يلوّث صفاء هذه المرآة التي تومئ إلى القلب أوالروح. لهذا سجّل الغزالي في ثالث ما ذكره من الحجب : «ثالثها : أن يكون مصرّا على ذنب أومتّصفا بكبر أومبتلى في الجملة بهوى في الدنيا مطاع، فإنّ ذلك سبب ظلمة القلب وصدئه، وهوكالخبث على المرآة فيمنع جلية الحقّ من أن يتجلّى فيه، وهوأعظم حجاب للقلب وبه حجب الأكثرون». على أنّ المسألة لا تلبث أن تأخذ صيغة المعادلة الطردية بين الشهوات وصدأ القلب، وصيغة المعادلة العكسية بين هذين الاثنين واحتجاب معاني القرآن، إذ «كلّما كانت الشهوات أشدّ تراكما كانت معاني الكلام أشدّ احتجابا، وكلّما خفّ عن القلب أثقال الدنيا قرب تجلّي المعنى فيه. فالقلب مثل المرآة والشهوات مثل الصدأ، ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراءى في المرآة، والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل تصقيل الجلاء للمرآة» (80).
يكتسب هذا التمثيل وصفا أدقّ مع الشيرازي، وهويميّز بين موانع داخلية وخارجية تصيب القلب وتمنعه من الفهم، يوضّحه بالصيغة التالية : «فلفهم معاني القرآن موانع غير ما ذكر، إذ القلب لإدراك حقائق الأشياء بمنزلة المرآة لانشباح صورها المرئية، كما أنّ حجب المرآة بعضها داخلية كالطبع والرين وعدم الصقالة، وبعضها خارجية كوجود الحائل وعدم المحاذاة بوجهها شطر المطلوب، فكذلك حجب القلب عن الفهم، بعضها في داخله وبعضها في خارجه. أمّا الحجاب الداخلي فبعضها من باب الأعدام والقصورات كالطفولية والبلاهة والجهل البسيط، وبعضها وجودية كالمعاصي والرذائل» (81). ثمّ يأتي بكلام الغزالي السابق، لينتقل بعدئذ إلى الحجب الخارجية التي يقسّمها بدورها إلى قسمين بعضها عدمية كعدم الفكر، وبعضها الآخر «وجودية كوجود الاعتقادات العامّية التقليدية أو الجهليات الفلسفية. وهذا بمنزلة الغلاف للمرآة أوالحاجز كالجدار» (82). أهمّية هذا النص للشيرازي أنّه يقيم وزنا للامور الإدراكية كروادع للفهم القلبي، ولا يقصر المؤثّرات على المعاصي والخصال الأخلاقية المذمومة وحدها، وإن كان ثقل الرؤية يبقى رهينا لتطهير المحتوى الداخلي.
يقترن التمثيل الحسي ذاته الكائن في مثال المرآة مع التفسير الموجود في نصوص الإمام الخميني عند بيانه لهذا الحجاب، حيث يقول في امتداد نص سابق :
«ينبغي أن يعلم، كما أنّه لكلّ عمل من الأعمال الصالحة أوالسيّئة صورة تتناسب معه في عالم الملكوت فله أيضا صورة في ملكوت النفس، تحصل بواسطتها في باطن ملكوت النفس إمّا نورانية يكون معها القلب مطهّرا ومنوّرا، وعندئذ تكون النفس صافية كالمرآة المصقولة تليق بالتجليّات الغيبية [ومستعدّة] لظهور الحقائق والمعارف فيها، وإمّا أن يصير ملكوت النفس ظلمانيا خبيثا، وحينئذ يكون القلب كالمرآة المرينة الملوّثة التي يعلوها الصدأ والرين، لا تتحقّق فيه المعارف الإلهية ولا تنعكس به الحقائق الغيبية.
في هذه الحالة ما دام القلب يقع تدريجيا تحت سلطة الشيطان، ويكون إبليس هوالذي يتصرّف بمملكة الروح، فإنّ ذلك الخبيث يستحوذ أيضا على السمع والبصر وسائر القوى الاخرى ويتصرّف بها ، على النحوالذي يصمّ السمع عن المعارف والمواعظ الإلهية بالكامل، ولا تبصر العين الآيات الإلهية الباهرة وتعمى عن الحقّ وآثاره وآياته، ولا يتفقّه القلب بالدين ويكون محروما عن التفكّر في الآيات والبيّنات وتذكّر الحقّ والأسماء والصفات، كما يقول الحقّ تعالى : {لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها ولَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِها ولَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بِها أولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ} [الأعراف : 179]. نظرة هؤلاء إلى العالم تصير كنظر الأنعام والحيوانات خالية عن التدبّر والاعتبار، وتصبح قلوبهم كقلوب الحيوانات لا نصيب لها من التفكّر والتدبّر، بل تزداد غفلتهم عن النظر في الآيات وسماع المواعظ والمعارف ويزداد استكبارهم يوما بعد آخر، فهم إذن أرذل من الحيوان وأضلّ» (83).
هنا يخرج بنا النص عن الكيان اللغوي للقرآن ويدخل في صميم الاستعداد الوجودي لبنية الإنسان، فقد يكون الإنسان خبيرا بالعربية وبمدلولات النص القرآني ومفاهيمه، بيد أنّه معزول عن حقيقة القرآن بعدم الاستعداد : «ثمّ إنّك أيها المغترّ بفطانتك البتراء لوأنصفت قليلا ... لعلمت أنّ المشار إليهم بقوله تعالى :
{إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ} [الشعراء : 212] كانوا عارفين بدقائق علم الألفاظ وفنون تأدية الكلام على ما يوافق المرام، لأنّهم من العرب العرباء والفصحاء الدهناء، بل إنّما انعزالهم عنه لعدم استعدادهم للاهتداء بأنوار القرآن والارتقاء إلى أعلام الحقيقة والعرفان والاطلاع على أسرار المبدأ والمعاد والوصول إلى عالم الملكوت والتقرّب بالحق الجواد». على أنّ عدم الاستعداد هذا ليس جبلّيا فيهم. بل هووليد الطغيان والكبر والعتوبأعلى صوره ممّا اسدل عليهم حجبا كثيفة كلية : «ثمّ لا يخفى على أولي النهى أن تولّي مثل أبي لهب وأبي جهل وغيرهما عن القرآن وانعزالهم عن السمع، ليس من جهة عدم فهمهم ترجمة القرآن [أي وعي المعاني المفاهيمية للنص] أوعدم اطّلاعهم على ظاهر العربية وقواعد النحووالصرف وعلم البيان، ولا لأجل الصمم في آذانهم الجسمانية، والعمى في أعينهم البدنية، والبكم في قلوبهم الحيوانية ولكن لأنّهم كانوا من أهل الغفلة والحجاب الكلّي، عمي القلوب عن مشاهدة الحقائق، صمّ العقول عن سماع ذكر الحبيب، بكم الأرواح عن قبول دعوة الإله واستدعاء طلب التقرّب إلى الحقّ بالإعراض عمّا سواه، كما أخبر عنهم بقوله :
{صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ} [البقرة : 171] » (84).
لا تكتمل هذه الرؤية دون استعادة التميّز بين العقل والنور العقلي، فما له دور في هذا النطاق هوالعقل- القدسي العبودي أوالعقل المستفاد الذي يرسل بأنواره على الروح أوالنفس الإنسانية، فتتراءى في النفس «حقائق الملكوت وخبايا الجبروت، كما تتراءى بالنور الحسي الأشباح المثالية في المرائي الصيقلية»، هذا «إذا لم يفسد صقالتها بطبع، ولم يتكدّر صفائها برين، ولم يمنعها حجاب عن ذلك» (85).
على ضوء تكامل عناصر هذه الرؤية نتفهّم أيضا تصريحات هذا الخطّ حول التفسير وقيمته، هذه التصريحات التي تبدونافرة حادة صادمة للوعي تعود لتبدومنسجمة مع الرؤية بعد هذا التطواف. فعند ما يصنّف الغزالي مثلا علم التفسير الظاهر في خانة علوم القشر والصدف، فهويقصد من يقف بالتعامل مع القرآن عند تخوم هذا التفسير ظانّا أنّه الدّر ولا شيء أنفس منه، في حين أنّ وراءه مراتب ما أعظم حرمان الناس منها، لظنّهم ذاك وقناعتهم به : «يليه علم التفسير الظاهر، وهوالطبقة الأخيرة من الصدفة القريبة من مماسّة الدّر. ولذلك يشتدّ به شبهه حتّى يظنّ الظانّون أنّه الدّر وليس وراءه أنفس منه، وبه قنع أكثر الخلق، وما أعظم غبنهم وحرمانهم إذ ظنّوا أنّه لا رتبة وراء رتبتهم» (86). ليس المقصود إذن مصادرة التفسير، بل تجأوزه إلى ما بعده بعد استنفاد أغراضه وامتصاص طاقاته.
وما دام الحديث يدور عن معان هي من الملكوت، وفي داخل منطقة اسمها البصيرة، وأداتها القلب مدعما بالمكاشفة والعلم اللدني، وفي ظلّ أجواء مفعمة بصفاء النفس وطهارة الداخل، فلا معنى لإقحام العلوم الكسبية والأفكار النظرية، فهذه كلّها والأدلة البرهانية معها مكانها منطقة العقل. على هذه الخلفية يتطهّر النص التالي من مدلولاته السلبية المنفّرة التي تتراءى لنا لأول وهلة، ليعود نصا إيجابيا منسجما مع مبادئه وإطاره المرجعي بالكامل : «واعلم أنّ النفس ما لم تكن صافية عن غشأوة العلوم التقليدية المكتسبة من الأقوال، وعن الأفكار النظرية الحاصلة باستعمال المنطق بآلتي الوهم والخيال للعقل الفكري، لم يكن صاحب بصيرة في الإلهيات بل في جميع العلوم، ولم يكن قابلا للفتح الإلهي، وبعيد من أن يحصل له شيء من العلم اللدني الحاصل لنفوس الأميّين، وهم الذين كتب نفوسهم وألواح قلوبهم خالية عن نقوش هذه الأقأويل المتعارفة ... لصفاء قلوبهم عن غير اللّه وسلامة صدورهم عن هذه الوسأوس» (87). فالمقصود هنا منطقة القلب، ولا معنى للكسب في منطقة القلب التي تأتي طورا ما بعد طور العقل.
انطلاقا من الأفق ذاته نعيد قراءة نص الإمام التالي في تقويم حركة التفاسير والحكم عليها، قراءة إيجابية خالية من إيحاءات التعريض بجهود المفسّرين ومصادرتها : «بعقيدة الكاتب [يعني نفسه] لم يدوّن تفسير لكتاب اللّه» (88) حتّى الآن. فالتفاسير المصنّفة كثيرة وبعضها موضع ثناء الإمام وتقديره، إنّما المقصود أنّه لم يكتب تفسير للقرآن بلحاظ مقاصده السامية التي يفهمها الإمام، يتقدّمها مقصد معرفة اللّه في أسمائه وصفاته ومظاهر هذه الأسماء والصفات وتجلياتها، ممّا يتخطّى حدود العقل وآلته البرهان إلى القلب.
فلا الغزالي أراد خفض شأن التفسير الظاهر، ولا الشيرازي قصد إلغاء العلوم الكسبية ولا الإمام الخميني رام مصادرة جهود المفسّرين، بل الهدف الماثل أمامهم هوفتح باب المعرفة القلبية والاقتراب من معاني القرآن وحقائقه باختراق الحجب وتجأوزها.
8- حجاب الانغمار بالدنيا
يأتي هذا الحجاب الذي يحول بين الإنسان ومعارف القرآن في امتداد الحجاب الذي سبقه، ويندمج معه في نسيج واحد. لذلك نسعى أن نتعرّف عليه من خلال النصوص مباشرة.
يسجّل الإمام الخميني بعد انتهائه من الحديث عن حجاب الذنوب والمعاصي مباشرة، ما نصّه : «من الحجب الغليظة الاخرى التي تعدّ سترا صفيقا يحول بيننا وبين معارف القرآن ومواعظه، حجاب حبّ الدنيا، فبواسطة هذا الحجاب يصرف القلب تمام همّته إلى الدنيا وتصير وجهته دنيأوية بالكامل. إنّ القلب ليغفل بواسطة هذه المحبّة عن ذكر اللّه، ويعرض عن الذكر والمذكور» (89).
تكتسب العلاقة بين حبّ الدنيا وهذا الحجاب طابعا طرديا : «فكلّما ازدادت العلاقة بالدنيا وأوضاعها صار حجاب القلب أضخم وأكثر سمكا ومناعة» (90) حتّى يبلغ هذا الحجاب في مداه أحيانا أنّه يحجب نور الفطرة بالكامل : «ربّما تتغلّب هذه العلاقة على القلب أحيانا وتبلغ هيمنة سلطان حبّ الجاه والشرف على القلب مدى يؤدّي إلى انطفاء نور فطرة اللّه بالكامل، ويفضي إلى أن تؤصد أبواب السعادة بوجه الإنسان» (91).
صحيح أنّ للفهم مرتكزاته في العقل : {إِنَّما يَتَذَكَّرُ أولُوا الْأَلْبابِ} [الرعد : 19] ، بيد أنّ الصحيح أيضا أنّ اللّه سبحانه شرط فيه أيضا الإنابة واليقظة والتذكير : {تَبْصِرَةً وذِكْرى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ}[ ق : 8] ، كما قوله : {وما يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ} [غافر : 13] ، ومن : «آثر غرور الدنيا على نعيم الآخرة فليس من ذوي الألباب» فضلا عن أن يكون من ذوي القلوب والبصائر «ولذلك لا تنكشف له أسرار الكتاب» (92).
على هذا المستوى من الرؤية تكون علاقة القرآن مع القلب لا مع العقل وعلومه، وبذلك يأتي صفاء القلب والعزوف عن الدنيا في أول شروط المعرفة :
«والقرآن غذاء للقلوب الصافية، وبلاء للنفوس المريضة بداء الجهالة لقوله تعالى :
{هُولِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وشِفاءٌ والَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذانِهِمْ وَقْرٌ وهُوعَلَيْهِمْ عَمًى أولئِكَ يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ} [ فصلت : 44] ... ولا شبهة في أنّ المشتغلين بالدنيا المنهمكين في اللذات ليسوا من أهل الاهتداء بنور القرآن، ولا يمكنهم الارتقاء إلى نشأة العرفان» (93).
القلب الصافي السليم هوالأرضية التي تنزل عليه المعارف في هذا الطور، وإلّا إذا كان القلب منكفئا على الدنيا ملوّثا بعلائقها لا تينع فيه تلك المعارف بل تتحوّل إلى ضدّها، وقد مثّلوا بذلك بمقولة لسقراط : «البدن الذي ليس بالنقي كلّما غذّوته فقد زدته شرا ووبالا»، وذكروا في بيانه : «أنّ المراد منه الإشارة إلى كيفية اقتناء العلوم الربانية، التي يتوقّف الاستكمال بها على تصفية السرّ عن محبة الشهوات، وتخلية الباطن عن الوسأوس والكدورات» (94). ولا ريب أنّ حبّ الدنيا والارتباط الحثيث بها هوفي طليعة أقفال القلوب : «وربّما كان المراد من أقفال القلب في الآية الشريفة : {أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها} [محمّد : 24] هذه الأقفال والعلائق الدنيوية» (95).
لا مناص لمن يرغب أن يلج حريم القرآن على هذا المستوى ويتذوّق معارفه في هذه المنطقة، من أن يطهّر قلبه عن العلائق التي تمثّل جوهر حبّ الدنيا (96) : «إذا ما أراد الإنسان أن يستفيد من معارف القرآن وينتفع بمواعظه الإلهية، ينبغي له أن يطهّر القلب من هذه الأرجاس ومن لوث المعاصي القلبية المتمثّلة بالاشتغال بالغير، لأنّ القلب غير المطهّر لا يكون محرما لهذه الأسرار.
قال تعالى : {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ* فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ* لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ}[ الواقعة : 77- 79] ، فكما أنّ غير المطهّر بالطهارة الظاهرية ممنوع تشريعا وتكليفا من ظاهر هذا الكتاب ومسّه في عالم الظاهر [أي فيما هوموجود من ظاهر القرآن الذي بين أيدينا متمثّلا بهياكل الحروف والصورة اللفظية] فكذلك ممنوع من معارفه ومواعظه ومن باطنه وسرّه من كان قلبه ملوّثا بالأرجاس والتعلقات الدنيوية» (97).
هذه المقاربة بين مسّ الظاهر المنوط بشروط تشريعية تكليفية وبين مسّ معارفه ومقاربة أسراره وبواطنه التي ترتكز هي الاخرى إلى شروط وجودية وأخلاقية خاصّة؛ يعود الإمام إلى تعميقها أكثر من خلال مثال آخر، وهولا يزال يحدّثنا عن حجاب حبّ الدنيا، فيقول : «وقال تعالى : {ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ} [البقرة : 2] إلى آخر الآية، فغير المتّقي بحسب مستوى تقوى العامة [جمهور الناس] وغير المؤمن بحسب مستوى إيمان العامّة، محروم من الأنوار الصورية لمواعظ [القرآن] وعقائده الحقّة. أمّا غير المتّقي وغير المؤمن بحسب بقية مراتب التقوى المتمثّلة بتقوى الخاص وخاص الخاص وأخصّ الخواص، فهومحروم من مراتبها [المعارف والمواعظ والمعارف القرآنية الإلهية الحقة] الاخرى» (98).
المهمّ أنّ الدنيا في هذا النسق من الفهم تمثّل بكثرة أشيائها وما تفرزه هذه الأشياء من علائق، حجبا متراكمة «بعضها فوق بعض» (99) تستقطب الإنسان وتجرّه إلى غياهبها، فهل إلى الخلاص منها من سبيل؟ بقدر تشدّد هذه المدرسة على تنظيف الطريق وتعبيده من العقبات، فهي لا تغلق الباب بوجه الإنسان، بل يبدووكأنّها تفتحه على مصراعيه أمامه، إيمانا منها : «أنّ جميع أفراد الناس ممّا يوجد فيهم الحركة المعنوية نحوالآخرة، إلّا أنّهم يتفأوتون في كيفية هذه الحركة».
فالطريق إذن مفتوح، له مرتكزاته الشرعية الواضحة المتمثّلة بالانتباه واليقظة ، والتوبة والإنابة، وملازمة الشريعة وفك الارتباط مع الأشياء وليس ترك حيازتها، ومزأولة العمل الصالح وهكذا.
نقطة البدء في هذا المسار أن يتعرض الإنسان إلى نفحات اللّه، فإن «أدركته لمعة من أنوار الرحمة تيقّظ من رقدة الجهالة، وتنبه من نوم الطبيعة، وتفطن بأنّ ما وراء هذه المحسوسات عالم آخر، وفوق هذه اللذات الحيوانية لذات اخر، فحينئذ يتوب عن اشتغاله بالمزخرفات، وينيب إلى اللّه من هذه المنهيات التي زجرها الشارع، فيشرع في التدبّر في آيات اللّه واستماع مواعظه، والتأمّل في أحاديث نبيّه، والعمل بمقتضى شريعته، فيشرع في ترك الفضول الدنيأوية من الجاه والمال وغيرهما طلبا للكمالات الأخروية، ويعزم عزما تامّا إن أدركته العناية الإلهية إلى التبتّل إليه والسلوك نحوه من موطن نفسه ومقام هواه، فيظهر له لوامع الملكوت وينفتح له باب الغيب، ويلوح له لوائح عالم القدس مرة بعد اخرى، فيشاهد امورا غيبية في صورة مثالية، فإذا ذاق منها شيئا يرغب في الخلوة والعزلة وذكر اللّه على الدوام، ويفرغ القلب عن المشاغل الحسية ويتوجه باطنه إلى اللّه بالكلية، فيفيض عليه العلوم اللدنية والأسرار الإلهية» (100).
القرآن في هذه الرؤية نور، والقلب هوالقناة التواصلية مع هذا النور : «ما دام الإنسان محجوبا بحجاب ذاته فلا يستطيع الإنسان أن يدرك هذا القرآن الذي هونور. القرآن نور كما يصف نفسه، ومن يعيش في الحجاب ويتوارى خلف حجب كثيرة لا يستطيع إدراك هذا النور، يخيّل إليه أنّه يستطيع لكنه لا يستطيع. فما لم يفلت الإنسان من حجابه الحالك، وما دام يعيش شراك الأهواء النفسية والغرور والإعجاب بالنفس، وما دام مبتليا بالامور التي أوجدها في باطن نفسه التي هي ظلمات بعضها فوق بعض، فلا يكون مؤهّلا في أن ينعكس هذا النور الإلهي في قلبه.
إنّ من يريد أن يفهم القرآن ومحتواه، وليس صورته الصغيرة النازلة، بل يفهم محتواه على النحوالذي تكون حصيلة أي شيء يقرأه منه الارتقاء نحوالأعلى، وعلى النحوالذي كلّما قرأ القرآن يقترب من مبدأ النور ومن المبدأ الأعلى؛ إذا ما رام الإنسان أن يفهم القرآن ويقرأه على هذا النحوفلا سبيل له إلى ذلك إلّا بالتحرّر من الحجب، و«الإنسان نفسه هوحجاب نفسه»، ومن ثمّ ينبغي لك أن تنفلت من هذا الحجاب وتتخلّص منه حتّى تستطيع أن تدرك هذا النور كما هو، وأن تكون إنسانا مؤهلا لإدراكه» (101).
أخيرا روي في النبوي الشريف : «إذا عظّمت أمّتي الدينار والدرهم نزع منها هيبة الإسلام، وإذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرموا بركة الوحي»، قال الفضيل : «يعني حرموا فهم القرآن» (102).
(2)- إحياء علوم الدين 1 : 284.
(3)- آداب الصلاة : 195.
(4)- نفس المصدر : 191- 192.
(5)- نفس المصدر : 192
(6)- نفس المصدر : 195.
(7)- نفس المصدر.
(8)- نفس المصدر.
(9)- إحياء علوم الدين 1 : 284.
(10)- لم يوفر الإمام في نقده المجالين الفلسفي والعرفاني حين يكتفي الفيلسوف والعارف بالاصطلاح وينشغل به عن القرآن، كما سيأتي الحديث عنه تفصيلا.
(11)- تفسير القرآن الكريم 6 : 10- 11.
(12)- نفس المصدر : 21.
(13)- آداب الصلاة : 192.
(14)- وسائل الشيعة 6 : 220، كتاب الصلاة، أبواب قراءة القرآن، الباب 30، الحديث 2.
(15)- جواهر القرآن : 36.
(16)- مفهوم النص : 9.
(17)- نفس المصدر : 10.
(18)- نفس المصدر : 25.
(19)- نفس المصدر : 10. تبقى هنا نقطة تمليها أمانة النقل وفهم الرأي في إطار متبنيات صاحبه والمبادئ التي تؤطّر فهمه والاصول التي تصوغ مرجعيته، فصاحب هذه الرؤية لا ينكر وجود حقيقة ما ورائية للقرآن الكريم كما لا يحرص على إثباتها والدفاع عنها، وإنّما يمر عليها مرورا محايدا مفترضا- وفاقا لمنهجه وإطاره في الفهم- أنّ : «الإيمان بوجود ميتافيزيقي سابق للنص» في «العلم الإلهي أوفي اللوح المحفوظ» لا يتعارض والتعامل مع القرآن كنصّ لغوي وحسب، كما لا يتعارض أيضا «مع تحليل النص من خلال فهم الثقافة التي ينتمي إليها»، إذ ما بين أيدينا فعلا في عالم الشهادة والملك هوهذا «النص اللغوي» فقط دون تلك الحقيقة الغيبية المأورائية. (راجع : مفهوم النص : 24، 25 ومواضع اخرى من الكتاب)
(20)- الكافي 2 : 599/ 3.
(21)- نور الثقلين 3 : 74/ 176.
(22)- سلسلة عالم المعرفة الكونية، العدد 276 : 453 و457، الثقافة العربية وعصر المعلومات، الدكتور نبيل علي.
(23)- نفس المصدر : 457.
(24)- آداب الصلاة : 192.
(25)- نفس المصدر : 194.
(26)- مفاتيح الغيب : 62.
(27)- آداب الصلاة : 193.
(28)- نفس المصدر : 192.
(29)- تفسير القرآن الكريم 7 : 185.
(30)- نفس المصدر 1 : 29.
(31)- نفس المصدر : 30.
(32)- جواهر القرآن : 36.
(33)- نفس المصدر : 37.
(34)- تفسير القرآن الكريم 7 : 185.
(35)- نسب أبوالعبّاس المبرّد الشعر إلى مروان بن سليمان بن يحيى يهجوبه قوما من رواة الشعر. راجع : الكامل 3 : 857.
(36)- الزاملة : بعير تحمل المتاع.
(37)- الغرائر : الجوالق العظام.
(38)- آداب الصلاة : 198.
(39)- نفس المصدر : 199.
(40)- نفس المصدر : 195- 196.
(41)- تفسير سورة حمد : 142.
(42)- نفس المصدر.
(43)- نفس المصدر.
(44)- نفس المصدر : 144.
(45)- نفس المصدر.
(46)- مصطلح يشمل جميع العلوم الكسبية المتدأولة في نطاق العلوم الإسلامية ذلك في مقابل المعارف الكشفية.
(47)- تفسير سورة حمد : 142.
(48)- نفس المصدر.
(49)- نفس المصدر : 143.
(50)- نفس المصدر.
(51)- نفس المصدر : 143- 144.
(52)- تفسير القرآن الكريم 6 : 20- 21، مفاتيح الغيب : 17.
(53)- إحياء علوم الدين 1 : 284.
(54)- راجع مفاتيح الغيب : 62، حيث جاء الشيرازي بعبارة الغزالي ونقلها دون تغيير حرف ممّا يدل على تبنية موقفه من المسألة.
(55)- تفسير سورة حمد : 142.
(56)- نفس المصدر.
(57)- تفسير القرآن الكريم 1 : 31.
(58)- نفس المصدر : 415.
(59)- إحياء علوم الدين 1 : 284.
(60)- نفس المصدر 2 : 284، وقد ثبته عنده الشيرازي عند حديثه عن هذا الحجاب ما خلا تغيير طفيف في عدد من الكلمات. (راجع مفاتيح الغيب : 62)
(61)- تفسير القرآن الكريم 1 : 415.
(62)- نفس المصدر : 416.
(63)- نفس المصدر : 417.
(64)- آداب الصلاة : 196- 197.
(65)- آداب الصلاة : 197- 198.
(66)- نفس المصدر : 199.
(67)- راجع في حركة التفسير وكيف تحولت إلى سياج يؤطر النص القرآني، ويحول دون فهمه إلّا من خلال ما أفرزه التفسير من أدوات ومنهجيات ومفاهيم، بحيث استحال التفسير نفسه إلى سلطة شبه تقديسية تجعله بمثابة نص ثان، راجع : التفاسير القرآنية المعاصرة : قراءة في المنهج.
(68)- إحياء علوم الدين 1 : 285، مفاتيح الغيب : 63.
(69)- مفاتيح الغيب : 69.
(70)- نفس المصدر : 63.
(71)- تفسير القرآن الكريم 4 : 174، مفاتيح الغيب : 96.
(72)- آداب الصلاة : 199.
(73)- نفس المصدر : 347.
(74)- نفس المصدر : 200.
(75)- نفس المصدر : 200- 201.
(76)- إحياء علوم الدين 1 : 282، مفاتيح الغيب : 62.
(77)- إحياء علوم الدين 1 : 282- 283.
(78)- مفاتيح الغيب : 34.
(79)- آداب الصلاة : 201.
(80)- إحياء علوم الدين 1 : 284.
(81)- مفاتيح الغيب : 61.
(82)- نفس المصدر : 61- 62.
(83)- آداب الصلاة : 201.
(84)- تفسير القرآن الكريم 6 : 11.
(85)- مفاتيح الغيب : 34.
(86)- جواهر القرآن : 37.
(87)- مفاتيح الغيب : 46.
(88)- آداب الصلاة : 192.
(89)- نفس المصدر : 201- 202.
(90)- نفس المصدر : 202.
(91)- نفس المصدر.
(92)- إحياء علوم الدين 1 : 284- 285.
(93)- تفسير القرآن الكريم 6 : 11- 12.
(94)- نفس المصدر.
(95)- آداب الصلاة : 202.
(96)- يطرح الإمام مفهوما لحب الدنيا يرتكز إلى العلاقة، فكل ما تربطنا به علاقة وإن زهد وكان تافها فهوتعبير عن حب الدنيا، وكلّما ما لا تربطنا به مثل هذه العلاقة فهوخارج عن المفهوم. يقول : «الميزان هوالعلاقة، ميزان الدنيا هي تلك العلائق التي تربط الإنسان بهذه الأشياء». على هذا يمكن لصاحب قصر فخم أن لا يكون من أهل الدنيا على حين يكون طلبة من طلاب الحوزة العلمية من أهلها لمحض علاقته بكتاب يملكه، كما يمثل الإمام نفسه على هذا. فالمدار ليس الحيازة وعدمها، بل العلاقة وعدم العلاقة، والمطلوب أن يتحرر الإنسان مع علائقه بالأشياء، لا أن يتخلى عن حيازتها. راجع : تفسير سورة حمد : 147.
(97)- آداب الصلاة : 202.
(98)- آداب الصلاة : 202.
(99)- تفسير سورة حمد : 147 وفيه بحث دقيق عن حبّ الدنيا عرضه الإمام في عام 1979.
(100)- مفاتيح الغيب : 54.
(101)- صحيفه امام 14 : 388- 389.
(102)- إحياء علوم الدين 1 : 284.
 الاكثر قراءة في مواضيع عامة في علوم القرآن
الاكثر قراءة في مواضيع عامة في علوم القرآن
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية











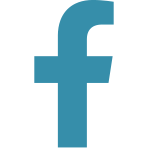
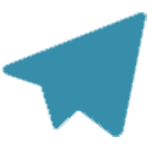
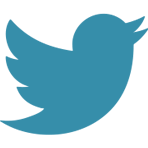

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)