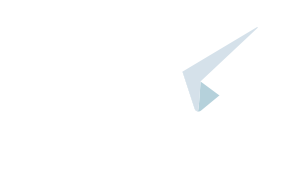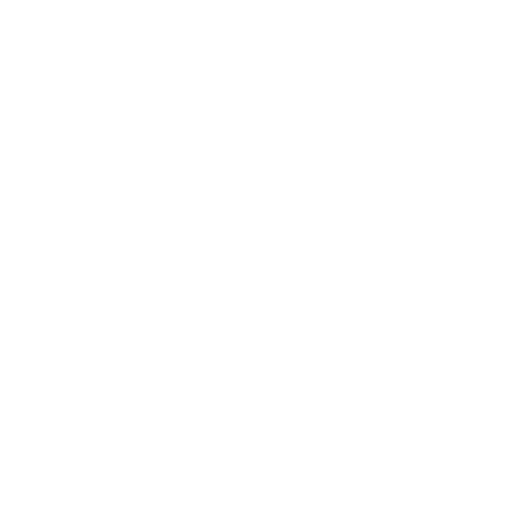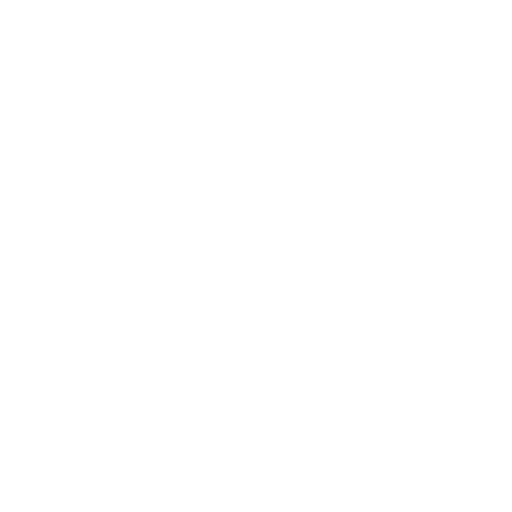التاريخ والحضارة

التاريخ

الحضارة

ابرز المؤرخين


اقوام وادي الرافدين

السومريون

الساميون

اقوام مجهولة


العصور الحجرية

عصر ماقبل التاريخ

العصور الحجرية في العراق

العصور القديمة في مصر

العصور القديمة في الشام

العصور القديمة في العالم

العصر الشبيه بالكتابي

العصر الحجري المعدني

العصر البابلي القديم

عصر فجر السلالات


الامبراطوريات والدول القديمة في العراق

الاراميون

الاشوريون

الاكديون

بابل

لكش

سلالة اور


العهود الاجنبية القديمة في العراق

الاخمينيون

المقدونيون

السلوقيون

الفرثيون

الساسانيون


احوال العرب قبل الاسلام

عرب قبل الاسلام

ايام العرب قبل الاسلام


مدن عربية قديمة

الحضر

الحميريون

الغساسنة

المعينيون

المناذرة

اليمن

بطرا والانباط

تدمر

حضرموت

سبأ

قتبان

كندة

مكة


التاريخ الاسلامي


السيرة النبوية

سيرة النبي (صلى الله عليه وآله) قبل الاسلام

سيرة النبي (صلى الله عليه وآله) بعد الاسلام


الخلفاء الاربعة

ابو بكر بن ابي قحافة

عمربن الخطاب

عثمان بن عفان


علي ابن ابي طالب (عليه السلام)

الامام علي (عليه السلام)

اصحاب الامام علي (عليه السلام)


الدولة الاموية

الدولة الاموية *


الدولة الاموية في الشام

معاوية بن ابي سفيان

يزيد بن معاوية

معاوية بن يزيد بن ابي سفيان

مروان بن الحكم

عبد الملك بن مروان

الوليد بن عبد الملك

سليمان بن عبد الملك

عمر بن عبد العزيز

يزيد بن عبد الملك بن مروان

هشام بن عبد الملك

الوليد بن يزيد بن عبد الملك

يزيد بن الوليد بن عبد الملك

ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك

مروان بن محمد


الدولة الاموية في الاندلس

احوال الاندلس في الدولة الاموية

امراء الاندلس في الدولة الاموية


الدولة العباسية

الدولة العباسية *


خلفاء الدولة العباسية في المرحلة الاولى

ابو العباس السفاح

ابو جعفر المنصور

المهدي

الهادي

هارون الرشيد

الامين

المأمون

المعتصم

الواثق

المتوكل


خلفاء بني العباس المرحلة الثانية


عصر سيطرة العسكريين الترك

المنتصر بالله

المستعين بالله

المعتزبالله

المهتدي بالله

المعتمد بالله

المعتضد بالله

المكتفي بالله

المقتدر بالله

القاهر بالله

الراضي بالله

المتقي بالله

المستكفي بالله


عصر السيطرة البويهية العسكرية

المطيع لله

الطائع لله

القادر بالله

القائم بامرالله


عصر سيطرة السلاجقة

المقتدي بالله

المستظهر بالله

المسترشد بالله

الراشد بالله

المقتفي لامر الله

المستنجد بالله

المستضيء بامر الله

الناصر لدين الله

الظاهر لدين الله

المستنصر بامر الله

المستعصم بالله

تاريخ اهل البيت (الاثنى عشر) عليهم السلام

شخصيات تاريخية مهمة

تاريخ الأندلس

طرف ونوادر تاريخية


التاريخ الحديث والمعاصر


التاريخ الحديث والمعاصر للعراق

تاريخ العراق أثناء الأحتلال المغولي

تاريخ العراق اثناء الاحتلال العثماني الاول و الثاني

تاريخ الاحتلال الصفوي للعراق

تاريخ العراق اثناء الاحتلال البريطاني والحرب العالمية الاولى

العهد الملكي للعراق

الحرب العالمية الثانية وعودة الاحتلال البريطاني للعراق

قيام الجهورية العراقية

الاحتلال المغولي للبلاد العربية

الاحتلال العثماني للوطن العربي

الاحتلال البريطاني والفرنسي للبلاد العربية

الثورة الصناعية في اوربا


تاريخ الحضارة الأوربية

التاريخ الأوربي القديم و الوسيط

التاريخ الأوربي الحديث والمعاصر
الأعياد الموسمية في معبد ادفو (الزواج المقدس)
المؤلف:
سليم حسن
المصدر:
موسوعة مصر القديمة
الجزء والصفحة:
ج15 ص 218 ــ 228
2025-10-15
32
يعد الزواج المقدس (1) وهو آخر الأعياد الكبيرة التي سنفحصها هنا من وجوه عدة، وهو أعظم هذه الأعياد من حيث التشويق والأهمية، وهذا العيد كان شعبيًّا في أصله إلى درجة عظيمة أكثر من الأعياد التي وصفناها فعلًا؛ وذلك لأن جزءًا كبيرًا من الأحفال كان يحدث خارج جدران المعبد كما كان — بدرجة مختلفة — له أثره ومكانته في نفوس كل شعب الوجه القبلي من «دندرة» حتى «الفنتين».
وكان هذا العيد يُحتَفل به في «إدفو» من أول يوم من الشهر القمري في الشهر الثالث من فصل الصيف (وهو الشهر الحادي عشر من السنة) وينتهي في اليوم الذي يبلغ فيه القمر التمام؛ أي إنه كان يمكث مدة خمسة عشر يومًا، وعلى أية حال كانت تبتدئ التجهيزات الأولية فعلًا قبل الاحتفال بأربعة عشر يومًا (2) في درندة، وذلك عندما كانت الإلهة حتحور «تركب» سفينتها العظيمة ويسير بها موكبها في عرض النهر، وبعد ذلك كانت ترسو عند «إدفو»، وهناك كانت تدق أوتادها في وسط أسطول عظيم من القوارب التي كانت تحمل الكهنة والأتقياء من عبادها. هذا، وكان الموكب يقف في طريقه عند طيبة حيث كانت تزور الإلهة «موت» ربة «أشرو» و«كومير» الواقعة بين «أسنا» و«هيراكونبوليس» قبالة الكاب الحالية، ومن الجائز أنها كانت تقف في أماكن أخرى — وإن كان ذلك لم يذكر — ومن السهل علينا أن نتخيل أنه عندما كان الموكب الوضَّاء يتقدم ببطء فإن ذلك كان يثير أحاسيس النظارة فيرقصون ويمرحون برؤيته، وهم وقوف على شاطئ النهر، ولا نزاع في أن مدة العيد كانت فترة سلام وأفراح، فكان سكان إدفو في ابتهاج يصيحون سرورًا حتى عنان السماء … وماء الفيضان العظيم قد سكن ثائره، والنيل يفرح مهدئًا أولئك الذين في الماء في حين أن التماسيح قد هدأت كلها، ولم يكن في مقدور واحد منها أن يَثِب من الماء (3).
وكان الموكب يصل عند المرسى الواقعة شمال إدفو في الساعة الثامنة نهارًا في يوم القمر الجديد، وهناك قابل حتحور «حور بحدت» وأتباعه ووفد من «الفنتين»، وبعد ذلك نزلت «حتحور» من سفينتها، وسارت مع «حور» إلى معبد قريب، وهناك أقيمت أحفال مختلفة أهمها حفل فتح الفم، وتقديم قربات من باكورة فاكهة الحقل، وتقديم الحقل، وحفل «سوق العجول» وتقديم رمز الصدق وقربات طعام عدة، وبعد ذلك ركب الآلهة سفنهم، ثم أقلعوا مع عمدة «كومير» و«هيراكنبوليس» و«الفنتين» وجم غفير من الحجاج إلى «إدفو» في قناة على ما يظن، ودخلوا في النيل عند «أتبو» إلى مكان على مقربة جدًّا من المعبد، وفي أثناء الطريق وقف الموكب عند مكان يدعى «تل جب» حيث أقيمت أحفال أخرى تشمل حفل «فتح فم» آخر، وتقديم قربات محروقة، ثم استأنف الموكب طريقه، وفي النهاية وصلت القوارب إلى «إدفو»، وعندئذ دخل «حور» وزوجه حرم المعبد من الباب الشرقي في الحرم المصنوع في الجدار المبني باللبنات، وبذلك اجتازوا الحرم، ودخلوا الردهة الأمامية من الباب الواقع في ركنه الجنوبي الشرقي B، وبهذا تمت أحفال اليوم، وقد كان هذا هو الزواج الحقيقي، وقد أمضى «حور» و«حتحور» ليلة زواجهما في المحراب.
وفي صباح اليوم التالي — وهو اليوم الثاني من الشهر القمري — حدث تغيُّر يدل على دهاء؛ فلم يظهر أي تأكيد على موضوع الزواج الذي لم يأت ذكره، بل نقرأ بدلًا من ذلك عن «عيد بحدت» مدة أربعة عشر يومًا يبتدئ في هذا اليوم، وقد تألف الموكب، وكان على رأسه خمس الحراب المقدسة، وكل الوفود الزائرين وكهنة، وبلا نزاع كان معظم أهل البلد يتبعونهم، وسلك الكل طريقهم من المعبد مجتازين الصحراء حتى أرض دفن «بحدت» التي تقع على مسافة إلى الغرب أو الجنوب الغربي، وهناك وقفوا عند المعبد العالي فضلًا عن قربات الخبز والجعة والثيران والطيور، وكل شيء طيب، وضحايا محروقة كثيرة، وإنشاد الأناشيد لتقديم القربات السائلة للأرواح المقدسة، واحتفال دوس القبر.
وبعد ذلك اندفع كل الناس لإقامة الأفراح لمدة من الزمن، وبعد ذلك غادر الموكب المعبد العالي، وانطلق في طريقه إلى قاعة «بيت الحياة» وهو مبنى لا يُعرَف موقعه، ولكن يُحتَمل أنه كان من المباني التابعة للمعبد الرئيسي، وهنا أقيمت سلسلة شعائر غاية في التعقيد، وأهم مفرداتها هي ذبح تيس أحمر ووعل أحمر (اللون الأحمر يدل على الشر، وهو لون يجلب سوء الحظ؛ لأنه لون الإله ست) وكميات غزيرة من القربات من كل وصف، وكذلك أطلق أربع أوزات إلى جهات العالم الأربع، وكل واحدة منها تحمل الرسالة التالية لآلهة الجهات الأربع المختصة لكل:
إن ملك الوجه القبلي والوجه البحري «حور البحدتى» رب السماء قد استولى لنفسه على التاج الأبيض، وتسلم التاج الأحمر.
وبعد ذلك أخذ كاهن يدعى «ابنه المحبوب» قوسًا وفوقه نحو الجنوب والشمال والغرب والشرق.
هذا، ونجد أن طبيعة الشعائر التي تلت قد تغيرت، وأصبحت أكثر مقاومة للمرض؛ فقد أُحضِر فرس بحر مصنوع من الشمع الأحمر منقوش عليه أسماء الأعداء، ثم دونت أسماء أعداء الملك على إضمامة من البردي، وصُنِع فرس بحر من الرمل، وعمل لها كل شيء مؤذٍ، وبعد ذلك أُدِّيَت أحفال دوس السمك، ودوس عدو الملك، ووطئه بالأقدام، والطعن بالسيف، وهذه الأحفال قد تُبِعت بعد ذلك بترجمة فسَّرت بوضوح أن كل هذه كانت رموزًا للأعداء التي قضى عليها بهذه الكيفية، وفي هذا الوقت كان المساء قد حلَّ، وبعد الشراب في الحضرة الإلهية انسحبت الآلهة، واستسلم الناس لليلة طافحة بالمسرات حول المعبد (4).
والأحفال التي أقيمت من اليوم الثاني حتى اليوم الرابع من «عيد بحدت» كانت على وجه التقريب مماثلة لأحفال اليوم الأول عدا أنه في كل من الأحفال الرئيسية التي كانت تقام عند المعبد العالي كانت تقع عند تلٍّ مختلف، ومن اليوم الخامس حتى اليوم الثالث عشر من أيام العيد نجد أن التفاصيل عنها ضئيلة للغاية، ولكن بقدر ما يمكن الإنسان أن يجمعه من معلومات كانت الأحفال تقام على نطاق ضيق جدًّا، فلم يظهر هناك أي موكب للجبَّانة(5)، وكل الأحفال الدينية يظهر أنها كانت تؤدى كلها داخل المعبد، وأخيرًا في يوم تمام القمر، وهو اليوم الرابع عشر من عيد «بحدت» كان الوقت قد حل لرجوع «حتحور» إلى «دندرة».
وقد سار في ركابها الناس بنفس الأبهة التي وصلت بها حتى معبد أو مقصورة «أتبو» وهناك أقيم لها احتفال وداع عظيم فعُمِل لها احتفال «فتح الفم» وقدمت القربات، وسار نواتي مركب حور أمامها، وأدى حفل دوس القبر مرة أخرى، وتُلِيت عبادة الخطاف المقدس، وأخيرًا ركبت «حتحور» سفينتها، وأقلعت بها تتهادى نحو الشمال إلى «دندرة».
والوصف السابق يعد أبسط مجمل لأحفال هذا العيد التي تُعتَبر غاية في التعقيد، وهي التي ذكرتها لنا المتون بقليل من التفصيلات، وعلى أية حال ظهر عدد من النقاط غاية في الأهمية؛ فمن الواضح أن هذا العيد لم يكن وحدة قائمة بذاتها، كما أن أقسامه الواضحة تنحصر في قسمين رئيسيين؛ وهما الزواج المقدس الذي حدث في اليوم الأول، وبعبارة أدق الذي حدث بعد ظهر اليوم الأول وفي المساء من نفس اليوم، وعيد بحدت الذي جاء على أعقابه ينقسم كذلك قسمين؛ الأول: مكث أربعة أيام، والثاني: عشرة أيام.
ولكن هناك أكثر من ذلك؛ وذلك أن الميزة البارزة في الأحفال هي التأكيد على إبراز الأحفال التي يحتويها، وكل ما هو معروف الآن في الواقع هو عبارة عن شعائر خاصة بعيد الحصاد مثل شعيرة تقديم باكورة الفاكهة، وقربات الحقل، وسوق العجول، ودوس القبر، وطلق الأوز إلى الجهات الأربع، وكلها مميزات معروفة تمامًا لعيد الحصاد، وحتى دوس العدو تحت الأقدام موجود بوضوح، وهو ممثل في نثر الحَب ودوسه تحت الأقدام عند عيد الحصاد غير أنه تظهر نقطة غريبة؛ وذلك أنه عندما نعتبر عيد الحصاد بأنه احتفال يقع مباشرة قبل حصد المحصول، وأن تاريخه التقليدي هو الشهر الأول من فصل الصيف (6)، وحتى عندما تكون السنة والتقويم متفقين معًا فإن الشهر الثالث من فصل الصيف يكون قد اشتمل شهر مايو ويونيو عندنا، وذلك بعد الحصاد بكثير؛ لأن الحصاد يحدث في شهر أبريل في الوجه القبلي، ولكن في الوقت الذي كان قد دوِّن فيه متن العيد الذي نحن بصدده وهو الشهر الثالث من فصل الصيف؛ قد جاء متأخرًا في السنة.
ويحتمل أن ذلك كان من يوليو لأغسطس، وهما شهران يأتيان بعد الحصاد والدرس في مصر، وذلك عندما يكون النيل في فيضانه فعلًا، وليس هناك من شك أن الزواج المقدس في «إدفو» كان في الأصل عيد حصاد، وهو في الحقيقة عيد الشهر الأول من الصيف، ولكنه عيد حصاد قد تمَّ في غير فصله المناسب (بسبب عدم الحساب بالسنة الشمسية المضبوطة التي تحتوي على يومًا).
ولكن هناك ما هو أكثر من ذلك؛ فمن المعلوم جيدًا أن أعياد الحصاد هذه كانت قد أصبحت بسرعة أوزيرية الصبغة، وبذلك أصبحت أعيادًا جنائزية، وهذا واضح بجلاء في إدفو، ونعلم أن الزيارة للمعبد العلوي كانت لزيارة جبَّانة مقدسة؛ حيث دفنت الأرواح المقدسة التي كانت تقدم لها القربات أثناء انعقاد العيد، وهذه الأرواح المقدسة كانت من المسلَّم به هي الآلهة الأجداد لمدينة إدفو، ولدينا سلسلة (7) طويلة من المتون خاصة جميعها بهؤلاء الآلهة، وعلاقتهم بهذا العيد الخاص، فهي تحدثنا بأنهم كانوا تسعة آلهة، ثم تذكر أسماءهم، وتحدثنا أن الزيارة السنوية التي كانت تقوم بها حتحور للإله حور قد جلبت لهؤلاء الآلهة حياة ونورًا.
وعلى ذلك فمن البديهي أن هذا الزواج المقدس كان عيدًا مركبًا جدًّا، فالزواج نفسه يعد جزءًا وثيق الصلة بالحصاد، وذلك لأنه يضمن الخصب وكثرة المحصول، وفي «إدفو» نجد أنه قد اتَّحد دون مِراء مع شعائر الحصاد، ومع عبادة الأجداد، وأنه أصبح المثال المصري الكامل للنموذج المثالي لعالم الإنثروبولوجيا للزواج المقدس المرتبط بشعائر الحصاد، وعبادة الأجداد.
والآن بعد أن ألقينا نظرة عامة سريعة على النشاط الذي يحدث في المعبد خلال سنة كاملة، فقد أصبح من الطبيعي بعد ذلك أن نسائل أنفسنا: كيف كان مسلك رجال الدين أمام هذا النشاط المتعدد النواحي؟ وبأية روح كانوا يقومون بأداء واجباتهم؟ والواقع أن نقوش المعبد المصري لم تكن قط شخصية فلم تُحدِّثنا قط في عبارات مدونة عن شعور الكهنة ورد الفعل عندهم، ولكن لدينا على بعض أبواب المعبد خطابات موجهة من الكهنة للداخلين في المعبد، وهي تلقي بعض الضوء على السؤال السابق.
وقد جمع كل هذه الخطابات الأثري «الليو» وترجمها (8)، وسنورد منها هنا اقتباسين: فعلى أحد الأبواب مثلًا نقرأ:
إن كل فرد يدخل من هذا الباب عليه أن يحذر من أن يدخل نجسًا؛ لأن الإله يحب الطهارة أكثر من ملايين الممتلكات، وأكثر من مئات الآلاف من الذهب النضار. فطعامه الصدق، وإنه راضٍ به، وقلبه مسرور بالطهارة العظيمة (9).
وفي متن آخر يقول الكاهن:
ولوا وجوهكم شطر هذا المعبد الذي وضعكم فيه جلالته، فهو يسيح في السماوات في حين أنه يرى ما يجري فيه، وإنه لمسرور بذلك على حسب كماله. لا تدخلوه مذنبين، ولا تدخلوا فيه أنجاسًا، ولا تنطقوا مَيْنًا في بيته، ولا تطمعوا في أشياء، ولا تسبوا، ولا تقْبَلوا رشوة، ولا تكونوا متحيزين بين رجل فقير ورجل عظيم، ولا تُخْسِروا الميزان والمِكْيال، ولا تلحقوا أضرارًا بحاجيات عين رع (القربان المقدسة) ولا تفشوا أسرار ما رأيتم في المعبد، ولا تمدوا أيديكم إلى أمتعة بيته، ولا تخاطروا بالاستيلاء على متاعه. احذروا فوق ذلك من قولكم غبيا! في القلب، وذلك لأن الإنسان يعيش على فيض الآلهة، والفيض هو ما يسميه الإنسان ما يأتي من مائدة القربان بعد إعادة القربان الإلهية التي كانت عليها (أي على موائد القربان). تأمل فإنه (أي الإله) سواء يسبح في السماوات، أو يجتاز العالم السفلي فإن عيناه مثبتتان بقوة على ممتلكاته في أماكنها الحقة (10).
على أنه في استطاعة الرجل الساخر الهازئ بما أوردنا هنا أن يعلق بقوله إذا كانت أمثال هذه التحذيرات ضرورية، فإن هؤلاء الكهنة لا بد أنهم كانوا قد سقطوا في هوة سحيقة بعيدة عن المثل العليا، ولكن على أية حال لا بد من الاعتراف هنا بأنه كان يوجد كهنة أشرار بعيدون عن سبيل الفضيلة، ومع ذلك فأهم من مثل هذه الاعتبارات هو وجود المثل الأعلى فيها، وهذه المتون تضع أمام الكهنة هدفًا ومثالًا أعلى، والواقع لن نكون قد حِدْنا عن جادة الصواب إذ سلَّمنا أنه مع ذلك كان يوجد كهنة قد سعوا بكل إخلاص وتواضع في أن يسلكوا هذا السبيل السوي الذي رسموه.
أما عن الشعب وسلوكه بوجه عام فليس لدينا ما نتحدث به عنه إلا القليل. فمن الواضح أن الأغلبية العظمى من دهماء الناس لم يكن لهم اتصال مباشر بالصلوات اليومية التي كانت تقام في المعبد، أو بالكثير من مختلف العبادات. يضاف إلى ذلك أن الشعب لم يشترك في إقامة أية شعائر خاصة أو مقدسة.
وكل ما نعرفه هو أنه في بعض المناسبات، كعيد تتويج الصقر المقدس وعيد النصر، نرى أنه من المعقول أن نسلِّم أن بعض أشراف المديريات، ويُحتَمل كذلك أعضاء من جماعات المعبد غير طائفة الكهنة كان يُسْمح لهم بالدخول في حرم المعبد، ومن الجائز أنه كان يصرَّح لهم بالدخول في ردهة المعبد الأمامية، ومن ثَم نفهم أنه لم يكن مسموحًا لأي فرد من غير الكهنة بالتوغل في داخل المعبد أكثر من ذلك.
أما رجل الشارع العادي فكان عليه أن يقنع بمعرفة أن هذه الشعائر السرية كانت تقام في داخل المعبد لمنفعته ومصلحته العظمى وحسب، وعلى أية حال كان في مقدوره أن يسهم في الأعياد والمواكب المطبوعة بالطابع الشعبي، فيتمتع بالوجبات المجانية التي كانت تقدم له، وينعم بالأفراح التي كانت دائمًا تصحب مثل هذه الأعياد.
وتدل شواهد الأحوال على أن الشعب كان يتمتع بمثل هذه الملاذ بشهوة، فقد وجدنا ذلك مسجلًا على جدران المعبد أكثر من مرة، والاقتباس التالي يضع أمامنا وصفًا للأفراح العامة في أحد الأعياد، ويعتبر نموذجًا لما كان يجري في تلك الفترة من تاريخ البلاد (11).
إنه يقف قبالة مدينته، ويرى معبده، وقد أثرى بكل مئونة، ومدينته في عيد وقلبه متهلل بالفرح، وكل أزقتها في سرور … مُؤَنها يفوق عددها عدد رمال الشاطئ؛ فكل أنواع الخير فيها بكثرة مثل عدد حبات الرمل، والثيران ذوات القرن الطويل وذوات القرن القصير أكثر عددًا من أرجال الجراد، وفيها بِركة طير لأجل الطيور، والغزال والوضيحى والوعل وما شابهها يبلغ دخانها عنان السماء (أي الدخان المنبعث من طهيها)، وعين حور الخضراء (كناية عن النبيذ) تجري في ربوعها كالفيضان عندما ينبع من كهفيه (عند أسوان)، وبخور المر على موقده مع البخور تُشَم رائحته على بعد ميل، وإنها (أي المدينة) موشاة بالقاشاني المتلألئ بالنطرون، وهي مكللة بالأزهار والأعشاب النضرة، في حين أن الكهنة خدمة الإله والكهنة آباء الآلهة كانوا مرتدين ملابس جميلة من الكتان، وحاشية الملك قد ارتدوا شعاراتهم، وشبانها سكارى ومواطنوها مبتهجون، وشباتها العذارى يروق النظر إليهن، والفرح شامل، والأعياد في كل الربوع، ولا نوم فيها حتى مطلع الفجر.
ولا يجب علينا — على أية حال — أن نفكر في أن اتصال الرجل العادي بربه ومعبده كان اتصالًا الغرض منه الخلاعة والانغماس في اللذات؛ وذلك لأنه على الرغم من أنه لم يكن مسموحًا له دخول المعبد، فإن المعبد والصلوات التي كانت تقام فيه وإلهه المعبود كانت كلها أمورًا حقيقية في نظر الكثير، كما كانت ضرورية لهم.
فلدينا سلسلة متون منقوشة على البوابة الجنوبية لحرم المعبد تبرهن لنا على أن هذا الاعتقاد في الإله كان موجودًا فعلًا، وأن مؤنًا كانت تُصنَع لحاجة الناس لإقامة الصلاة، ولتقديم قرباتهم. ففي هذه المتون نقرأ أنه مكان الوقوف لأولئك الذين يملكون والذين لا يملكون (ثروة) ليتعبدوا طلبًا للحياة، ولأجل رب الحياة، أو المكان لسماع ظلامات كل المتظلمين، لأجل أن يفصل بين الصدق والكذب، وأنه المكان العظيم لحماية الفقراء، ولتخليصهم من الأقوياء (12)، ويقول كذلك: إنه المكان الذي في خارجه تقدَّم القربات في كل الأزمان، وتحتوي على كل محصول للخدم.
والمتون التي اقتبسناها هنا تبرهن على أنه خارج البوابة الجنوبية مباشرة من حرم المعبد كان في استطاعة عامة الشعب أن يأتوا إلى هناك في كل وقت للصلاة وللعبادة، ولتقديم ظلاماتهم، وليلتمسوا العدالة، وليضعوا قرباتهم المتواضعة أمام الإله (13). فالمعبد إذن كان وحدة حية، وكان النشاط المنوع الذي يُجرَى في داخل جدرانه يُعمَل للصالح العام، ولم يكن رجل الشارع أعمى بالنسبة لإلهه، ولكن كان ينظر إليه بطريقته المتواضعة بأنه السند والملاذ في وقت الشدة والرجاء (14).
هذه نظرة عابرة على ما جاء في معبد «إدفو» من نقوش دينية، وبخاصة عن عبادة الإله «حور» رب معبد «إدفو»، وكان لا بد من وضع هذا المختصر لأولئك الذين يريدون دراسة عهد البطالمة من الوجهة المصرية البحتة، وهو المرمى الأصلي، والهدف الأساسي في كتابتنا لتاريخ مصر في عهد البطالمة.
ولا نزاع في أن الأجانب الذين كانوا يقطنون وادي النيل في تلك المدة كانوا لا يعرفون شيئًا عما كان يجري في داخل المعابد المصرية، كما أن الكهنة — على الأرجح — كانوا لا يسمحون لأحد من هؤلاء الأجانب بالدخول في معابدهم، ولا أدل على ذلك من أن المصريين أنفسهم من غير رجال الدين لم يكن يُسمَح لهم بالدخول في أعماق المعبد، أو حتى الاشتراك في إقامة الصلوات هناك، وقد نوهنا عن ذلك فيما سبق، ومن أجل ذلك لن نكون قد حِدنا عن جادة الصواب إذا قلنا إن العبادات التي كانت تقام داخل المعبد كانت مصرية بحتة لم تشبها أية شائبة أجنبية، وعلى الرغم من أن النقوش تحدثنا أن الملك كان هو الكاهن الأكبر الذي كان عليه أن يقوم بتأدية الشعائر الدينية فإن من المحتمل جدًّا أنه كان لا يحضرها قط أو يفهم منها كلمة واحدة؛ وكل ما في الأمر أنه كان رمزًا للفرعون الذي لم يكن بد من وجوده في مصر حسب السُّنة التي اتبعت منذ أقدم العهود، وكان الملك على أية حال يمثل على جدران المعبد وهو يقدم القرابين، ويرأس الأحفال، ومع ذلك فإنه من الجائز جدًّا أنه لم يره طوال حياته، ولدينا في معبد إدفو عدة مناظر مُثِّل فيها بطليموس الثالث وهو يقوم ببعض العبادات، وتأدية شعائر دينية نذكر منها ما يأتي:
(1) قاعة العُمُد الداخلية: يُشاهد في المدخل من الداخل بطليموس الرابع أمام بطليموس الثالث «إيرجيتيس» و«برنيكي الثانية» زوجه، وذلك في الصف الثالث من الجدار الغربي (110–114) (15).
(2) الدهليز الخارجي: الحجرة الخامسة (165): يُشاهد الملك «بطليموس الرابع» أمام بطليموس الثالث المؤلَّه، ومعه «أرسنوي» (؟) وثالوث «إدفو» وهو يقدم لهم قربانًا، والمنظر على الجدار الشمالي من الحجرة.
(3) على جدران المقصورة رقم 9 من الداخل: يُشاهد «بطليموس الرابع» و«أرسنوي الثالثة» يقدمان القربان لكل من «بطليموس الثالث» و«برنيكي الثانية» وذلك على الجدار الغربي (رقم 200).
(4) المحراب: وكذلك في المحراب يُشاهد «بطليموس الرابع» أمام «بطليموس الثالث» و«برنيكي» (16).
(5) خارج المعبد الأصلي أي على جدار الدهليز من الخارج: هناك متن مؤلف من سطرين ذُكِر فيهما تأسيس المعبد على يد «بطليموس الثالث إيرجيتيس» الأول (17).
(6) الواجهة الخارجية — الجدار الغربي: نقرأ على جدران سور المعبد من الخارج على الجدار الغربي تواريخ ذكرها «بطليموس الحادي عشر» عن بناء المعبد وتزيينه في عهد كل من «بطليموس» الثالث والرابع والخامس والسادس … إلخ.
تعليق: إن أهم ما يلفت النظر في المناظر التي تركها لنا «بطليموس الثالث» في نقوش معبد «إدفو» هو أن اسمه لم يُذكَر فيها بوصفه هو الواضع لها على الرغم من أنه هو الذي أقام البناء الأصلي، ومن ثَم نستنبط أن المعبد لم يُنقَش، ولم يزين في عهده، غير أن ملوك البطالمة الذين أتَوا من بعده لم ينسوا له فضله فذكروا أعماله كما ألَّهوه في أعين الشعب المصري هو وزوجته «برنيكي» وبدهي أن كل ذلك من عمل الكهنة المصريين، ويحق لهم أن يفعلوا ذلك؛ فقد كان من أعظم ملوك البطالمة الذين خلَّفوا وراءهم آثارًا ضخمة عديدة في طول البلاد وعرضها، وهي التي سنستعرضها بقدر ما وصلت إليه معلوماتنا، ويخيَّل إليَّ أن ملوك البطالمة قد أخذوا درسًا مفيدًا من ملوك الأسرة الثلاثين الذين كانوا يتبارون في إقامة المباني الدينية في عهدهم؛ وذلك بعد أن علموا تمام العلم أنه لن يستقر عرش الملك لواحد منهم إلا إذا أقام المباني الدينية الضخمة وأرضى الكهنة بكل ما لديه من قوة وسلطان، وإلا كان مصيره الخلع أو الطرد، وقد تحدثنا عن هذا الموضوع بشيء من التفصيل في الجزء الثالث عشر من هذه الموسوعة (راجع الجزء الثالث عشر).
........................................................
1- Edfu V, 29, 9–32, 16; 124, 8–129, 11; 130, 17–136, 4; 34, 2–35, 3
2- Edfu VII, 26, 9–12.
3- Edfu V, 30, 3–6.
4- Edfu V, 134, 2.
5- J. E. A., 35, 98–112; 36, 63–81.
6- Gauthier. Les fêtse du dieu Min; Frankfort, kingships and the Gods. PP. 188–90
7- Edfu I, 173, 3–174; 382, 4–15, II, 51, 352, 8; IV, 102, 17–103, 13; 239, 13–241; V, 61, 17–63; 160, 12; 162, 6; VII, I, 118, 4–119, 8; 279, 16–281, 2; III, 323, 5–12
8- راجع Alliot Culte I, 181 95; Marriette Dend. I, 15 e; De Morgan Ombos II 245 No. 878.
ولدينا متون مماثلة في دندرة، وكوم امبو.
9- Edfu VI, 349, 4–6.
10- Edfu III, 360, 361, 5.
11- Edfu IV, 3, 1–8.
12- Edfu VIII, 162, 16-17.
13-Edfu VIII. 163. 1-2.
14- Edfu VIII, 164, 11
15- انظر تصميم معبد إدفو شكل 4-1
16- Portr and Moss VI. P. 146
17- Porter and Moss Ibid. P. 157
 الاكثر قراءة في العصور القديمة في مصر
الاكثر قراءة في العصور القديمة في مصر
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية












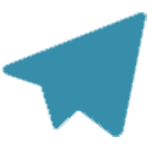
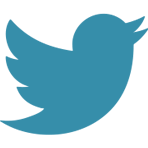

 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)