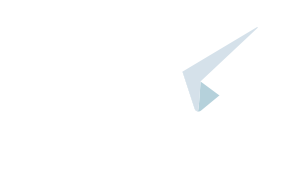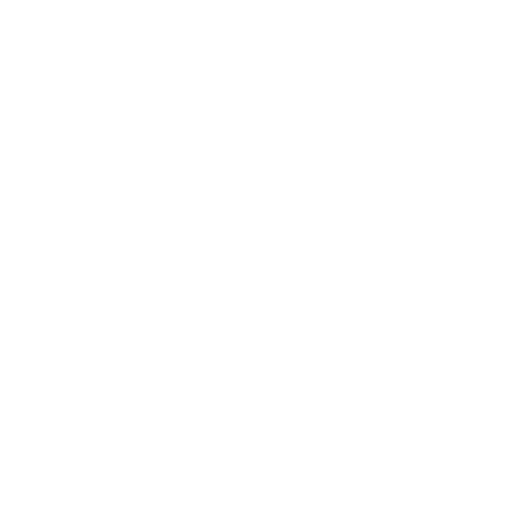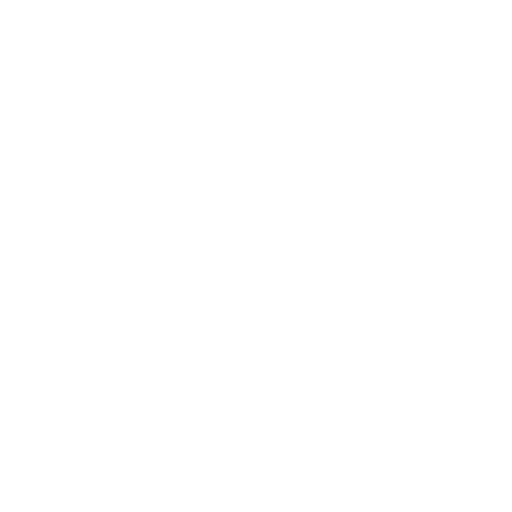التاريخ والحضارة

التاريخ

الحضارة

ابرز المؤرخين


اقوام وادي الرافدين

السومريون

الساميون

اقوام مجهولة


العصور الحجرية

عصر ماقبل التاريخ

العصور الحجرية في العراق

العصور القديمة في مصر

العصور القديمة في الشام

العصور القديمة في العالم

العصر الشبيه بالكتابي

العصر الحجري المعدني

العصر البابلي القديم

عصر فجر السلالات


الامبراطوريات والدول القديمة في العراق

الاراميون

الاشوريون

الاكديون

بابل

لكش

سلالة اور


العهود الاجنبية القديمة في العراق

الاخمينيون

المقدونيون

السلوقيون

الفرثيون

الساسانيون


احوال العرب قبل الاسلام

عرب قبل الاسلام

ايام العرب قبل الاسلام


مدن عربية قديمة

الحضر

الحميريون

الغساسنة

المعينيون

المناذرة

اليمن

بطرا والانباط

تدمر

حضرموت

سبأ

قتبان

كندة

مكة


التاريخ الاسلامي


السيرة النبوية

سيرة النبي (صلى الله عليه وآله) قبل الاسلام

سيرة النبي (صلى الله عليه وآله) بعد الاسلام


الخلفاء الاربعة

ابو بكر بن ابي قحافة

عمربن الخطاب

عثمان بن عفان


علي ابن ابي طالب (عليه السلام)

الامام علي (عليه السلام)

اصحاب الامام علي (عليه السلام)


الدولة الاموية

الدولة الاموية *


الدولة الاموية في الشام

معاوية بن ابي سفيان

يزيد بن معاوية

معاوية بن يزيد بن ابي سفيان

مروان بن الحكم

عبد الملك بن مروان

الوليد بن عبد الملك

سليمان بن عبد الملك

عمر بن عبد العزيز

يزيد بن عبد الملك بن مروان

هشام بن عبد الملك

الوليد بن يزيد بن عبد الملك

يزيد بن الوليد بن عبد الملك

ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك

مروان بن محمد


الدولة الاموية في الاندلس

احوال الاندلس في الدولة الاموية

امراء الاندلس في الدولة الاموية


الدولة العباسية

الدولة العباسية *


خلفاء الدولة العباسية في المرحلة الاولى

ابو العباس السفاح

ابو جعفر المنصور

المهدي

الهادي

هارون الرشيد

الامين

المأمون

المعتصم

الواثق

المتوكل


خلفاء بني العباس المرحلة الثانية


عصر سيطرة العسكريين الترك

المنتصر بالله

المستعين بالله

المعتزبالله

المهتدي بالله

المعتمد بالله

المعتضد بالله

المكتفي بالله

المقتدر بالله

القاهر بالله

الراضي بالله

المتقي بالله

المستكفي بالله


عصر السيطرة البويهية العسكرية

المطيع لله

الطائع لله

القادر بالله

القائم بامرالله


عصر سيطرة السلاجقة

المقتدي بالله

المستظهر بالله

المسترشد بالله

الراشد بالله

المقتفي لامر الله

المستنجد بالله

المستضيء بامر الله

الناصر لدين الله

الظاهر لدين الله

المستنصر بامر الله

المستعصم بالله

تاريخ اهل البيت (الاثنى عشر) عليهم السلام

شخصيات تاريخية مهمة

تاريخ الأندلس

طرف ونوادر تاريخية


التاريخ الحديث والمعاصر


التاريخ الحديث والمعاصر للعراق

تاريخ العراق أثناء الأحتلال المغولي

تاريخ العراق اثناء الاحتلال العثماني الاول و الثاني

تاريخ الاحتلال الصفوي للعراق

تاريخ العراق اثناء الاحتلال البريطاني والحرب العالمية الاولى

العهد الملكي للعراق

الحرب العالمية الثانية وعودة الاحتلال البريطاني للعراق

قيام الجهورية العراقية

الاحتلال المغولي للبلاد العربية

الاحتلال العثماني للوطن العربي

الاحتلال البريطاني والفرنسي للبلاد العربية

الثورة الصناعية في اوربا


تاريخ الحضارة الأوربية

التاريخ الأوربي القديم و الوسيط

التاريخ الأوربي الحديث والمعاصر
التنازع في شمالي بلاد الشام - ضم حلب
المؤلف:
أ.د. محمد سهيل طقوش
المصدر:
تاريخ السلاجقة في خراسان وإيران والعراق
الجزء والصفحة:
ص 102 ــ 108
2025-09-12
38
بعد نجاح السلطان ألب أرسلان في فتح أرمينية، وأضحى الطريق أمامه مفتوحاً للعبور إلى شمالي بلاد الشام والأناضول، هاجم في عام (458 هـ / 1065م) القلاع البيزنطية في الرها (1) وأنطاكية (2).
وأغارت جماعة من الغز على المناطق الحدودية في الأناضول فاستولوا على دروب الأمانوس في عام (459هـ / 1066م)، وهاجموا قيصيرية (3)، حاضرة كبادوكيا في العام التالي، ووصلوا إلى نيكسار (4) وعمورية (5) وقونية وخونية، القريبة من ساحل بحر إيجه. وفي عام (461هـ / 1068م) استسلمت بلاد الكرج للسلطان واستطاع إخضاع بني شداد في حرَّان (6)، وبني عقيل في الموصل، لنفوذه، وجعلهم موالين له، وفي أوائل عام (462 هـ / 1070م) انتزع أرجيش وملازكرد من بيزنطية، ثم عبر الفرات متوجهاً إلى حلب.
والواقع أنه كان من الصعب على السلطان السلجوقي، من الناحيتين السياسية والعسكرية، أن يتجاوز محور الرها إلى جنوبي بلاد الشام، ثم مصر من دون تقدير الموقف البيزنطي من جهة ومواقف أمراء الجزيرة وبلاد الشام من جهة أخرى؛ لأن أي اضطراب في العلاقة هذه الأطراف من شأنه أن يُهدِّد بقطع خط الرجعة على مع جيشه الذي سيكون بعيداً عن قواعده الخلفية.
واشتدت في هذه الأثناء غارات الأتراك على أراضي الدولة البيزنطية منطلقين من حلب، وتوغلوا فيها، ففتح هارون بن خان أرتاح (7) في (27 رمضان 460هـ/ أول تموز 1068م)، بعد أن حاصرها خمسة أشهر (8).
نهض الامبراطور البيزنطي رومانوس الرابع ديوجينوس (460 - 463هـ / 1068 - 1071م)، الذي خلف قسطنطين العاشر دوكاس، ليوقف تقدم المغيرين ومنعهم من التوغل أكثر في عمق الأراضي البيزنطية مدركاً أن سلامة الامبراطورية تقضي باسترداد أرمينية، فبذل جهداً كبيراً في حشد جيش من أجل هذه الغاية، وقام بثلاث حملات عسكرية ضد بلاد الشام وأعالي الجزيرة الفراتية في الأعوام (461 - 463 هـ / 1069 - 1071م).
توجهت الحملة الأولى إلى إمارة حلب الواقعة تحت الحكم المرداسي (9)، واستناداً إلى ما ذكره المؤرخ والفيلسوف البيزنطي بسللوس، الذي عاش هذه الأحداث وشارك فيها وإن شاب حديثه كثير من التحامل على الامبراطور، أن رومانوس الرابع خرج من عاصمته بصحبة جيشه وزحف ضد البرابرة (الأتراك) من دون تخطيط مسبق لا يعرف أين سيمضي أو ماذا يفعل يُخطط ليمضي في طريق يسير في طريق آخر، توغل في أراضي الشام وكل ما حققه من نجاح كان فقط قيادة جيشه داخل هذه الأراضي مكتفياً بأنه زحف ضد العدو (10).
الواقع أن رومانوس الرابع اعترض، أثناء حملته هذه جماعة من الأتراك كانت قد هاجمت نيكسار، وأرغمها على أن تتخلى عن الغنائم التي ظفرت بها، بالإضافة إلى أنه شنَّ بعض الغارات على إمارة حلب واستولى على أرتاح الواقعة شرقي أنطاكية، وترك فيها حامية عسكرية، كما استولى على حصن بالس (11)، ثم انسحب المنطقة إثر ورود أخبار عن تقدم قوة من الأتراك بقيادة الأفشين باتجاه عمورية، والجدير بالذكر أن السلطان ألب أرسلان أرسل قائده الأفشين على رأس قوة عسكرية للتوغل داخل أملاك الامبراطورية. وغزا رومانوس الرابع إمارة حلب أيضاً في حملته الثانية انطلاقاً من أراضي إقليم الجزيرة الفراتية، فسلك طريق سيواس - قيصرية للوصول إلى مرعش (12) على الحدود بين بلاد الشام ومنطقة كيليكيا، ثم تابع طريقه إلى منبج (13) الواقعة على الضفة الغربية لنهر الفرات فنهبها وقتل أهلها وضمها إلى أملاك الامبراطورية، واصطدمت قواته بقوات محمود بن صالح المرداسي وبني كلاب وابن حسان الطائي، ومن معهم من جموع العرب وانتصرت عليهم (14).
الواضح أن رومانوس الرابع حقَّق بعض أمانيه في أطراف بلاد الشام، فحد من تحركات الأتراك، بل إنه تابع مهماته العسكرية فوصل إلى ملازكرد وعاث في أطرافها وأطراف خراسان، ثم انسحب من المنطقة عائداً إلى بلاده بسبب المؤن (15)
لم يكن لهاتين الحملتين نتائج خطيرة، ولم ينجم عنهما أي تغيير في وضع الأراضي باستثناء الاستيلاء على أرتاح ومنبج وبالس، وما أحرزه الامبراطور من انتصارات جزئية لم يكن حاسماً بدليل مواصلة الأتراك ضغطهم على أراضي الامبراطورية وتوغلهم في أرجائها ما اضطره إلى القيام بحملته الثالثة لوضع حد لتعدياتهم. (16)
لم يسع رومانوس الرابع، بعد عودته إلى عاصمته من حروب الشام، إلا أن يعود أدراجه لمواجهة السلاجقة وإخراجهم من المناطق التي استقروا فيها، وبخاصة حول قيصرية وكبادوكيا بالإضافة إلى السيطرة على بعض المواقع داخل الأراضي الإسلامية ليشحنها بالجند ويتخذها مراكز أمامية تواجه كل تحرك تركي في المستقبل، فترك قسماً من جيشه بالقرب من ملطية تحت قيادة فيلاريت الأرمني، وأمره أن يعترض سبيل الأتراك، غير أن هؤلاء استطاعوا إنزال الهزيمة به وفتحوا ملطية وانسابت جموعهم إلى قلب آسيا الصغرى، ونهبوا قونية، سمع الامبراطور البيزنطي بما أصاب هذه المدينة تابع تقدمه ليوقف زحف المغيرين إلا أنه لم يكن بوسعه أن يهزمهم، فعاد إلى القسطنطينية في عام (463 هـ / 1071م) لتجهيز جيش آخر عهد بقيادته إلى مانويل كومنين، ولم يكن هذا الجيش بأفضل ممن سبقه، إذ أنزل السلاجقة الهزيمة بالقائد البيزنطي قرب سيواس وأسروه (17).
وعلى الرغم من أن توغل الأتراك في الأناضول كان يُهدد النظام البيزنطي من الداخل، إلا أن الخطر الحقيقي جاء من الشرق من خراسان، وكان لذلك علاقة بالمدى الذي وصلت إليه أوضاع الدولة الفاطمية في مصر من تدهور، وكان السلطان ألب أرسلان ينتظر فرصة سانحة ليُحقق حلمه بضم بلاد الشام ومصر إلى الأملاك السلجوقية وأتاح له النزاع الذي حصل بين أركان الحكم في مصر من أجل السيطرة والتسلط على المستنصر الفاطمي، هذه الفرصة.
كان ناصر الدولة الحسين بن الحسن الحمداني أحد أبرز القادة، في القاهرة قد انتصر على تحالف ضمَّ الوزير ابن أبي كدية وقائد عسكر الأتراك الدكوز، وذلك في عام (462 هـ / 1070م)، وتمادى في تخطيطه عندما قرَّر القضاء على الدولة الفاطمية، وإقامة الدعوة للخليفة العباسي، فأرسل أبا جعفر محمد بن البخاري قاضي حلب إلى السلطان السلجوقي بطلب منه أن يُرسل جيشاً إلى مصر يساعده في تحقيق هدفه .
وفور تسلمه الدعوة، جهز السلطان ألب أرسلان جيشاً كبيراً وخرج على رأسه من خراسان متوجهاً إلى بلاد الشام لإخضاعها لسيطرة السلاجقة، ومن ثم متابعة زحفه إلى مصر لإسقاط الدولة الفاطمية، وضم هذا البلد إلى السلطنة السلجوقية، لكن تحركه كان بطيئاً بسبب ما صادفه من عقبات كانت أولاها في الرها الواقعة تحت الحكم البيزنطي، فحاصرها في أوائل (463هـ / أواخر 1070م). قاوم الرهاويون الحصار ببسالة بقيادة باسيل بن أسار، حاكم المدينة، واضطر السلطان إلى التفاهم السكان بعد نيف وثلاثين يوماً من الحصار والضرب المتواصل، ثم تابع طريقه إلى حلب (18) لضمها حتى يمنع أي محاولة التفاف من جانب البيزنطيين من جهة الجنوب، غير أن قسماً من جيشه تقاعس عن المضي تأخير أرزاقهم، فاضطر أن يتابع زحفه بمن بقي معه من الجيش وعددهم أربعة آلاف مقاتل، فعبر نهر الفرات في (14 ربيع الآخر 463 هـ / كانون الثاني (1071م) ودخل أراضي الإمارة، وقدَّم له جميع أمراء الجزيرة الفراتية الولاء، أمثال شرف الدولة مسلم بن قريش العقيلي أمير الموصل، ونصر بن مروان أمير ميافارقين وابن وثاب، أمير حران بالإضافة إلى أمراء الترك والديلم (19).
وتقاعس محمود بن نصر المرداسي أمير حلب عن تقديم الولاء للسلطان السلجوقي، ويبدو أن لذلك علاقة بالمدى الذي وصلت إليه معارضة الشيعة في المدينة لإعادة مذهب أهل السنة، وربما أدرك أنه سيفقد استقلاله إذا تجاوب مع مطالب السلطان السلجوقي فأرسل إليه السلطان القاضي أبا جعفر محمد بن البخاري يدعوه للقدوم إليه لتقديم الولاء والطاعة ودوس بساطه أسوة بسائر أمراء الجزيرة الفراتية، وفتح أبواب حلب لاستقباله (20)، لكن محموداً رفض الدعوة بتحريض من ابن خان أحد القادة الأتراك، وآثر الاعتصام بحلب والدفاع عنها، واستنفر الرجال من جميع أنحاء بلاد الشام، وتأهب لمقاومة الحصار الذي سوف يفرضه الجيش السلجوقي على المدينة، ويبدو أنه اطمأن إلى أن ولاءه للعباسيين
وللسلطان السلجوقي وارتداء خلع الخليفة، التي أرسلت إليه في عام (462هـ/ 1070م)، كافيان لحمايته من هجوم السلطان لكنه فوجئ بوصوله إلى حلب في (أواخر جمادى الآخرة 463هـ / أوائل نيسان 1071م) وضَرْبه الحصار عليها، واتخذ السلطان من الفنيدق (21) مركزاً لقيادته وكانت الخيام والعساكر من حلب إلى نقرة بني أسد إلى عزاز إلى الأثارب متقاربة بعضها من بعض ولم يتعرض أحد من العسكر بمال أحد ولا سبيت حَرمة ولا قاتل حصناً، ولم يأخذ عليقة تبن من فلاح إلا بثمنه. استمر الحصار مدة شهر ويومين ولم يجر قتال غير يوم واحد وكان يقول لأتباعه: أخشى أن أفتح هذا الثغر بالسيف فيصير إلى الروم (22).
ومهما يكن من أمر، فقد فشل السلطان في اقتحام المدينة، ولعل مرد ذلك يعود إلى شدة المقاومة ومتانة الأسوار وإشراك محمود بن نصر جميع القبائل العربية في الدفاع عنها، بالإضافة إلى طبيعة تكوين الجيش السلجوقي الذي يعتمد على الفرسان الخفاف، والمعروف أن عمليات الحصار تتطلب جنوداً من المشاة وهو ما افتقده الجيش السلجوقي ولم تتوقف المفاوضات خلال أيام الحصار للوصول إلى حل، لكن من دون جدوى بسبب التصلب في المواقف واضطر السلطان أخيراً إلى فك الحصار عن المدينة، إلا أنه خشي على سمعته بعد إخفاقه في اقتحام الرها وأخذ حلب، ما ينعكس سلباً على دولته الناشئة وبخاصة بعد ورود أنباء عن ظهور الامبراطور رومانوس الرابع في أرمينية وهو عازم على مهاجمة خراسان(23)، لذلك لجأ إلى السياسة لتفريق الكلابيين وإضعاف موقف محمود بن نصر، فاستدعى جميع أمراء بني كلاب ليختار أميراً منهم يُعينه على حلب ويُفوّضه السعي للاستيلاء على المدينة وانتزاعها من محمود بن نصر على أن يتفرغ هو لمواجهة الخطر البيزنطي(24).
لبي الأمراء دعوة السلطان، وامتثلوا لأمره ويدل ذلك على أن التنازع كان متفشياً بين العشائر الكلابية، وأن محموداً لم يتمكن من جمع شمل القبيلة تحت رايته، وعندما علم محمود بهذا التحول خشي على سلطته في حلب وبخاصة أن البلد قد أشرف على «الفتح»، فتحرك بسرعة باتجاه السلطان، وسعی إلى التوصل إلى مصالحة معه تحفظ ملكه وتفوت الفرصة على خصومه من الأمراء الكلابيين (25).
وإذا كان لنا أن نقوم تصرف الكلابيين، فإنهم أخطأوا، فلم يستغلوا الفرصة التي سنحت لهم للتضامن ومقاومة الخطر السلجوقي فأتاحوا للسلاجقة أن يفرضوا سلطتهم عليهم، وقد يعود ذلك إلى طبيعتهم البدوية وتنافسهم على الزعامة.
ومهما يكن من أمر، فقد خرج محمود بن نصر من حلب متخفياً بزي الأتراك (ليلة الأول من شعبان 463هـ / 4 أيار (1071م بصحبة والدته منيعة بنت وثاب النميري، وتوجه إلى معسكر السلطان، فرحب به هذا الأخير، وجرت بين الرجلين مفاوضات أسفرت عما يلي:
- يخرج محمود بن نصر في اليوم التالي علناً ليزور معسكر السلطان ويدوس بساطه، ويُقدِّم فروض الولاء والطاعة.
- يوافق السلطان على بقاء محمود أميراً على حلب على أن يكون تابعاً له، ويدعو للخليفة العباسي وللسلطان السلجوقي (26).
وفعلا خرج محمود في اليوم التالي من حلب وتوجه إلى معسكر السلطان وحمل معه مفاتيح المدينة، واصطحب معه والدته فاستقبلهما السلطان ورحب بهما وأكرمهما وأحسن إليهما، وثبت محموداً في حكم حلب وكتب له توقيعاً بذلك (27)، فأضحى بموجبه تابعاً فعلياً ورسمياً للسلطان ومتولياً من قبله وبتوقيعه، وليس أميراً حاكماً بقوته الذاتية يستطيع في كل لحظة نقض الولاء (28).
.............................................
(1) الرها مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام بينهما سنة فراسخ الحموي جـ 3 ص 106.
(2) أنطاكية: قصبة العواصم من الثغور الشامية وهي من أعيان البلاد وأمهاتها، بينها وبين حلب وليلة. المصدر نفسه: ج1 ص 266، 267.
(3) قيصرية: مدينة عظيمة في بلاد الروم هي كرسي ملك بني سلجوق ملوك الروم. الحموي: جع ص 421.
(4) نيكسار: إحدى مدن ولاية سيواس تقع حالياً في شمال شرقي تركيا.
(5) عمورية مدينة في بلاد الروم.
(6) حران مدينة عظيمة مشهورة في الجزيرة وهي قصبة ديار مضر بينها وبين الرها يوم، وهي على طريق الموصل والشام والروم. الحموي: جـ 2 ص 235.
(7) ارتاح اسم حصن منيع كان من العواصم من أعمال حلب المصدر نفسه: ص 140.
(8) ابن العديم: ج1 ص 256.
(9) المرداسيون عشيرة عربية أقامت إمارة وراثية في حلب في عهد صالح بن مرداس بدءاً من عام 451هـ ودامت حتى عام 447هـ.
Chronographia: p532. (10)
(11) بالس: بلد بالشام بين حلب والرقة الحموي: ج1 ص328.
(12) مرعش: مدينة في الثغور بين الشام وبلاد الروم المصدر نفسه: جـ 5 ص 107
(13) منبج: مدينة كبيرة واسعة ذات خيرات كثيرة وأرزاق واسعة في فضاء من الأرض، بينها وبين الفرات ثلاثة فراسخ وبينها وبين حلب عشرة فراسخ وجعلها الخليفة العباسي هارون الرشيد مدينة العواصم المصدر نفسه: ص 205، 206.
(14) العظيمي: محمد بن علي: تاريخ حلب ص 347.
(15) ابن القلانسي أبو يعلى حمزة بن أسد: ذيل تاريخ دمشق ص 166. سبط ابن الجوزي،
= شمس الدين بن يوسف بن قزاوغلي: مرآة الزمان في تاريخ الأعيان جـ 8 ص 254.
(16) المصدران نفساهما. 364، 363 psellus: pp
Grousset: P624. (17)
Cahen, CL: Pre Ottoman Turkey, p71.
(18) ابن العبري ص 109. ابن الأثير جـ 8 ص 222. ابن العديم: ج1 ص 261.
(19) ابن العديم المصدر نفسه.
(20) المصدر نفسه ص 261، 262.
(21) الفنيدق من أعمال حلب، ويُعرف الآن بتل السلطان نسبة إلى السلطان ألب أرسلان الحموي: جـ ص 279.
(22) ابن العديم: ج1 ص 262، 263
(23) المصدر نفسه ص 263.
(24) المصدر نفسه.
(25) المصدر نفسه: ص 263، 264.
(26) ابن العديم ج1 ص 264. الحسيني: ص 39.
(27) ابن القلانسي: ص 167. العظيمي: ص 326. الحسيني: ص 37.
(28) ضامن محمد إمارة حلب في عهد السلاجقة: ص 96، 97.
 الاكثر قراءة في التاريخ
الاكثر قراءة في التاريخ
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية












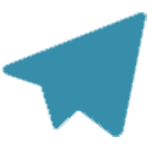
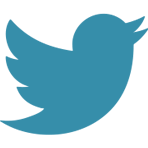

 "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام) قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)
قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)