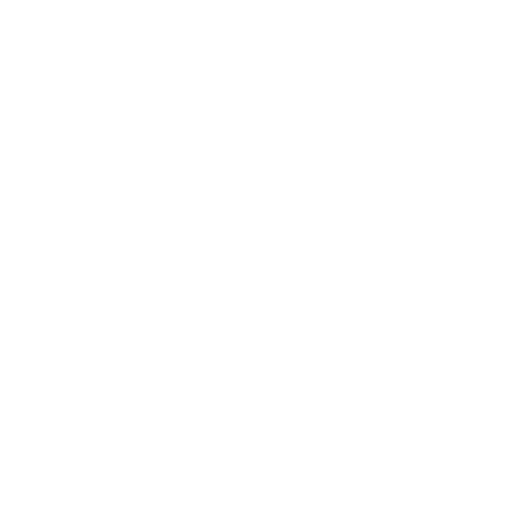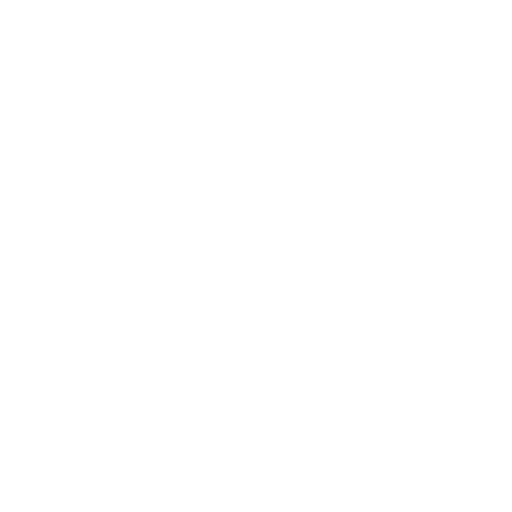التاريخ والحضارة

التاريخ

الحضارة

ابرز المؤرخين


اقوام وادي الرافدين

السومريون

الساميون

اقوام مجهولة


العصور الحجرية

عصر ماقبل التاريخ

العصور الحجرية في العراق

العصور القديمة في مصر

العصور القديمة في الشام

العصور القديمة في العالم

العصر الشبيه بالكتابي

العصر الحجري المعدني

العصر البابلي القديم

عصر فجر السلالات


الامبراطوريات والدول القديمة في العراق

الاراميون

الاشوريون

الاكديون

بابل

لكش

سلالة اور


العهود الاجنبية القديمة في العراق

الاخمينيون

المقدونيون

السلوقيون

الفرثيون

الساسانيون


احوال العرب قبل الاسلام

عرب قبل الاسلام

ايام العرب قبل الاسلام


مدن عربية قديمة

الحضر

الحميريون

الغساسنة

المعينيون

المناذرة

اليمن

بطرا والانباط

تدمر

حضرموت

سبأ

قتبان

كندة

مكة


التاريخ الاسلامي


السيرة النبوية

سيرة النبي (صلى الله عليه وآله) قبل الاسلام

سيرة النبي (صلى الله عليه وآله) بعد الاسلام


الخلفاء الاربعة

ابو بكر بن ابي قحافة

عمربن الخطاب

عثمان بن عفان


علي ابن ابي طالب (عليه السلام)

الامام علي (عليه السلام)

اصحاب الامام علي (عليه السلام)


الدولة الاموية

الدولة الاموية *


الدولة الاموية في الشام

معاوية بن ابي سفيان

يزيد بن معاوية

معاوية بن يزيد بن ابي سفيان

مروان بن الحكم

عبد الملك بن مروان

الوليد بن عبد الملك

سليمان بن عبد الملك

عمر بن عبد العزيز

يزيد بن عبد الملك بن مروان

هشام بن عبد الملك

الوليد بن يزيد بن عبد الملك

يزيد بن الوليد بن عبد الملك

ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك

مروان بن محمد


الدولة الاموية في الاندلس

احوال الاندلس في الدولة الاموية

امراء الاندلس في الدولة الاموية


الدولة العباسية

الدولة العباسية *


خلفاء الدولة العباسية في المرحلة الاولى

ابو العباس السفاح

ابو جعفر المنصور

المهدي

الهادي

هارون الرشيد

الامين

المأمون

المعتصم

الواثق

المتوكل


خلفاء بني العباس المرحلة الثانية


عصر سيطرة العسكريين الترك

المنتصر بالله

المستعين بالله

المعتزبالله

المهتدي بالله

المعتمد بالله

المعتضد بالله

المكتفي بالله

المقتدر بالله

القاهر بالله

الراضي بالله

المتقي بالله

المستكفي بالله


عصر السيطرة البويهية العسكرية

المطيع لله

الطائع لله

القادر بالله

القائم بامرالله


عصر سيطرة السلاجقة

المقتدي بالله

المستظهر بالله

المسترشد بالله

الراشد بالله

المقتفي لامر الله

المستنجد بالله

المستضيء بامر الله

الناصر لدين الله

الظاهر لدين الله

المستنصر بامر الله

المستعصم بالله

تاريخ اهل البيت (الاثنى عشر) عليهم السلام

شخصيات تاريخية مهمة

تاريخ الأندلس

طرف ونوادر تاريخية


التاريخ الحديث والمعاصر


التاريخ الحديث والمعاصر للعراق

تاريخ العراق أثناء الأحتلال المغولي

تاريخ العراق اثناء الاحتلال العثماني الاول و الثاني

تاريخ الاحتلال الصفوي للعراق

تاريخ العراق اثناء الاحتلال البريطاني والحرب العالمية الاولى

العهد الملكي للعراق

الحرب العالمية الثانية وعودة الاحتلال البريطاني للعراق

قيام الجهورية العراقية

الاحتلال المغولي للبلاد العربية

الاحتلال العثماني للوطن العربي

الاحتلال البريطاني والفرنسي للبلاد العربية

الثورة الصناعية في اوربا


تاريخ الحضارة الأوربية

التاريخ الأوربي القديم و الوسيط

التاريخ الأوربي الحديث والمعاصر
مجال حياة (وزاحر رسن)
المؤلف:
سليم حسن
المصدر:
موسوعة مصر القديمة
الجزء والصفحة:
ج13 ص 68 ــ 76
2025-05-24
38
تحدثنا نقوش تمثال «وزاحر رسن» على أن مجال حياته كان مدنيًّا في الأصل؛ فقد كان في عهد الملك «أحمس» الثاني «أمسيس» يشغل وظائف مدنية عالية، ولا نعرف شيئًا عن سُلُوكه مدة احتدام الحرب التي وقعت بين «مصر» والفرس، غير أنه لُوحظ — بعد انتهاء هذه الحروب — أنه كان من بين رجال حاشية الملك «قمبيز».
ولا نزاع في أنه كان يميل — كل الميل — إلى جانب الفرس، وقد كان له تأثيرٌ على نتيجة الحرب التي قام بها الفرس لفتح «مصر»، وبخاصة عندما نذكر أن «وزاحر رسن» كان قائدًا للأسطول المصري في البحر في عهد «بسمتيك» الثالث، فقد وضعه هذا المنصبُ السامي في مكانةٍ خاصة غاية في الأهمية، ومن المحتمل أن الخدمات العظيمة التي أَدَّاها فعلًا لملك الفرس، والتي كان لا يزال يؤديها بعد تقربه من الفرس؛ قد خولت له أن يتوسط لدى «قمبيز» في صالح أسرته وفي صالح مدينته «سايس» مسقط رأسه، كما توسط كذلك لدى الملك لخدمة الآلهة المصرية.
ويدل ما لدينا من نقوشه على أنه قد احتفظ بعددٍ عظيمٍ من ألقابه، وقد نال — فضلًا عن ذلك — ألقابًا جديدة من الفرس، وبخاصة لقب «رئيس الأطباء»، ولا بد أن هذا اللقب كان لقبًا حقيقيًّا لا لقبَ شرفٍ وحسب. أما الوظيفة الهامة التي كان يقوم بأدائها لدى ملك الفرس؛ فهي وظيفة رئيس المراسيم ومُرشد الملك إلى كل العادات المصرية القديمة من دينية واجتماعية، وغير ذلك.
وتُحدثنا النقوش أن «وزاحر رسن» قد سافر بعد وفاة «قمبيز» إلى الخارج؛ أي في عهد الملك «دارا» الأول؛ فقد ذهب إلى «عيلام» ليكون بالقرب من مليكه، ولكن لا نعلم شيئًا قط عن الأحوال التي اقتضتْ هذا السفر.
وقد ذهب المؤرخون مذاهبَ شتى متضاربة في هذا الصدد، ولا حاجة بنا إلى سَردِها هنا؛ فإنها كلها محض حدس ورجم بالغيب.
) راجع:Revillout, Rev. Egypt. I (1880) p. 71; Maspero, Hist. Anc. Des Peuples de l’orient Classique 3, 685: Farina Bibychnis, 18 (1929) 455).
وعلى أية حال نعلم من نقوش «وزاحر رسن» أن العاهل الجديد؛ أي «دارا»، قد أرسله إلى «مصر» في بعث رسميٍّ، كما سنتحدث عن ذلك بعد، وقد كان القيام بتنفيذ هذا الأمر آخرَ عملٍ قام به، جاء في النقوش التي تركها لنا، وقد استغرق حوالي ستة أعوام.
والواقع أن ما جاء في نقوش تمثال «وزاحر رسن» يُعدُّ دفاعًا عن موقفه بالنسبة لبلاده، فقد أراد أن يفهم خلفه بأنه كان جديرًا بكل حمد وثناء من أسرته، ومن مدينته ومن رؤسائه، وبوجه خاص من آلهته، ومما يُلحظ في نقوشه أنه لم يذكر لنا من الوقائع التاريخية إلا التي اشترك فيها هو، وبخاصة عندما تكون هذه الوقائع عونًا له على إظهار تُقاهُ وصلاحُهُ وخدماته لآلهة «سايس» مسقط رأسه.
وإذا كان «قمبيز» لم يُظهر اهتمامَه إلا بمعبد الإلهة «نيت» وإذا كان «وزاحر رسن» قد أظهر نفس الاهتمام بوصفه الساعدَ الأيمنَ لملك الفُرس؛ فإن ذلك كان يرجع — بلا شك — للاختيار الخفيِّ للأمور التي ذكرها لنا صاحبُ التمثال في نقوشه، هذا بالإضافة إلى أنه كان في خدمة أجانب؛ أي في خدمة الفُرس، فكان مدينًا لهم بمركزه الهام؛ ولذلك كان عليه أن يختار من الأمور ما يعجبهم، ثم يعرضها عليهم دون تعليق بعد أن كان قد أخذ للأمور عدتها ومَهَّدَ السبيلَ بما لديه من سياسة وتجارب لتنفيذها دون تعليق، وهذه هي التحفظات التي يجب أن نضعها هنا من جهة القيمة التاريخية لهذه الوثيقة.
ومن جهة أُخرى يجب أن نلحظ أن ما قصه علينا «وزاحر رسن» في نقوش تمثاله كان مفروضًا أن يقرأه المارةُ «هذا إذا كان تمثالُهُ على ما يظهر موضوعًا في معبد «أوزير» بمدينة «سايس»»، وكان معاصرًا للحوادث التي ذكرها عليه.
هذا، ومن الطبيعي أن يضع أمام المارة صورة مشوهة جدًّا عن العصر الذي عاش فيه هو، وأن يُفهم القوم أنه أَسهم في الإصلاحات التي جرت فيه.
على أنه كيف يكون رئيس الأطباء «وزاحر رسن» هذا ليس في حاجة إلى ملق الملك «قمبيز»؟ والواقع أن هذا يرجع إلى أن المتن قد وُضع بعد موت هذا الملك، يُضاف إلى ذلك أنه على الرغم من أن «وزاحر رسن» كان ميالًا بعواطفه إلى الفرس، إلا أنه قد تحدث عن وجود اضطرابات عظيمة في أيامهم؛ فقد أشار إلى التخريب الذي سَبَّبَه الأجانبُ في أثناء حروبهم وتوطيد أقدامهم في «مصر». وأخيرًا نجد أنه قد برهن على حياده في تلك الفترة بأنْ وضع أسماءَ مُلُوك الأسرة الساوية في طغراءات، وأسبقها بلقبَي: ملك الوجه القبلي والوجه البحري، كما فعل مع ملوك «فارس»، وذلك في حين أننا نجد بعض الوثائق كانت لا تعترف بالملك «أحمس» الثاني ملكًا كما جاء ذلك في تاريخ «هردوت»، (راجع: Herod. III 16) ، وكما ذكر لنا «ماسبرو» (راجع: Hist. III p. 663)، و«جريفث» أيضًا (راجع: Pa p. Ryland III p. 99)، ومن جهة أُخرى نجد في تواريخ المتون المكتوبة بالخط الديموطيقي أن الأمر كان على عكس ذلك؛ إذ نرى أن «أحمس» الثاني قد عُومل بوصفه ملكًا على حين أن «قمبيز» وحتى «دارا» قد ذُكرا بوصفهما شخصين عاديين.
)راجع:( Spiegelberg A. Z. L III p. 30; Sottas, A. Z. 23, p. 46.
ومِن ثَم لا ينبغي علينا ألا نُقلِّل من القيمة التاريخية لهذا المتن الذي نحن بصدده، وألا نعد صاحبه رجلًا وصوليًّا، ولكن بشرط أن نذكر أنَّ الحوادث التي دَوَّنَها في هذا المتن كانت قد اختِيرت بصورةٍ شخصيةٍ تُوحِي بما يُشْتمُّ منه رائحة التحيُّز، ومن ثم يمكنُ استعمالُهُ واستخلاصُ معلوماتٍ ثمينةً من محتوياته.
والواقع أن «وزاحر رسن» قد وصف لنا في متنه هذا فتح الفرس ﻟ «مصر»، بألفاظ تنطوي على الإبهام، فلم يذكر لنا الحروب التي قامتْ بين البلدين، وهذا الصمت من جهة «وزاحر رسن» كان أمرًا طبيعيًّا؛ لأن ذكرها في هذا الوقت لم يكن من السياسة أو اللباقة التي يُحمد عليها صاحبها، ولا تدعو إلى الفخار في ظرف كهذا، وعلى ذلك فقد أراد أن يمثل لنا الملوك الأجانب الذين اغتصبوا «مصر» بأنهم كانوا يواصلون بأمانة إنجاز الأعمال التي بدأها الملوك الوطنيون، والواقع أن الدور الذي قام به «سماتوي تفنخت» في أثناء الفتح الفارسي الثاني ﻟ «مصر» على يد «أردشير» الثالث يشبه الدور الذي قام به «وزاحر رسن» غير أنه يُعَد أقلَّ وضوحًا من الدور الذي قام به الأخيرُ كما سنرى بعد، وتدلُّ ظواهرُ الأُمُور على أن كلًّا منهما كان يلعب دورًا مزدوجًا، فكان مذبذبًا بين هؤلاء وهؤلاء.
(راجع Spiegelberg, Chronique demotique de Paris Recto. V 15-16:).
والواقع أن الفتح الفارسي في القصة التي رواها لنا رئيس الأطباء «وزاحر رسن» قد ظهر في صورة هجرة؛ إذ يقول: «إن سكان البلاد الأجنبية الذين أتوا مع «قمبيز» قد استوطنوا «مصر».» وفي فقرة أُخرى نجد أن مهاجمين قد استقروا في معبد الإلهة «نيت»، ولا نِزَاعَ في أن المقصودَ من ذلك كان رجالُ الجيش الفارسي الذين أبقاهم معه «قمبيز» طوال مدة إقامته في «مصر» (525–522ق.م)، وقد كانت «مصر» في عهده تعد بمثابة قاعدة للأعمال الحربية التي قام بها على بلاد «كوش» والواحات، ومن المحتمل أن عددًا من سكان البلاد المجاورة ﻟ «مصر» قد انتهزوا فرصة الفتح الفارسي ودخلوا «مصر» مستوطنين فيها، وقد يكون ذلك صحيحًا — كما جاء في الوثيقة السالفة التي من عهد الملك «أكزركزس».
وتدلُّ الوثائقُ التي في متناولنا على أن الغُزاة كانوا من سلالات عدة؛ ولذلك نجد أن «وزاحر رسن» قد اختار التعبيرَ الملائم للدلالة على ذلك في نقوش تمثاله؛ فقد قال عنهم: «الأجانب الذين من كل البلاد الأجنبية»، والواقع أن البردية الآرامية التي عُثر عليها في «مصر» والتي يرجع عهدها إلى القرن الخامس تكشف لنا عن وجود فُرْس وخوارزميين وكسبيين، وبوجه خاص جَمٌّ غفير من الساميين يحملون أسماء بابلية وآرامية ويهودية.
) راجع: Ed. Meyer, Das Papyrusfund Von Elephantine 25 et Noël Aimé-Giron, Textes Araméens d’Egypte p. 58).
هذا، وقد دل على وجود جنود من البابليين في جيش «قمبيز» وثيقةٌ بالخط المسماري، (راجع: Meissner, A. Z. 29, p. 123)، وقد أحس المصريون بوصول هؤلاء الأجانب بما ارتكبوه من عُنف وقسوة، وكان ذلك — بلا نزاع — بداية عهدٍ من الفوضى وسوء النظام، ويُلحظ أن رد الفعل الذي أحدثتْه الغزواتُ الفارسية ﻟ «مصر» في الأدب والدين ذو طابع هام بارز؛ ففي أسطورة الإله «حور» التي نقشت على جدران معبد «إدفو» نجد أن الإله «ست» عدوه قد أحفظه وأثار غضبه بوصمه له بأنه ميدي؛ «أي فارسي».
(راجع Chassinat Edfu, 6, 214-215 F; Kees, Kult-legende und Urgeschichte, Nachr., Göttingen 1930 p. 346).
هذا، ونجد أسماء أقوام الأقواس التسعة القديمة أعداء «مصر» التقليديين (راجع: «مصر القديمة» الجزء التاسع) قد بدئوا يسمون بأسماء حديثة، فنجد أن رُماة الصحراء الذين وحدوا بالبدو قد سموا بأهل بلاد «ميا».
) راجع Chassinat, Edfu, 6, p. 198; sethe, Spuren der: Perserherrschaft Nachr., Göttingen 1916 p. 130).
هذا، ويُلحظ أن التعبير «أجانب كل البلاد الأجنبية» — الذي ذكرناه فيما سبق — يدل على الغزاة في المتنين رقم 1، 6، ويوجد في نفس نقش معبد «إدفو» الذي نحن بصدده صيغٌ سخريةٌ عملت ضد أعداء الملك، وهؤلاء هم في الأصل آسيويون (راجع: Ibid. 6, 235)، وتدل الأحوال على أن «وزاحر رسن» لم يخف ما ارتكبه الأجانب من آثام، ويُلحظ هذا في الفقرتين الشهيرتين من نقوشه وهما اللتان تذكران: «الاضطراب العظيم جدًّا الذي حدث في مقاطعة «سايس» وفي كل «مصر»، وهذا الاضطراب لم يحدث مثيله من قبل».
وقد أراد بعض المؤرخين أن يرى في هذه الاضطرابات إشارةً إلى أعمال العنف التي ارتكبها «قمبيز» في «مصر»، وهي التي ذكرها الكُتاب الأقدمون، وبخاصة «هردوت» وهناك الفقرات التي جاء فيها ذكر هذا العنف.
(راجع: Herod. 3, 16, 27, 130; Diodorus 1, 46; Strabo 17, 1, 27; Plutarch, De lside 44 justin 1, 9, etc).
وقد تابع «قمبيز» السير من مدينة «منف» إلى مدينة «سايس» قاصدًا أن يتم ما بدأه؛ لأنه عندما دخل قصر «أحمس» الثاني أمر في الحال بأن يحضر جسم «أحمس» الميت من ضريحه، وعندما تم له ذلك أعطى الأوامر بجلده ونتف شعره ووخزه وانتهاك حرمته بكل طريقة ممكنة، ولكنهم عندما أخذ منهم التعبُ كل مأخذ من هذا العمل «لأنه لما كان الجسم محنطًا فقد قاوم ولم يُمزق إربًا إربًا» أمر «قمبيز» بحرقه، وبذلك أمر بما هو كفر؛ لأن الفرس كانوا يَعتبرون النار إلهًا؛ «أي يعبدونها»، ومن ثم فإن حرق الميت لم يكن — بحالٍ — مسموحًا به في كلتا الأمتين «الفارسية والمصرية»، فلم يكن مسموحًا عند الفرس للسبب السابق؛ وذلك لأنهم يقولون: إنه ليس من الحق أن نقرب لإله جسم إنسان ميت، أما من جهة المصريين فقد كانت النار تُعَد حيوانًا حيًّا وأنها تلتهم كل شيء يمكن أن تصل إليه، وعندما تتخم بالطعام تخبو بما التهمتْه، وعلى ذلك كان قانونُهُم أَلَّا يعطى — بأية حال من الأحوال — جسمٌ ميتٌ لحيوانات مفترسة؛ ولهذا السبب كانوا يحنطونها «حتى لا ترقد وتأكلها الديدان».
ومن هذا نرى أن «قمبيز» قد أمر بشيء منبوذ في عادات الأُمَّتين، وعلى أية حال فإن المصريين يقولون إنه ليس «أحمس» الثاني الذي عُومل بهذه المعاملة، بل كان مصريًّا آخر في نفس قامة «أحمس» الثاني قد أهانه الفرسُ ظَانِّينَ أنهم قد أهانوا «أحمس»؛ لأنهم يقولون إن «أحمس» كان قد أُخبر — بوحيٍ — بما سيحدث له بعد الموت؛ لأجل أن يعالج الشر الذي كان سيلحق به، ولذلك دُفن جسم هذا الرجل الذي عُذب بالقرب من باب مدفنه وكلف ابنه بأن يدفن جسمه هو في أقصى جُزء في الضريح.
والآن فإن هذه الأوامر التي أعطاها «أحمس» وهي الخاصة بدفنه هو، ودفن هذا الرجل يظهر لي أنها لم تُعط قط، ولكن المصريين يفخرون بها كذبًا، وجاء في فقرة أخرى (Herod. III 27): وعندما وصل «قمبيز» إلى «منف» ظهر العجل «أبيس» للمصريين وهو الذي يُسميه الإغريق «أبا فوس»، وعندما حدث هذا الظهور أسرع المصريون في الحال إلى ارتداء أثمن الملابس، وأقاموا أعيادًا انقطعوا أثناءها عن العمل، وعندما رآهم «قمبيز» مشغولين هكذا استنبط منهم أنهم يقومون بهذه الأفراح بسبب عدم نجاحه في حملته على بلاد النوبة، فأمر حُكَّام «منف» بالحضور أمامه، وعندما مثلوا في حضرته سألهم: «لماذا لم يفعل المصريون شيئًا من هذا القبيل عندما كان في «منف» من قبل ثم فعلوا ذلك الآن عندما عاد فاقدًا جزءًا عظيمًا من جيشه؟» فأجابوا أن إلههم قد ظهر لهم، وهو الذي كان معتادًا أن يظهر في فترات متباعدة، وأنه عندما ظهر كان المصريون جميعًا قد اعتادوا أن يفرحوا ويُقيموا أعيادًا، وعندما سمع «قمبيز» بذلك قال لهم: إنهم كذبوا وأمر بقتلهم بسبب كذبهم (8) وبعد قتلهم أمر بمثول الكهنة في حضرته، وعندما قص الكهنة نفس القصة قال: إنه سيكشف فيما إذا كان إلهًا طيعًا على هذا النحو قد أتى بين المصريين، وبعد أن قال ذلك أمر الكهنة أن يحضروا «أبيس» إليه وعلى ذلك ذهبوا ليحضروه.
وهذا العجل «أبيس» أو «أبا فوس» هو عجل بقرة لا يُمكنُها أن تحمل في غيره، ويقول المصريون: إن الثور ينزل من السماء على البقرة، ومن ثم تضع «أبيس»، وهذا العجل الذي يُسمى «أبيس» يُميز بالعلامات التالية: إنه عجل أسودُ فيه بقعةٌ مربعةٌ بيضاء على جبهته، وعلى ظهره صورةُ نسر، وفي الذيل شعرٌ مزدوجٌ، وعلى لسانه صورة جعران (29)، وعندما أحضر الكهنة «أبيس» استل «قمبيز» خنجره كإنسانٍ يكاد أن يكون قد خرج عن حواسه، قاصدًا بذلك بَقْرَ بطن «أبيس»، ولكنه ضربه في فخذه، وبعد ذلك أخذته نوبةُ ضحك قائلًا للكهنة: «أنتم أيها الأغبياء هل هناك آلهة مثل هذه من دم ولحم وتحس بالفولاذ؟ حقًّا إن هذا إله جديرٌ بالمصريين، ولكنكم لن تهزؤوا مني».
وبعد أن تكلم هكذا أمر رجاله بتعذيب الكهنة، وقتل كل المصريين الذين كانوا يجدونهم على يد هؤلاء الذين كان هذا عملهم، وعلى ذلك فض عيد المصريين وعوقب الكهنة، ولكن «أبيس» الذي جُرح في فخذه خارتْ قواه في المعبد، وفي النهاية مات من الجرح ودفنه الكهنةُ دون علم «قمبيز».
وفي فقرة أخرى نقرأ عن تعسُّف «قمبيز» ما يأتي: (راجع: Herod. III par, 37) وبعد ذلك ارتكب أعمالًا جنونية مع الفرس وحلفائه أثناء مكثه في «منف»؛ إذ فتح المدافن القديمة وفحص الأجسام الميتة، وكذلك دخل معبد «فلكان» واحتقر تمثاله؛ لأن تمثاله كان شديد الشبه بتمثال «باتيس Pataice» الفنيقي وهو الذي يضعه الفنيقيون عند مقدمة سفنهم الحربية وهو على صورة قزم، وكذلك دخل معبد «كابيري» (وهو محرم على كل فرد دخوله إلا الكهنة) وحرق هذه التماثيل بعد أن مثل بها بطُرُق مختلفة، وهذه كلها مثل تمثال «فلكان» ويقولون: إنها أولاد هذا الأخير هذا ما أورده لنا «هردوت»1 غير أن ما جاء في متن «وزاحر رسن» ليس فيه ما يسوغ حتى التقريب بينه وبين ما جاء في «هردوت»؛ وذلك لأن الكلمة المصرية التي استعملها «وزاحر رسن» في متنه، وهي كلمة «نشن» لا تعني — في الواقع — إلا اضطرابًا سياسيًّا أو فوضى، ولا تعني قط مصيبة أو كارثة، وإذا جاز لنا أن نثق في الصيغ الثابتة التي تُستعمل في وصف «تعذيب كبير» فإنا نكون هنا أمام حالة فوضى وسوء نظام، يُمكن أن نجعل سكان مدينة عظيمة في خطر مما يجعل القويَّ يقهر الضعيف ويترك الخائف دون حماية، كما جاء في متن تمثال «وزاحر رسن»، ولكن هذا الوصف لا يمكن أن يعزى إلى أعمال الشدة التي ارتكبها «قمبيز» كما حدثنا عن ذلك «هردوت»، وهي الفظائع التي ذكرناها فيما سبق، والواقع أن تعسف «قمبيز» كان موجهًا بصورة خاصة للدين، ولكن على ما يظهر لم يمس هذا التعسف صغار الشعب الذين يتحدث عنهم متن تمثال «وزاحر رسن»؛ إذ إن هذه الأعمال تصبغ بصفة كارثة عامة نزلت بالبلاد جميعها، مثل الاضطراب الذي يحدثنا عنه متن التمثال.
ومن جهة أخرى ليس أمامنا ما يبرر أن «وزاحر رسن» قد أشار من طرف خفي إلى أعمال السوء التي ارتكبها «قمبيز» سيده وحاميه، وهو الذي كان يعمل جاهدًا باستمرار على إظهار مقاصده الحسنة نحو «مصر»، أما ما يجب أن نفهمه من عبارة «الألم العظيم» فيبحث عنه في نفس متن تمثال «وزاحر رسن»، فالاضطرابُ الذي فوجئتْ به البلادُ جميعًا قد نتج عن استقرار الأجانب في «مصر»، كما ذكر في المتن، أما سوء النظام الذي حدث في مقاطعة «سايس» فنجد مقابلًا له في إقامة الغزاة في معبد الإلهة «نيت».
وهذا التغير في حالة البلاد يؤكده بصفة غير مباشرة ما جاء في عقد بابلي خاص ببيع عبد مصري (Meissner A. Z. (1891) p. 123-124) وهذا العبد كان قد جيء به إلى «مسوبوتاميا» عام 525ق.م، بوصفه غنيمة حرب ومن ثم يُمكننا القول بأنه في بداية الفتح الفارسي كان سكان «مصر» يجتازون فترة أليمةً في حياتهم، ومع ذلك فإنه بعد الفتح الفارسي تدل الأحوالُ على أن الحياة قد عادتْ بسرعة إلى مَجراها الطبيعي؛ ففي نهاية السنة السادسة من عهد «قمبيز» (524ق.م) كان في الإمكان الاحتفال بدفن عجل «أبيس» كما جاء ذلك في الوثيقة رقم 3، وكذلك في نفس السنة نرى أحد الكهنة القاطنين في الدلتا قد أرسل في طلب مرتبه في معبد من معابد «مصر» الوسطى (راجع: Griffith Ryl. Pa p. 3, 105-106)، وأخيرًا نجد في أربع وثائق من عهد «قمبيز» ما يُبرهن على أن حكمه في «مصر» كان لصالح البلاد ورقيها، (راجع (Sottas A. S. 23, p. 46:.
ومما يؤسَف له أن متن تمثال «وزاحر رسن» لم يقدم لنا تفاصيل أكيدة عن هذا الموضوع، فلم نعلم منه شيئًا إلا ذِكْره احتلال معبد «سايس»، ومن المحتمل أن المدرسة التي كان يجب أن تكون بجوار المعبد قد خربت ونهبت؛ وذلك لأن الملك «دارا» — فيما بعد — كان مضطرًّا لأنْ يهبها كل المواد اللازمة لإصلاحها، ولا نِزَاع في أنَّ إصلاح مدرسة «سايس» كان من أعمال «دارا» لا من أعمال سلفه، ومع ذلك فإنه يظهر أن «قمبيز» قد كبح جماح جُنُوده بمَنعِهم من التعدِّي على الأهلين وأصلح — على الأقل ولو جزئيًّا — الأضرارَ التي نتجت عن الغزو، وقد وصف لنا ذلك المتن رقم 2، ومن جهة أخرى نعرف على حسب رأي المؤرخ اليهودي «جوسيفس» (راجع Ant. Jud II, 15, 315:)، أن قمبيز أسس مدينة «بابل» القريبة من «منف» (راجع: 315 Ed. Meyer Sitzungsber. Pr. Ak. Wiss. (1915) p. 310 note 1).
ونعرف مكانين يَحملان اسم الفاتح الفارسي «قمبيز»، واحد منهما جنوبي الشلال الثاني (راجع Ptolemie. 4, 7; pline Hist, Nat. p. 181:).
والثاني عند قناة السويس (راجع: Id 6, 165) وينسب «ديودور» الصقلي (راجع: Diod. 1, 33) إلى «قمبيز» تأسيس مدينة «مروى»2 بالسودان.
هذا، ونعلم أن الغُزاة قد طردوا بأمر من «قمبيز» من داخل سور الإلهة «نيت»، كما أمر بتطهير المعبد، وعلى ذلك يمكن «وزاحر رسن» أن يتحدث عن تَعَسُّفات الأجانب؛ وذلك لأن سيدَه وحاميَه «قمبيز» لم يكن شخصيًّا مسئولًا عنها، بل على العكس حارب تلك التعسفات وأوقفها.
.............................................
1-Diodorus I, 46, Strabo, 17, 1, 27: Plutarch De Iside, 44: Justin 1, q etc
2-ويشمل النيل كذلك جزائر في داخل مياهه، كثيرٌ منها يوجد في «إثيوبيا»، ومنها واحدةٌ عظيمةُ المساحة، تُدعى «مروى»، وقد أقيم عليها كذلك مدينةٌ عظيمةٌ تَحمل نفس اسم الجزيرة، وهي التي كان قد أَسَّسَها «قمبيز»، وقد سماها باسم والدته «مروى». ويقولون: إن هذه المدينة في صورة درع طويل، وهي تفوق في حجمها الجزائر الأخرى في ستاد، وهي كذلك تحتوي على مدن طولها هو 30000 ستاد، وعرضها ألف هذه الأجزاء؛ وذلك لأنهم يقولون إن ليست بالقليلة وأعظمها شهرة هي «مروى».



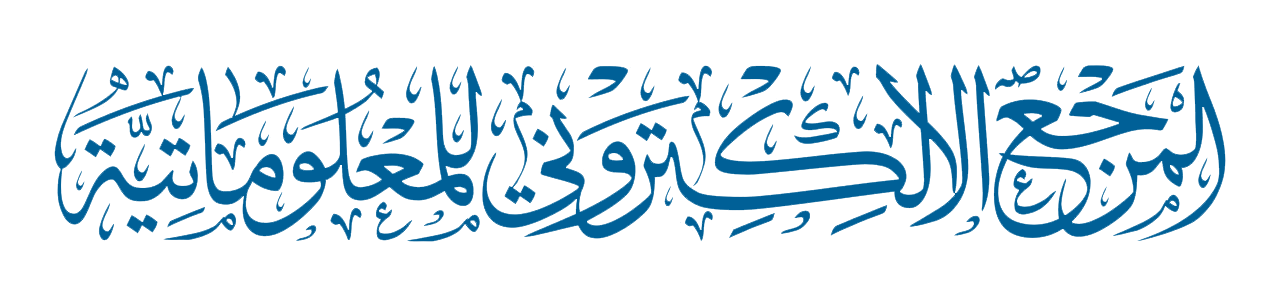









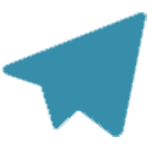
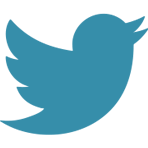
 قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)
قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)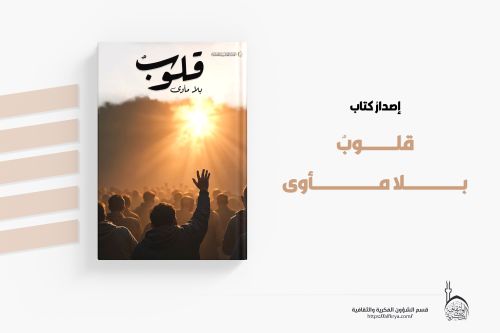 قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)
قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)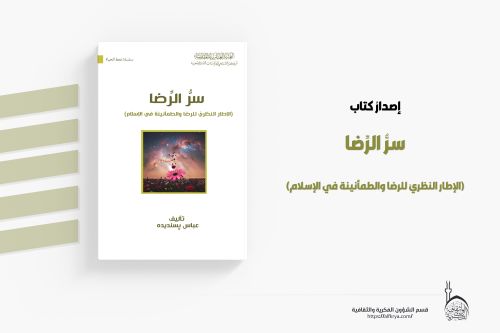 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاب (سر الرضا) ضمن سلسلة (نمط الحياة)
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاب (سر الرضا) ضمن سلسلة (نمط الحياة)